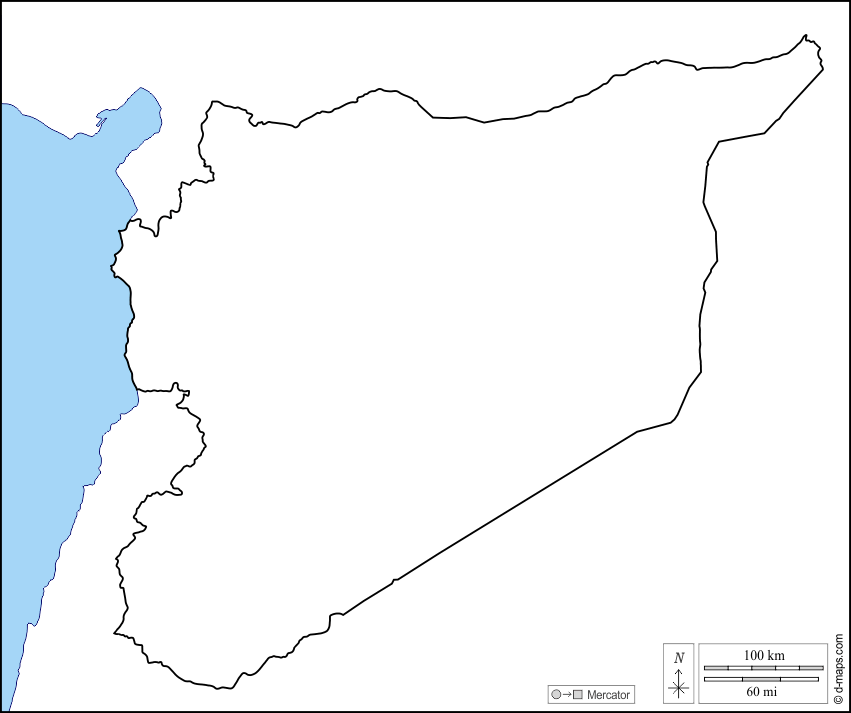حسين جمو
تضيق دائرة السياسة على الأراضي السورية إلى الحد الأدنى هذه الأيام لتصبح محصورة في اجتماعات ثلاثية تعقدها روسيا وتركيا وإيران كل ستة شهور. خارج هذا الإطار، لم يبق سوى تهريج دولي يضمن رواتب لجيش من الموظفين، سواء الأمم المتحدة أو دوائر دبلوماسية في وزارات خارجية الدول الغربية.
حصيلة سنوات طويلة من الاضطرابات السورية منذ عام 2011 وحتى اليوم، انفصال القضية السورية عن السياسة بمفهوها التجريدي النظري المعروف. ما بقي حالياً هو إعادة تنصيب النظام السوري على رأس الدولة، وهي عملية يعود الفضل فيها إلى ديناميات إقليمية ودولية تتحكم فيها روسيا بشكل أساسي.
فقدت المعارضة السورية نصيبها من السياسة منذ سنوات، وباتت هيكلاً من هياكل الأمن القومي التركي. لم تكن لدى المعارضين الجرأة على تعريف دورهم الجديد، و أسقطوا أنفسهم في “مجزرة” حين انساقوا وراء وهم أن بإمكانهم الفوز بجائزتين يستحيل أن يفوز بهما طرف واحد: وحدة سوريا (وفق صيغة الدولة القومية المختلة) وإسقاط النظام. ولم تمض فترة على الجري وراء هذا الوهم حتى باتت قضية المعارضة الرئيسية، “وحدة سوريا”، تتبع أسلوب “الأنفال” البعثي العراقي، كما حدث في عفرين وسري كانيه وغيرها من المناطق التي تحولت إلى “أرض محتلة” من جانب تشكيلات المعارضة السورية. فباتت هذه المعارضة، حين تخلت عن السياسة لصالح الأمن القومي التركي، قوة خارجية مكتملة الأركان على الأرض السورية.
مع تحول المعارضة إلى قوة خارجية مرتهنة، بقي هناك طرفان إشكاليان، شبه داخليين، لكل منهما ديناميات سياسية محلية وأرضية اجتماعية: النظام السوري والإدارة الذاتية الديمقراطية.
شهد النظام فترات صعود وهبوط، كان من بينها أنه شارف على السقوط منتصف 2015 قبيل التدخل العسكري الروسي. وكانت الإدارة الذاتية أيضاً، حتى قبل تشكلها حين كان التمثيل العسكري محصوراً في وحدات حماية الشعب، على وشك السقوط في كوباني خريف 2014 قبل التدخل العسكري للتحالف الدولي. وأوشكت المعارضة المسلحة على السقوط في معركة إدلب مطلع 2020.
نظراً للفارق البيروقراطي في صناعة وتوجيه السياسة بين الولايات المتحدة وروسيا، ظهر عجز الجانب الأميركي عن مجاراة الروس في السياسة السورية. فالقوة الأميركية، المعزولة في قواعد متناثرة شمال شرق سوريا، ذات حجم صغير لا تستطيع التأثير على أي قرارات يتم اتخاذها في واشنطن، وعجزت عن الوقوف في وجه صفقات دموية تمت بين البيت الأبيض والحكومة التركية على حساب الكرد في سوريا. والملف السوري، وفق مفاهيم البيروقراطية السياسية الأميركية، والغربية عموماً، ليس غنياً ولا يرقى إلى طموحات حاملي الملفات بين أيديهم خلال جولاتهم الدولية. هذه العوامل وغيرها حسمت الثقل السياسي في سوريا لصالح روسيا بلا منازع وباتت الولايات المتحدة تمثل “همرات” عسكرية وشاحنات تنقل كتل إسمنيتة ضخمة قادمة من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا لبناء مقرات عسكرية وحواجز أمام القواعد الشبيهة بـ”مساكن مسبقة الصنع”.
بين روسيا والولايات المتحدة، كسبت تركيا مساحة سياسية واسعة. أولاً، استولت على “السياسة” الخاصة بالمعارضة السورية سابقاً، ثم قامت بتفعيل دورها الوظيفي التاريخي: لعب دور الساحة المشتركة لكل من واشنطن وموسكو في سوريا. فهي من جهة ما زالت تمثل حلف ناتو في إدلب، وهذا يقع في هوى دائرة واسعة من صنّاع القرار في واشنطن ممن لم يتخلصوا من كراهية الشيوعية السوفييتية ويعتبرون روسيا امتداداً للحرب الباردة. وفي المناطق ذات النفوذ الأميركي، شرقي الفرات، تمثل تركيا مصدر إزعاج للتحالف الدولي وفق الحسابات الروسية، وأداة استراتيجية لا غنى عنها لإسرائيل لجهة منع إيران حيازة مزيد من المساحات الجغرافية في سوريا. وهذا – وفق رؤية إسرائيل – لا يكون سوى بتوسيع الوجود التركي قدر الإمكان.
هذه المعادلات، الخاصة بكل من روسيا والولايات المتحدة وتركيا، أكبر من قدرة كل من النظام وقوات سوريا الديمقراطية على المشاركة فيها. وحين حاولت الإدارة الذاتية، عبر مجلس سوريا الديمقراطية، الحديث في السياسة مع “هؤلاء”، حظي الفيتو التركي بإجماع كافة الأطراف. هكذا، تم إجراء هندسة “مثالية” للوضع في سوريا تمهيداً لفرض الرؤية الثلاثية (الروسية التركية الإيرانية). وحقيقةً، لا يمكن تجاهل الدور الإسرائيلي الحاضر في إسناد تركيا، بكافة السبل، تحت فرضية أن أي نفوذ تركي إضافي يحرم إيران من نفوذ إضافي آخر. تتمثل هذه الهندسة في السماح فقط بتنمية الجانب العسكري في قوات سوريا الديمقراطية مقابل إجماع كافة الأطراف على شلها سياسياً. وهذه معادلة ليست اكتشافية، بل معروفة لأي شخصية على صلة بالإدارة الذاتية، التي حاولت على مدى سنوات كسر هذا الحصار من دون أن تنجح. وليس السبب هنا النقص في “خطابها الإقناعي” كما يتوهم المتوهمون.
على الجانب الآخر، لم تكتمل بعد معادلة المعارضة السورية، وهي معكوسة مقارنة مع قسد، أي تجريدها من القوة العسكرية وإبقائها جسماً سياسياً شكلياً يلتهي أربابها بتهريج مفصّل مسبقاً يسمى “اللجنة الدستورية”. في المرحلة الحالية، ما زالت تشكيلات المعارضة المرتهنة لتركيا تحظى بقوة عسكرية احتلالية داخل سوريا. لكن جرى الفصل بين العسكر والساسة منذ سنوات. والمرجح أن التسوية المقبلة هو تقليصها عسكرياً أكثر وأكثر وإبقائها فقط ضمن مجموعة من حملة الملفات الورقية في “اللجنة الدستورية”. ويرتبط مسار تقزيم المعارضة العسكرية بالصفقة التي تلوح في الأفق والتي ستحسم الصورة النهائية للصراع السوري.
في الاجتماع الأخير لـ”صيغة أستانا” في طهران، الشهر الماضي، حدثت متغيرات على الأرض من دون الإعلان عن اتفاق بشأنها في بيانات الاجتماعات الثنائية والثلاثية في طهران. فقد زادت وتيرة القصف التركي عبر المسيّرات في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وطالت مدينة القامشلي نفسها، وأدت في المحصلة حتى الآن إلى فقدان عشرات المدنيين والعسكريين حياتهم. وارتفعت وتيرة القصف بعد أن أظهرت تصريحات “أستانا” أن أي عدوان تركي جديد أمامه خط أحمر روسي وإيراني. إلا أن ما تشير إليه الوقائع “المسيّرة” أن هناك اتفاقاً غير معلن تم في طهران. هذا الاتفاق يرسمه مسار الأحداث والتطورات. ففرضية وجود اتفاق غير معلن ليس تسريباً لمعلومة إنما مسار تقود إليه الأحداث. ويفترض هذا الاتفاق أنه يتضمن عرضاً إيرانياً وروسياً إلى تركيا بأن تمتنع الأخيرة عن شن أي عمل عسكري جديد مقابل أن تحصل على النتيجة ذاتها، أي إنهاء تجربة الإدارة الذاتية بصيغتها الحالية، بما في ذلك الجانب العسكري، وهو الأهم بالنسبة لتركيا. يكون ذلك عبر تقدّم النظام في مناطق الإدارة الذاتية كحل وسط بين الأطراف الدولية الثلاثة. وبما أن التجارب السابقة تشير إلى أن الإدارة الذاتية لديها صلابة في التمسك بمطالبها أمام النظام، فإن الجزء المطلوب من تركيا في هذه الحالة توجيه ضربات مكثفة عبر المسيّرات في مناطق شمال وشرق سوريا، و هو ما يحدث منذ نهاية اجتماع طهران.
الحل الإيراني الروسي، وفق المعطيات، يتمثل في إحلال النظام محل الإدارة الذاتية. وهذا حل يحظى بقبول تركي غير مسبوق وفق تصريحات المسؤولين الأتراك، بما فيهم الرئيس رجب طيب أدروغان. الجزء المطلوب من أنقرة تكثيف الهجمات وتحويل الحياة في مناطق الإدارة الذاتية إلى جحيم اجتماعي واستنزاف عسكري لقيادات قوات سوريا الديمقراطية. وواقع الحال، أن هذا السيناريو يتقدم بتسارع. فالنظام قدر سوريا لمرحلة أخرى من المستقبل وفق الإرادات الخارجية الثلاث: روسيا وإيران وتركيا. أما داخلياً، تقاعدت المعارضة عن هدف إسقاط النظام وتبنت “وحدة سوريا العروبية”. وقد يستفيد النظام من وجود شكلٍ لهم داخل أي حكومة مستقبلية كطرف عصبوي عنصري وظيفته الوحيدة تعطيل أي شكل تعددي في سوريا “النظام”.
لم يعد هناك الكثير من هامش الانتظار بالنسبة إلى القوى المستهدفة في شمال شرق سوريا. فالمساحة القليلة المتبقية من السياسة هي تقليل القواسم المشتركة بين أنقرة ودمشق. ويتطلب ذلك خطوات مؤلمة، لكن ضرورية، قد يكون أولها حسم مسألة التعاون مع التحالف الدولي الذي تحول إلى أداة أخرى من أدوات تعطيل السياسة.