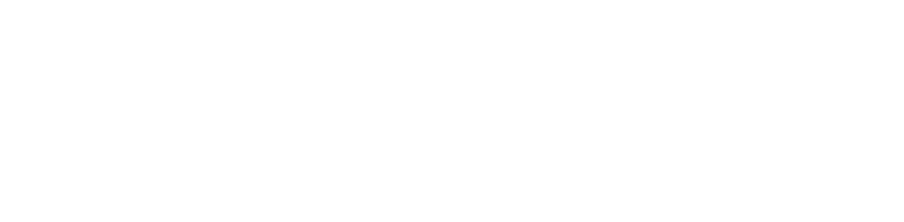حسين جمو
يخيم الظلام والخوف على عدد من المدن والبلدات الحدودية غير المحتلة في شمال سوريا حيث تتعرض إلى قصف عنيف وهجمات على البنية الخدمية الرئيسية بشكلٍ شبه كلي ومحاولات لاحتلالها. وفي عفرين تجري عملية إبادة منظمة وحشية تقف شاهدة على انتصار الكراهية تحت أنظار كل المنظمات الحقوقية.
في جنوب العراق، كشفت السلطات عن مقبرة جماعية جديدة تضم رفاة أكثر من مئة مواطن كردي من إقليم كردستان العراق، العدد الأكبر من هؤلاء الأشخاص الذي دفن بعضهم حياً هم من الأطفال والنساء. المقبرة تعود إلى فترة حملة نظام البعث العراقي بقيادة صدام حسين ضد الكرد. هذه المقبرة جزء من مئات المقابر التي ابتلعت عشرات الآلاف من الكرد في عمليات القتل الجماعي والإبادة القومية.
ما زال «قرن من الظلام» يخيم على هذه الأمة من 1923 إلى 2025. الدول الأربع التي تدين بوجودها (في حالتي سوريا والعراق) واستمراريتها (في حالتي تركيا وإيران)، إلى الاستعمار نفسه، اتبعت قاعدة وزير الداخلية العثماني والصدر الأعظم، طلعت باشا، في حقبة الاتحاد والترقي، هذه القاعدة أطلق عليها طلعت بنفسه اسم «الصندوق المغلق».
استخدم الوزير طلعت باشا هذا التعبير خلال افتتاحه مؤتمراً داخلياً للإعداد لأول حملة استكشافٍ داخلية ذات طابع استعماري في كردستان وأرمينيا. في هذا الصندوق المغلق كل شيء مباح بعيداً عن أعين العالم! لقد سمح العالم بإغلاق هذا الصندوق أساساً، وكانت هذه هي صفقة التعريف التركي لمعاهدة لوزان، والجزء الدولي من هذه الصفقة هو عدم ممانعة التعريف التركي على أن الداخل الخاص بها هو«صندوق مغلق»، على الخير والشر، على القتل والحياة. الأمر يتوقف على ضمير مالكي هذا الصندوق المغلق الذي في داخله كردستان والشعب الكردي. هذا بالضبط ما يدعونه «الدولة القومية» في الشرق الأوسط، سواء كانت عرقية أو مطعّمة بالتدين الكاره للآخر. كل دولة قومية تتبنى منهج الصندوق المغلق، وكلا العلاقات الدولية لهذه الدول مكرسة لضمان الحرية في القتل لجزء من مجتمعه أو شعب كامل في دولته.
خلال الأعوام المئة الماضية، عاش نموذج «الدولة القومية»، في نسخته الأكثر دموية وفشلاً، مجده في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من فشلها الذريع في التنمية وحكم القانون، إلا أن هذه الدولة سجلت نجاحاً استثنائياً في تغيير المزاج الشعبي للإيمان بطهرانية الدولة وحرمانية التشكيك في طبيعتها، وطبعتها السياسية الأحادية القائمة على إلغاء التنوع والتعددية. وبلغ نجاحها حداً أنها قامت بتغيير ذهنية التيارات المعارضة لها لتكون نسخةً مطابقة لها حين تكون المسألة تغيير هوية الدولة من كيانٍ عنصري استيلائي إلى دولةٍ وطنية تتشكل من أقوام عديدة متشاركة في حيّزٍ جغرافي.
لذلك، فإن الحديث عن فشل الدولة القومية في المشرق، يحجب نجاح هذا النموذج في ترسيخ العنصرية والكراهية وجعلهما ثقافة عامة عبر ضخ معلوماتٍ مضللة في اتجاهٍ واحد تنال من وجود الكرد وتشكك في أن لهم شأنٌ في التاريخ أصلاً! من هم هؤلاء الكرد حتى يطالبوا بحق من حقوق البشر الطبيعية في المجتمع الحديث؟ أفضل من فيهم مستعربون ومستتركون، وهذا هو الكردي المسموح له بالبقاء والارتقاء!
الأمثلة على ذلك لا حصر لها وتنسف الرواية المضللة في أن الحرب على القضية الكردية في الدول الأربع هي نتاج أنظمة سياسية. وحقاً كان الأمر كذلك في البدايات، حين كانت لجنة طلعت باشا الاستكشافية في الأناضول وكردستان ترسل نتائج صادمة إلى القيادة بأن سكان البلاد، خاصةً الأتراك، يرفضون تعريف أنفسهم بدلالة القومية التركية لأنهم كانوا يرون أن تعريفهم بهذا الوصف يحط من شأنهم!
لكن لاحقاً، تغير المزاج الاجتماعي إلى درجةٍ مهولة من الكراهية جراء التعليم والتلقين السلطوي للمجتمع. هذه الأيام، لا يخلو تحليلٌ سياسي في الشأن التركي من ربط التدخلات التركية في سوريا بالمكاسب السياسية للحكومة. بل حتى القيادة التركية نفسها لا تنكر ذلك، وسبق أن استباحت عفرين وسري كانيه “رأس العين” وتل أبيض وأحالت الوجود الاجتماعي الكردي في هذه الحواضر المتواضعة إلى أطلال وساحة للجريمة الحرة على أيدي الجيش الوطني السوري. هذه خلاصة مخيفة، على الرغم من أنها لا تلفت النظر كثيراً لدى المتابعين. ما الذي يعنيه أن يعزز الهجوم على شعبٍ في دولةٍ مجاورة واقتلاعه من أرضه وتدميره، من فرص فوزه في الانتخابات أو التأييد الشعبي؟ حقيقة الإجابة محرجة وفق أدبيات السلام الاجتماعي، لكن أصحاب الشأن لا يخجلون من الخلاصة، وهو أن الكراهية والحروب منهج لشريحة واسعة. من أين تأتي هذه الاتجاهات العدمية؟ ومن أين نشأت هذه الشريحة التي لا تتردد في مكافأة أي قائد يقتلع شعباً مقيماً على أرضه وتشريدهم بين المخيمات وطرق الموت؟ إنها من الشريحة ذاتها التي كانت ترفض تعريف نفسها بدلالة القومية خلال الحرب العالمية الأولى. كيف حدث هذا التغيير الانقلابي؟ هنا يكمن نجاح الدولة القومية العنصرية في أنها خلقت صورة عنها داخل جزء غير قليل من المجتمع. المجتمع المسلح – على الأقل – أيضاً يريد صندوقه المغلق هذه الأيام في الملاحقات التي تتم في الساحل السوري وجباله، وهي ذات الممارسات الموروثة من النظام المخلوع.
حدث مثل هذا النموذج سابقاً في تركيا وسوريا والعراق وإيران. نجحت الدولة في هذه الكيانات في صناعة شخصيةٍ تتلاءم مع طبيعتها الأحادية. وسيتطلب تغيير هذا الاتجاه والتقليل من تأثيره الانتخابي والسياسي أطروحاتٍ جديدة تتبناها حكومات ذات قاعدة ائتلافية عريضة تقوم على مكافأة الخطاب التعايشي السلمي على نحو ما فعل حزب العدالة والتنمية حين وصل إلى السلطة عام 2002. لم تشهد تركيا تفويضاً اجتماعياً عارماً في تاريخها الحديث كالذي حظي به حزب العدالة والتنمية في بدايات صعوده الانتخابي. وبدأ هذا الإنجاز التاريخي يتبدد حين انقسمت أصوات هذه الكتلة التاريخية وذهب جزءٌ منها إلى حزب الشعوب الديمقراطي وأحزابٍ أخرى أصغر نتيجة عدم التزام حزب السلطة بالوعود التوافقية التي بنى عليها نجاحه. وبدلاً من التحلي بالمسؤولية التاريخية في التعايش مع هذا التغيّر، ومحاولة تصحيح مساره، انزاح بشكلٍ متطرف إلى جهةٍ أخرى تحظى بدعم شرائح هامشية لا يزيد مجموع قوتها الانتخابية عن 7 في المئة وهو حزب الحركة القومية. ومن أجل استقطابهم، لجأ إلى تبني خطاب أقليةٍ متطرفة ترفع شعاراتٍ خرافية تمثل أسطورة الذئب الأغبر. وحدث الأمر على نحوٍ سريع منذ عام 2015. ومنه، بدأت سياسةٌ عدوانية خارج الحدود تستهدف الكرد تحت مسميات عديدة تبرر قتلهم جسدياً، من حزب العمال الكردستاني إلى وحدات حماية الشعب ثم قوات سوريا الديمقراطية. الكارثة التربوية-الثقافية التي تشهدها المنطقة حالياً أن خطاب الحرب والعدوان الخارجي أصبحت محركاً للتصفيق، وهذا لأن الكتلة الأناضولية العريضة – في حالة تركيا- التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 لم تنفض عنه حين تغير خطابه من السلام إلى الحرب من دون أن يكون هناك تهديدٌ وجودي لكيان الجمهورية. والآن، سيلقى أي حزبٍ يدعو إلى إعادة السلام للداخل وتخفيف الاستقطاب الحزبي والكف عن استعمال مقدّرات الدولة في حروبٍ حزبية انتخابية هزيمةً ساحقة داخل الكتلة الانتخابية الأناضولية. وحدث هذا التحول ليس لأن المجتمع في طبيعته ينحو نحو التطرف، بل لأن السلطة، النظام الحاكم، عمل على هندسة هذا التحول. من المرجح ان تشهد سوريا محاولة في هذا الاتجاه، أي أن تفرض عليها تركيا طبيعتها، أن تخلق لهذه السلطة صندوقها المغلق، وتفرض عليها محتويات هذا الصندوق!
المقلق أكثر أن القوى الدولية، خاصة روسيا، إلى جانب القوى الإقليمية، تدعم هذا الاتجاه القائم على الكراهية داخل مجتمعات الشرق الأوسط. لقد كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عشرات المرات ترديد جملة أن أمريكا تريد تأسيس دويلة انفصالية كردية في سوريا وأن الإجراءات التركية في سوريا (الاحتلال) مشروعة لحماية أمنها.
آخر مرة تحدث فيها لافروف بهذه الجملة كانت قبل أيام، أي بعد سقوط نظام الأسد. رغم هزيمة روسيا الاستراتيجية والمذلة في البحر المتوسط، كان لديه متسع من الوقت للتحريض على الكراهية ضد الكرد في مجتمعات تلتقط مثل هذه الجمل وتفاقم مخاوفها، مما يؤدي إلى انزلاقها نحو الكراهية ودعوات للإبادة بحجة حماية الدولة المقدسة. لقد صرّح فنان سوري قبل فترة، وهو يتحدث في مهرجان فني عن كوباني، بدون خجل، أن سوريا 185 ألف كيلومتر مربع ويريد هذه الكيلومترات كلها دون أن ينقص متر واحد. لقد تفوّه هذا الفنان بهذه الكلمات بنبرة تهديدية، حيث يعتقد أن مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مشروع انفصالي بدون أن يصرح بذلك. وهو بذلك يحذّر ويحدد أولويته، فلن يقبل بسوريا أقل من 185 ألف كيلومتر مربع. المعضلة هنا ليست في وجود مشروع انفصالي من عدمه، بل تكمن في أن “فرضية الانفصال” التي يصوغها هذا الفنان وأمثاله تبرر لهم إطلاق أيدي القتلة واللصوص لإزالة أي تهديد بإنقاص الـ 185 كيلومتر مربع. المشكلة الحقيقية هي في فرضية الحدوث نفسها وعدم تحديد وسيلة لكيفية منع ذلك، والتي تعكس قلة فهم – وليس سوء فهم- لا يبدو أن لها حلاً سهلاً عبر تصحيح معرفي تلقيني.
إلى اليوم، لا توجد أي مؤشراتٍ على أن القوى الدولية المتصارعة في الشرق الأوسط جادة في تغيير سياسي لمفهوم الدولة القومية الإبادوية، وليس من الصواب في شيء تبرئة هذه القوى – المنظمات بتعبير أكثر تفصيلية – من غض النظر بل ورعاية خطاب الكراهية في بعض الحالات وتوفير الحماية والحصانة لها في مجتمعات هذا الشرق، وكذلك تمكين هذه الكراهية من التعبير عن نفسها، وتمويل وسائل إعلام ماهرة في الترويج للعنصرية.
في كل الأحوال، يقع العديد من الأكاديميين في سوء تقدير لقدرة الدولة على صناعة مجموعات وميليشيات تشبهها في أنماط التفكير وصناعة الأعداء. وإلا، كيف يمكن تفسير تبني معظم المعارضة السورية الممولة دولياً – قبل تحولها المفاجئ إلى سلطة حاكمة – رؤية أكثر عنفاً من النظام السابق ضد التعددية بكليتها. فعبر آلات إعلامية ممولة دولياً، جرى الترويج لتصور يعرف الكرد كتكوينٍ اجتماعي وافد حديثاً، وأن الوافد لا حقوق سياسية له. وأن الكردي مكانه مسح الأحذية.
مثل هذه الفكرة، بتنويعاتها اللفظية المتوارية والعنصرية، تتردد في أوساط النخب والعوام. فأصل الكراهية يعود إلى وقتٍ مبكر من عمر الدول القومية صنيعة الاستعمار، وتم انتقاء مرويات محددة عن التاريخ القديم والأوسط والحديث تتمحور في اتجاهين؛ الأول: نزع استمرارية الإقامة والاستقرار عن الكرد ومن في حكمهم وموقعهم، والثاني: اصطناع استمرارية تاريخية أزلية للكيان الحديث جداً والذي أطلق عليه اسم «سوريا» أو «سورية» كما يطيب تسميتها للمعرّبين.
لو رويت فرضيات تاريخانية هذه الكيانات في المنطقة لأمكن التخفيف من هذه النزعات التطهيرية (وليس التطهرية).
سوريا مثالاً اسم إداري، ابتلع بفضل الاستعمار الفرنسي الحديث، أراضٍ لا تنتمي لجغرافيتها. في موسوعة «معجم البلدان» لياقوت الحموي، لا يوجد كيانٌ جغرافي اسمه سوريا سوى ما ورد في باب السين تحت اسم «سورية» (بالتاء المربوطة) وجاء في تعريفها: «موضع بالشام بين خناصرة وسلمية». وقبل ياقوت، ورد اسم «سورية» في كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب» للمؤرخ ابن العديم (المتوفى في 1262 للميلاد) ضمن الكلام عن جبل الأحص جنوب حلب: «وفي هذا الجبل مدينة خربة، وهي سورية كانت مبنية بالحجر الأسود، وهي اليوم خراب لا ساكن بها». وفي موضعٍ آخر، ذكر سورية مرة أخرى خلال نقله القول المنسوب لهرقل الروم بعد هزيمته: «عليك يا سورية السلام». وليس بعيداً أن محقق المخطوطة، وهو سهيل زكّار، حوّل الألف في اسم سوريا إلى تاء مربوطة أساساً.
واستطرد ابن العديم: «وسورية هي الشام الخامسة، وأنطاكية منها. وقد ذكرنا أن في طرف الأحص مدينة خربة يقال لها سورية». وفي كتاب «اليواقيت والضرب في تاريخ حلب» لأبي الفداء الأيوبي (توفي عام 1331 للميلاد) ذكر ترتيباً معكوساً لأقاليم الشام فاعتبر أن : «سوريا هي الشام الأولى، وهي حلب وما حولها من البلاد على ما ذكره بعض الرواة». وأقدم من هذه المصادر كلها هو كتاب ابن عبدربه الأندلسي (توفي عام 940 للميلاد) ولم يذكر فيها اسم سوريا في تقسيمات الشام، فقال: «ثم الشام الخامسة وهي قنسرين، ومدينتها العظمى حيث السلطان: حلب.. وساحلها أنطاكية..».
وبقي اسم سوريا فضفاضاً بلا هوية ولا موضع كلما تقدم الزمن، وظهر في القرن التاسع عشر في أول شكلٍ إداري رسمي خلال التقسيمات العثمانية الجديدة في بلاد الشام فظهرت ولاية «سوريا» فجأة لتدل على دمشق وتنسلخ عن الأصل وهي حلب ووادي العاصي الشمالي إلى أنطاكيا. ومع احتلال الفرنسيين والبريطانيين الأراضي العثمانية الجنوبية، قام إداريو فرنسا باجتهادٍ «ثوري». فلأول مرة في التاريخ منذ ظهور آدم وحتى عام 1920، تنضم منطقة الجزيرة الفراتية إلى جغرافية بلاد الشام تحت اسم جامع هو «سوريا».
الغاية من الاستطراد السابق بشأن اسم سوريا ودلالاته عبر التاريخ، وكيف تلاشى ثم ظهر فجأةً نهاية القرن التاسع عشر وتوسّع بقوة الاستعمار الفرنسي نحو الجزيرة، تفكيك الأسطرة الركيكة لوقائع الحاضر القريب والصغير جداً، وأن أحداً لا يملك سرديةً تاريخية متصلة، وأن الجميع يستطيع صناعة سرديته الخاصة الانعزالية والاستيلائية والعدوانية متى ما قررت الطبقة القيادية، سواءً في الدول أو الحركات المناهضة لها.
غير أن هذا لا يولّد سوى تعميق الكراهية ومراكمة الأحقاد، إذ لا يوجد كيانٌ على الأرض يمثل إرادةً سماوية ضد أخرى أرضية. ولا يوجد شيء اسمه الـ 185 ألف كيلومتر مربع أو دونها رؤوسنا!
إن استمرارية هذا النوع من الدول القومية وصفة لحروب أهلية مديدة، وعبثية، لأنها حروب على شيء لا قيمة له ولا معنى له، وهو سيادة ووصاية مجموعة قومية أو دينية على مجموعات أخرى. فما القيمة الحضارية في مثل هذه السيطرة سوى نزعات نفسية تستوجب العلاج لا منحها دولة؟ هي تصورات خارج التاريخ الذي صنع الفارق، ومنه تجربة «المجتمعات – الأمة» التي تجسدت لفترات قصيرة واستثنائية ومذهلة في تاريخ هذه المنطقة، ولا شيء يمنع إعادة بعثها بما يتناسب مع المضمون الأكثر تقدمية وتعددية من الدولة الحديثة.