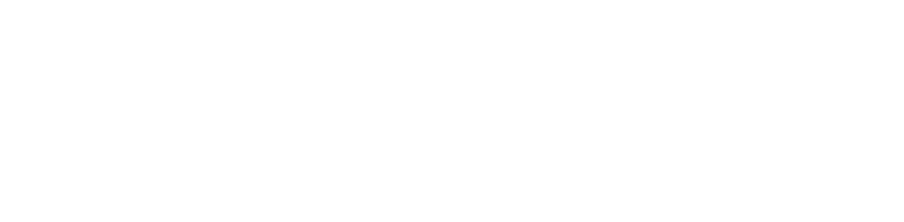محمد سيد رصاص
إثر توقع معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز 1923، كسب مصطفى كمال (لاحقاً أتاتورك) مساحات كبيرة من الأراضي بلغت 778 ألف كيلومتر مربع وُضعت ضمن الجمهورية التركية التي تم إعلانها بعد ثلاثة أشهر على المعاهدة، مقارنة بالأراضي التي فرض على الدولة العثمانية القبول بها في معاهدة سيفر قبل ثلاث سنوات والبالغة 453 ألف كيلومتر مربع.
كان وزير الخارجية البريطاني اللورد كرزون هو الطباخ الرئيسي للمعاهدتين، وأغلب الدراسات التاريخية تعزو الفرق بين المعاهدتين إلى انتصارات الكماليين العسكرية ضد اليونانيين وإلى الحقائق العسكرية التي فرضوها على الأرض في بقاع جغرافية متعددة غير تلك التي كان اليونانيون مسيطرين عليها. ولكن تتجاهل هذه الدراسات أنه في أزمة جنق قلعة – شاناك في سبتمبر/أيلول 1922، وبعد هزيمة اليونانيين عند ساحل بحر إيجة عندما تواجه الأتراك والبريطانيون عند مضيق الدردنيل في تلك الأزمة، كان تقدير رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج أن التوازن العسكري يسمح له بسحق قوات مصطفى كمال ولكنه مُنع من أغلبية وزرائه الذين أجبروه على هدنة مودانيا في 11 أكتوبر/تشرين الأول ثم الاستقالة بعد ثمانية أيام. وبدأت في الشهر التالي مفاوضات لوزان التي رأس فيها اللورد كرزون الوفد البريطاني وانتهت بتلك المعاهدة التي حصل فيها الأتراك على مكاسب جغرافية وسياسية تفوق وزنهم على الأرض.
ولأجل ذلك، يجب البحث في لندن وليس في أنقرة عن أسباب اتفاقية لوزان. وعلى الأرجح، هنا ، أن فلاديمير لينين كان العامل المحرك لتغيير النظرة البريطانية إلى الأتراك، حيث انتقلت هذه النظرة من الخوف على وضع لندن في الهند ومصر من عواقب دعوة السلطان عبدالحميد (1876-1909) لفكرة «الجامعة الإسلامية»، وهو ما استمر تلمّسه بريطانياً مع تأييد مسلمي البلدين لحرب مصطفى كمال ضد الحلفاء (1919-1922)، إلى فكرة استيعاب بريطاني للكماليين، حيث عقدت روسيا البلشفية اتفاقية مع الجنرال رضا بهلوي بعد خمسة أيام من انقلابه العسكري في بلاد فارس في 21 فبراير/شباط 1921 أتاحت للحاكم الجديد المتحدر من تشكيلات القوزاق الإيرانية التي كان يقودها ضباط روس منذ عام 1879 تثبيت حدود معاهدة 1881 الفارسية- الروسية وإلغاء كل الديون والمطالبات الروسية في بلاد فارس وكسب البلاشفة مقابل الاتفاقية. ونصت الاتفاقية على منع وجود دولة ثالثة بأراضي البلدين تكون على عداء مع أحدهما، وكان المقصود بها بريطانيا التي أُجبرت على سحب قواتها من بلاد فارس عند جنوب القفقاس. كما نصت المادة السادسة على حق موسكو في إرسال قوات إلى بلاد فارس في حال وجود تهديد من هناك على روسيا (تم إعلان قيام الاتحاد السوفياتي في 30 ديسمبر/كانون الأول 1922) وهو ما أتاح لجوزيف ستالين إرسال قوات إلى ايران في خريف 1941 بعد تنحي رضا بهلوي بسبب ميوله نحو الألمان. وأصيب البريطانيون بالفزع عندما لحق مصطفى كمال بالفُرس في الشهر التالي وعقد اتفاقية موسكو مع البلاشفة، ثم أتبع الأتراك هذه الحركة بعقد اتفاقية أنقرة مع الفرنسيين خريف عام 1921، في وقت كان الكماليون في ذروة مجابهتهم لليونانيين حلفاء لندن غرب الأناضول. وزاد إحساس البريطانيين أن الدائرة ستغلق عليهم عندما عقدت روسيا البلشفية اتفاقية رابالو مع الألمان في 16 أبريل/نيسان 1922 وفيها أول اعتراف أوروبي غربي بالدولة البلشفية مع تعاونات اقتصادية وعسكرية.
كانت معاهدة لوزان انقلاباً بريطانياً على الذات وعلى سياسات سابقة وعلى وضع إقليمي تشكًل مؤخراً، حيث تمّ من خلال تلك المعاهدة إنشاء كيان سياسي جديد اسمه «الجمهورية التركية» ذو طابع وظيفي بعد أن وُضع مصطفى كمال بعيداً من موسكو وباريس، وفي وضع الموازن للحاكم الفارسي الجديد الذي كانت لندن ترتاب منه كثيراً. كما تمً من خلال المعاهدة التأسيس لوضع احتياطي مستقبلي من حرب عالمية جديدة كان كرزون يؤمن بشأنها بمقولة رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو 1917-1920 عن معاهدة فرساي عام 1919: «هذه ليست معاهدة سلام بل هدنة لمدة عشرون عاماً».
كانت أولى وظائف الأتراك الوقوف بوجه الاتحاد السوفياتي الذي باتت حرية الملاحة في مضيقي البوسفور والدردنيل، وفق معاهدة مونترو عام 1936 وأيضاً اتفاقية لوزان بضغط من البريطانيين، مقيدةً بالنسبة إليه بحسب المواد 5-6-7-8 وتخضع عملياً لسلطة أنقرة بعد أن كانت حرية الملاحة مفتوحة في معاهدة لوزان (المادة 23). حاول ستالين بعد الحرب العالمية الثانية في فترة الوفاق مع واشنطن ولندن 1945-1947 تجاوز معاهدة مونترو ولكن حسابات الرئيس الأميركي هاري ترومان بخصوص اقتراب المجابهة مع موسكو حالت دون ذلك، حيث كانت تلك المعاهدة بمثابة سدّادة تركية للزجاجة السوفياتية التي اسمها البحر الأسود، والذي أصبحت سواحله بعد الحرب سوفياتية أو لدول تابعة لموسكو ماعدا تركيا.
أيضاً، مثّلت اتفاقية مونترو رشوةً للأتراك بعد صعود أدولف هتلر لكي لا يكرّروا في أي حرب تحالفهم مع برلين كما فعلوا عام 1914. وبحيادهم في الحرب العالمية الثانية، لعبوا دوراً مؤثراً في حرف مجريات الحرب لغير صالح الألمان وشكّلوا سدّاً جغرافياً أمام هتلر منعوا بواسطته وصوله للشرق الأوسط بعد سيطرته على اليونان في ربيع عام 1941 في وقت كانت قوات حكومة فيشي الموالية للألمان مسيطرة على سوريا ولبنان وكان كل من رشيد عالي الكيلاني في بغداد والشاه رضا بهلوي في طهران ميالاً لبرلين ضد لندن.
ثالث وظائف أنقرة أتت في فترة الحرب الباردة بعد أن دخلت في حلف الناتو بفترة 1951-1952، وهي لم تكن وظيفتها الأساسية بالحلف أن تكون فقط جناحه الجنوبي الشرقي ضد موسكو، وهو ما كان أساسياً لدى الحلف، بل يبدو أنه تم إعداد أنقرة منذ الخمسينيات لكي تكون الجسر الإقليمي للحلف نحو تشكيل «ناتو شرق أوسطي» مرتبط بالمنظمة الأم في بروكسل، وذلك من خلال مشاريع «قيادة الشرق الأوسط» عام 1951 و«حلف بغداد» عام 1955. وكثُر الحديث عن هذا الحلف بعد حرب الخليج الأولى 1991 ولدى طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير عام 2004 بعد احتلال العراق. كما تجدد الحديث عنه مع اتفاقات أبراهام عام 2020، ثم عاد الحديث عنه بقوة بعد حرب 7 أكتوبر العام الماضي.
ولكن لم تستطع أنقرة متابعة دورها الوظيفي عند الغرب الأميركي- الأوروبي بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1989 وتفكك الاتحاد السوفيتي بعد عامين. ومن الأحرى القول إنه لم يعد لها وظيفة عند هذا الغرب. وتقاعست عن تلك الوظيفة عندما رفض البرلمان التركي فتح جبهة شمالية للقوات الأميركية لغزو العراق في 2003. وعندما توافقت واشنطن وأنقرة في فترة 2011-2012 على تعويم وتعميم إقليمي للنموذج الإسلامي الأردوغاني عبر الربيع العربي، فإن الأميركيين سرعان ما تراجعوا عن هذا الزواج المؤقت في عام 2013، وهو ما أنذر ببداية تباعد بين واشنطن وأنقرة، فكانت سوريا ساحته الرئيسية خلال الأحد عشر عاماً الماضية.
في فترة 1991-1993، سعى الرئيس التركي تورغوت أوزال إلى أداء وظيفة جديدة تتمثّل في «عالم تركي يمتد من بحر إيجة حتى تركستان الصينية» تلعب فيه أنقرة دور الحاجز بين الروس والشرق الأوسط ودور نقطة الضغط على الصين في خاصرتها الإسلامية. ولكن واشنطن لم تستجب لذلك. وفي فترة 1996-1997، اتبع رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، إسلامي التوجه، سياسة أثارت التوجس في الدوائر الغربية عندما أراد تشكيل رباعي أنقرة- طهران- بغداد- دمشق في ظل سياسة «الاحتواء المزدوج» التي انتهجتها إدارة بيل كلينتون ضد طهران وبغداد. والأرجح أن انقلاب العسكر الأتاتوركيين الأبيض في 28 فبراير/شباط 1997 ضده كان مدفوعاً من واشنطن. وفي فترة 2002-2012، حاول حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان تقديم نفسه لواشنطن كنموذج «إسلامي أميركي شرق أوسطي» لمحاربة أتباع أسامة بن لادن من خلال أتباع حسن البنا في عالم ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2011، وكنموذج جديد يحوي لبوساً إسلامياً يكون بديلاً عن الأنظمة القائمة الحليفة للغرب وغير الحليفة. ولكن الأتراك لم ينجحوا في هذه الوظيفة، وإن أظهرت واشنطن لفترة قصيرة بعض الاقتناع بذلك في فترة الربيع العربي عندما غطًت وصول الإسلاميين للسلطة في تونس والقاهرة. وقبل هذا، كانت هناك إرهاصات أميركية منذ عام 2005 حينما ضغطت واشنطن على الرئيس حسني مبارك لإشراك الإخوان المسلمين في انتخابات البرلمان المصري، وهو ما قابله الفرع الإخواني العراقي عام 2006، أي «الحزب الإسلامي»، بهدية لواشنطن من خلال كسره مقاطعة سنة العراق العرب للعملية السياسية الناشئة عام 2003 مع الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر و«مجلس الحكم».
في دولة ذات بنية متعددة القوميات والطوائف يسيطر السنة الأتراك منذ عام 1923 على مفاصلها السياسية- الإدارية- العسكرية- الأمنية وهم لا يتجاوزون إلا بقليل النصف من السكان، كان الضعف الظاهر يغطى عليه من خلال التعويم الدولي للدور التركي الخارجي. وحتى عندما كانت تظهر الهشاشة الداخلية لتركيا، يغمض الخارج عينيه بشأنها كما حصل في انتفاضات الكرد أعوام 1925 و1930 و1937-1938، وكما حصل إبان القمع العنيف لليساريين في السبعينيات والثمانينيات، أو حملات الإبادة والقمع العنيف للكرد بعد الثورة المسلحة لحزب العمال الكردستاني القائمة منذ أغسطس/آب 1984.
ولكن، منذ فشل أنقرة في فترة 1989-2012 في تثبيت دورها الجديد لدى الغرب، على غرار فترتي 1923-1945 و1951-1989، أمكن ملاحظة تباعد أميركي– تركي منذ ربيع عام 2013 عندما حاولت تركيا فرض حكومة مؤقتة للائتلاف وفصائل مسلحة في الشمال السوري لتخريب تقاربات واشنطن وموسكو في الملف السوري، ثم من خلال محاولة تشكيل فصيل مسلح جديد اسمه «جيش الفتح» في ربيع 2015 نتج عن تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لفصيلي «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» دفعته أنقرة، مع أطراف خليجية، لاجتياح محافظة إدلب ومنطقة الغاب وكاد يصل للساحل وحمص لولا توافق الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تدخل موسكو عسكرياً. وتلاقى الأتراك، المتضررون من تقاربات الكرملين والبيت الأبيض في سوريا، مع أطراف خليجية على فرض حقائق جديدة على الأرض السورية عسكرياً كردٍ على قرب توقيع الاتفاق النووي الإيراني. ثم تثلثت مساعي أردوغان ضد الجهد المشترك لموسكو وواشنطن بعد القرار 2254 من خلال تخريب وإفشال «مؤتمر جنيف 3» بين السلطة والمعارضة السورية في أبريل/نيسان 2016 عبر رياض حجاب الذي أوقف المفاوضات بمؤتمر صحافي من دون التشاور مع أعضاء وفد هيئة المفاوضات.
دفع هذا الفشل التركي أردوغان للرقص على ما بين الحبلين الروسي والأميركي. فهو منذ تقاربه مع بوتين بعد زيارة موسكو في أغسطس/آب 2016، ساوم وقايض الروس. فمقابل غض نظر موسكو عن تمدد الأتراك في خط جرابلس- الباب- إعزاز، تخلى أردوغان عن دعم مسلحي المعارضة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. ومقابل تخليه عن مسلحي شمال حمص والغوطة وحوران، سمح له الكرملين بالسيطرة على مدينة عفرين ومنطقتها عام 2018. ويبدو أن الكرملين كان يحسب بأن تقارباته مع الأتراك، التي وصلت حد إعطاء الأتراك نظام الدفاع الجوي «إس- 400»، تتيح له إحداث انشقاق تركي عن حلف الناتو. لذلك، غض بصره عن تعارض المصالح مع أنقرة في ليبيا والقفقاس وحرب 2022 الأوكرانية، مادام أن هذه التقاربات تخلق توترات أميركية مع أنقرة سرعان ما ظهرت في ملف طائرات «إف 35» وكذلك في الموقف من الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا.
ولكن يدرك الرئيس التركي أن وضعه ليس كوضع رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس 1950-1960 عندما اعتمدته واشنطن ومعها لندن كمنسّق إقليمي بعد دخوله في حلف الناتو. فهو في وضع معاكس، حيث لا ثقة به في البيت الأبيض في مرحلة ما بعد 2002-2012. كما أن الكرملين لا يثق به. ومؤخراً، وقف على باب مؤتمر «بريكس» في مدينة قازان الروسية ولم يسمح له بالدخول كعضو جديد. وبالتأكيد، أن أعضاء حلف الناتو وفي مقدمتهم الولايات المتحدة لن يغفروا له محاولاته الاتجاه شرقاً. ولا يستطيع الأتراك، بعد ظهور بوادر حرب باردة جديدة إثر الحرب الأوكرانية، الاستمرار في الرقص على الحبلين الروسي والأميركي، ولا يستطيعون تحمل تكلفة التوجه شرقاً وكذلك العودة لحضن الغرب، على الأقل مادام أردوغان في السلطة.
الآن وعلى أثر عدم قدرة تركيا على الاضطلاع بوظيفة إقليمية لدى المركز الغربي بعد انتهاء الحرب الباردة، وفي ظل بوادر عدم قدرتها على الاستمرار بالرقص على الحبال وعدم قدرتها على الاختيار بين معسكرين عالميين يتصارعان وعدم قدرتها على لعب دور مستقل، فإنها تبدو وكأنها فقدت دورها. والأرجح، أن استبعاد واشنطن لأنقرة، وهي التي كانت تسمى «ملتقى وممر أنابيب الغاز والنفط والترانزيت»، من مشروع الممر الهندي يعطي صورة واضحة عن الوضعية الراهنة للأتراك على صعيد شرق أوسط جديد يتشكل من خلال طاحونة حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول التي تزامنت مع ذلك المشروع.
من المرجح أن يعجّل فقدان الدور الخارجي في تحوّل تركيا إلى دولة هشة ومتناقضة البنية المجتمعية، حيث كان هذا الدور يغطي على تلك الهشاشة في فترة 1923-1989 ويهيل التراب فوقها ولكن لا يمنع تلمسها. كما من المرجح أن يسرّع تفجّر تناقضات مزمنة لبنية تركية مجتمعية تحتكر فيها السلطة قومية واحدة وطائفة واحدة في بلد متعدد القوميات والطوائف بين علمانيين وإسلاميين وسنة وعلويين وأتراك وكرد. وهذا وضع عاشته فرنسا داخلياً مع انحدار مكانتها العالمية الخارجية في فترة 1945-1958 حتى أتى شارل ديغول منقذاً ومانعاً لانفجار الداخل الفرنسي. ولكن هل هناك «ديغول تركي» يتولّى مهمة الإنقاذ؟
هنا، يمكن تفسير ماجرى في حلب بأنه متأتٍ من ضعف تركي، في نفس صباح يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024عندما حصل إنهاء للفصل الثاني اللبناني في حرب 7 أكتوبر، وهو فصل بدأه نتنياهو قبل شهرين ونصف، حيث أراد أردوغان من خلال دفع الجولاني إلى حلب إرسال رسالة للقادم الجديد للبيت الأبيض بأنه يستطيع تكملة ما بدأه نتنياهو في غزة ولبنان من حيث ضرب وقطع التمددات الايرانية في المنطقة، وتوجيه ضربة كبرى لطهران في سوريا بلحظة ضعف تعيشها، ولو تسبّب هذا بإنهاء الرئيس التركي تفاهماته واتفاقاته مع الرئيس الروسي التي بدأت في حلب عام 2016، الأمر الذي كان بداية الرقص التركي على ما بين الحبلين الروسي والأميركي، ويبدو أن أردوغان من خلال حلب 2024 ينزاح من جديد بعيداً عن الكرملين باتجاه البيت الأبيض.