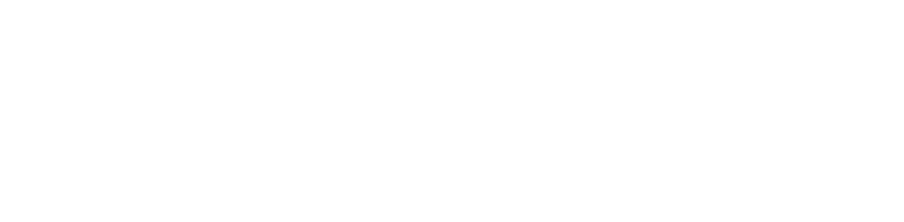حسين جمو
توجه وفد الجمعية الوطنية الكبرى إلى مؤتمر لوزان في تشرين الثاني/ نوفمبر 1922، بقيادة عصمت باشا إينونو ونخبة من السياسيين من بينهم رضا نور، الطبيب العثماني والوزير في حكومة أنقرة في ذلك الحين. كانت البلاد تحت حكم عاصمتين، أنقرة بقيادة مصطفى كمال باشا، وإسطنبول بقيادة السلطان العثماني. لكن الدول الغربية، المنهكة من الحرب، والمتطلعة بأي ثمن إلى فترة استراحة وبناء وتنمية، تسامحت مع أن يكون مصطفى كمال هو القائد في الصراع بين أنقرة وإسطنبول، لتسهيل مسار معاهدة لوزان، وبذلك اتخذت أنقرة قراراً تاريخياً في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1922 بإلغاء السلطنة العثمانية وإنهاء هذا الكيان السياسي المعمّر لمدة 600 عام. بهذا الإجراء، ضمن مصطفى كمال إلغاء الدول الأوروبية الدعوة الموجهة إلى حكومة إسطنبول لحضور مؤتمر لوزان إلى جانب حكومة أنقرة. بالفعل، اعترفت الدول الأوروبية في لوزان بوفد حكومة أنقرة في 11 من الشهر نفسه، وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر غادر السلطان محمد السادس إسطنبول على متن سفينة حربية أوروبية، منفياً إلى سان ريمو بإيطاليا.
بهذا ضمن مصطفى كمال تمثيلاً واحداً لبقايا الدولة العثمانية (الأناضول وكردستان وأرمينيا) وألغى أي إمكانية لازدواجية التمثيل السياسي في المفاوضات.
لقد رتّب معسكر مصطفى كمال الأمر باتجاه معاهدة لوزان على نحو دقيق. من غير المعروف ما إذا كانت الأطراف المنافسة لمصطفى كمال على القدر ذاته من التخطيط للخطوة المقبلة في كل حركة وإجراء. فبعد شهور من التفاوض في لوزان، وقبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، سارعت الشخصيات المهيمنة في أنقرة إلى حل البرلمان في 9 نيسان/ أبريل 1923. أي تم حل البرلمان الذي صوّت على تشكيل وفد حكومة أنقرة قبل شهور. لم يكن هذا البرلمان موحداً تجاه المعاهدة، فتم تشكيل مجلس جديد “أكثر اعتدالاً وانسجاماً مع التغييرات اللاحقة” على حد تعبير الأكاديمي السياسي التركي إيلبير أورتايلي في كتابه “أتاتورك”، وتم إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو 1923، وعقد أول اجتماع له في آب أغسطس. وكان أول عمل قام به هذا البرلمان هو المصادقة على معاهدة لوزان، بدون الاعتراض على أي بند فيها. لقد شكلت معاهدة لوزان الحجر الأساس للجمهورية، كما يرى أورتايلي. إن خطوة حل البرلمان كانت أساسية لإنهاء أي انقسام سريع في مرحلة لم تكن فيه سلطة مصطفى كمال راسخة بعد، خصوصاً لجهة ضرورة إزاحة أنصار لوزان من الكرد في البرلمان المنحل، فهؤلاء كان بينهم وطنيون كرد اعتبروا لوزان مكسباً مشتركاً لشعبي “الميثاق الملّي”، الكرد والترك، لكنهم سيرفعون لواء المعارضة ضد الجمهورية. بالنسبة للترك، فإن لوزان أساس الجمهورية. بالنسبة للكرد فإن الجمهورية ما هي إلّا إساءة استخدام لمعاهدة لوزان وخيانة من جانب واحد للميثاق الملي المشترك.
من وجهة نظر سياسية أعم، كانت الجمهورية ذات قضايا صغيرة متبقية بعد البناء على لوزان، مقارنة بملفات العثمانيين الكبرى في نهاية الحرب العالمية الأولى، وبطموحات أقل بكثير. لقد باتت “دولة قومية” بالمقاس المعتاد، جمهورية ذات لغة ودين وأرض، وهذا يتقاطع مع سياق عام إسلامي متراجع وواقع تحت الاستعمار في معظمه، ووقوع العالم التركي بمجمله تحت سيطرة البلشفية.
يقرأ رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، هذه المرحلة في كتابه “العمق الاستراتيجي” ضمن مسارات القوة الإقليمية والدولية. وبذلك فقدت النزعتان الإسلامية والقومية التركية، دورهما الحقيقي في تشكيل الأرضيتين الهامتين لإمكانية تكوين “الحديقة الخلفية” كمساحة تأثير تتحقق فيها المصالح في حوض القوة السياسية، الذي يشمل محور الأناضول والبلقان، والتي كانت إسطنبول مركزاً له. أدى هذا الوضع إلى توجه إدارة الجمهورية إلى إعلان يمكن له أن يلقى القبول من الناحية الدولية، وهذا الإعلان الذي صرحت به الدولة يقضي بتخلي الجمهورية عن كل المسؤوليات والطموحات الدولية، ويحتوي على عنصرين أساسيين:
الأول: تبني استراتيجية الدفاع عن الحدود القومية والدولة الوطنية بدلاً من الاستراتيجية ذات البعد الدولي.
الثاني: أن تكون الدولة التركية جزءاً من محور الغرب المتصاعد وليست بديلة أو معارضة له. (العمق الاستراتيجي – ص91)
لقد أخرجت معاهدة لوزان الجمهورية التركية، في الأراضي المتبقية من الدولة العثمانية، إلى ساحة التاريخ. هكذا يرى داوود أوغلو المعاهدة خلال مئة عام. بالنسبة له، فرضت لوزان على تركيا هويتين مزدوجتين، ومتضادتين:
أظهرت لوزان هوية خارجية للدولة تختلف عن هويتها الداخلية؛ إذ تم التخلي عبرها عن الهوية الإسلامية. أما في السياسة الداخلية فتم تحديد العناصر المشكلة للدولة على أساس استنادها إلى الأغلبية التركية صاحبة الهوية الإسلامية وتم تحديد الأقلية على أساس من هم من غير المسلمين فقط. وفي الوقت الذي انسحبت فيه الدولة العثمانية من المسرح التاريخي ببنيتها متعددة الأديان والأقليات، ظهرت مكانها الجمهورية التركية المستندة إلى مجتمع ذي دين واحد بأغلبية ساحقة، لكنها دولة قد تجردت من الرموز والمسؤوليات الدينية من خلال إلغائها مؤسسة الخلافة. (العمق الاستراتيجي- ص 92)
من الضرورة تكرار فكرة قابلية لوزان لتعدد القراءات. فكما ذكر أعلاه، بالنسبة للترك، فإن لوزان أساس الجمهورية. بالنسبة للكرد فإن الجمهورية أساءت استخدام معاهدة لوزان وارتكبت- من جانب واحد – خيانة للميثاق الملي المشترك.
من المهم في هذا السياق أيضاً قياس قوة الأمم في هذه المرحلة بإطلالاتها على طاولة صنع القرار الدولي. بمعنى ما، عشية لوزان، كان المجتمع الكردي بمقدار قوة المجتمع التركي، وبإمكانه حشد قوات ومقاتلين وعرقلة تسويات دولية، لكن لم يكن له تمثيل في الخارج في أي مرحلة من مراحل التسويات الكبرى، حتى في معاهدة سيفر لم يكن الجنرال والدبلوماسي العثماني الكردي شريف باشا في موقع قوة سوى أن الحلفاء أرادوا ممثلاً كردياً ولم يجدوا سوى شريف باشا قادراً على التحرك في أوروبا ولم يجد الكرد أيضاً غير شريف باشا. في المقابل، كانت قناة الاتصال التركية في غاية القوة، فهي تستند إلى ميراث نشط من العلاقات الدبلوماسية العثمانية الأوروبية ونشاط القنصليات وتقاريرها عن شخصيات الدولة. وذلك على النقيض من النشاط الكردي الذي أبعد نقطة له تكون من كردستان إلى إسطنبول! وهذا ليس مرتبطاً فقط بقصور الوعي لدى النخبة السياسية الكردية في ذلك الحين، إنما أيضاً بالإمكانيات المالية الضعيفة لهذه النخبة وعموم المجتمع الكردي حيث كانت الأصول المالية هائلة على شكل أراضٍ وإقطاعات، لكن المال بقي شحيحاً ولا يؤهلهم للعب أدوار مستقلة فاعلة بين العواصم.