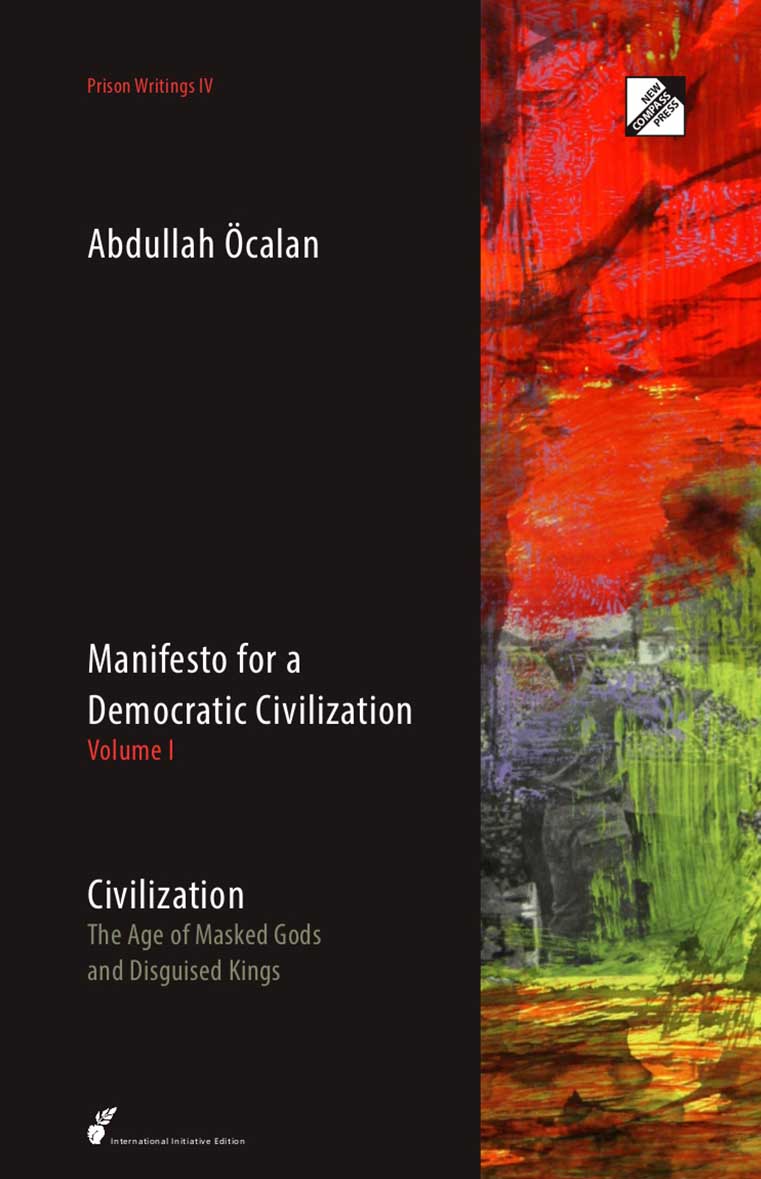البروفيسور دونالد ماثيوس – توماس جيفري ميلي- جامعة كامبريدج
مقدمة:
اخترق كل من البروفيسور دونالد ماثيوس وتوماس جيفري ميلي اللذان يعملان في الحقل الاكاديمي حاجز النقد السلبي المبني على المقاصد المبيتة والأحكام المسبقة حيال أطروحات المفكر عبد الله أوجلان، والاضطلاع بالدور النقدي البنائي في قراءة مرافعة أوجلان الأولى المعنونة بـ” المدنية” في سلسلة مانفيستو الحضارة الديمقراطية. والحق أن هذه الدراسة التأويلية، والتي اقتصرت على المجلد الأول “عصر الآلهة المقنَّعة والملوك المتسترين” بحكم ترجمته مؤخراً إلى اللغة الإنكليزية ساهمت في تحطيم الصورة النمطية الأوجلانية من الدائرة الشعبوية وإعادتها إلى نصابها الطبيعي من جهة ممارسة النقد البناء وتفكيك التصور الأوجلاني بصيغة منهجية محكمة.
المفارقة أنّ هذه الرؤية النقدية والمتزنة اطلت علينا من العالم الغربي بخلاف ما يسود في الحقل الاكاديمي والثقافي في الشرق أوسطي عبر تعتيم الأضواء وعدم المكاشفة، والانغلاق الإعلامي والعزوف عن قراءة مؤلفات أوجلان ناهيك عن عدم تدراك محتوى مشروعه المعني بالقضايا الإشكالية في كردستان والشرق الأوسط والعالم بصورة متداخلة، علماً أنّ مشروعه يتجسد عملياً في روج آفا- شمال سوريا، في الوقت عينه، تزاول الحركة الكردية التحريرية على الصعيد الممارساتي في صياغة “الكونفدرالية الديمقراطية” و”الأمة الديمقراطية” المتمثلة في أبعادها السياسية والدفاعية الحقوقية في كل من تركيا والعراق وإيران.
لا شك أنّ افتقار ظاهرة النقد البناء بحق مؤلفات أوجلان تتشابك مع المحاكاة التراجيدية لمسار العزلة الجسدية المفروضة عليه داخل زنزانته في جزيرة إيمرالي، وتالياً ينعدم خارجياً النقد الموضوعي المتوازن المستند عادة على قراءة النص وتحليله منطقياً بمنأى عن غايات دوغمائية وحملات تشهيرية مسيّسة.
ومن هذه الزاوية تحديداً تستحوذ هذه الدراسة أهمية جديرة، لا سيما عبر تجاوزها الحيز الشكلي الدعائي الملتبس، واستحضار مؤلف أوجلان تبعاً للقراءة التأويلية والتفسيرية المنسجمة مع مسار الفكر العالمي، بخلاف الدعاية المضادة التي تتداخل فيها الضغينة وغريزة الحقد والاتهامات الباطلة والأوهام المختلقة.
انصبت مساعي هذه الدراسة التي قامت بها العالم الاجتماعي الامريكي توماس جيفري ميلي وعالم الإلهيات دونالد ماثيوس على محاولة فهم النسق المعرفي والتاريخي الذي ينطلق منه أوجلان، وذلك عبر إبراز العطب البنيوي الذي أصاب التاريخ البشري، وعلى وجه الخصوص تاريخ الشرق الأوسط، حيث فجر الحضارة، المختزنة في طياتها جدلية “الحرية – الهرمية” القائمة على انقاض المجتمع الطبيعي العضوي، على ما عكس ما يروجه القول الاستشراقي الحداثي الذي يستثمر نسقه المعرفي في ترسيخ التاريخ الرسمي المعلن مع الثالوث” الدولة – الطبقة – التمدن”.
وتذهب الدراسة أيضاً في متابعة حيثيات نشوء النظام الأبوي التراتبي كطرح مضاد في مواجهة المجتمع الأمومي، متخذةّ من استعارات الذهنية الميثولوجية في شقيها الإيديولوجي والمادي كساحة للتناحر والإقصاء والتهميش، مع تصاعد ترجيح كفة الميزان لصالح العقل الذكوري التحكمي مع إعلان عصور الأديان التوحيدية مروراً بانهيار المجتمعات العبودية التقليدية، لتتجذر هذا التصور الإيديولوجي بمنوال حاد مع تبلور المجتمع التجاري الإقطاعي وتربع الديانة الرسمية المسيحية والإسلام على حيز الدولة والهيمنة والسلطة. في حين تسعى الشرائح الاجتماعية المهمشة خارج السلطة والطبقة والتمدن إلى تطوير عالمها الذهني والمادي بغرض صون وحماية الهوية الأخلاقية والسياسية والديمقراطية حسب ما جاءت في خاتمة البحث المذكور.
ونظراً لأهمية هذه المقاربة المستنيرة، يتحتم علينا من خلال واجبنا الثقافي والمعرفي في مركز الدراسات الكردية أن نتقاسم مع اعزائنا القراء هذه الدراسة الفريدة من نوعها، والقيام بتقديمها ضمن كتيب صغير، لعلنا نلتمس في القادم الأيام باكورة من الدراسات والأعمال التي تنحو صوب المقاربة النقدية السليمة بغرض تسليط الضوء على الفكر الأوجلاني.
مقدمة البحث
التقدير والاحترام لقائد حركة الحرية الكردية المسجون في تركيا، عبدالله أوجلان. يعيش أوجلان “حبيسا في سجن إمرالي” الذي يعد رمزاً للمقاومة والثبات والمرونة. أوجلان ذلك القائد المسؤول، وصاحب الرؤى السياسية القوية. تلك الرؤى التي ألهمت الثوريين في روج آفا داخل سوريا وتلك التي تغذي المقاومة الكردية ضد طغيان أردوغان في جنوب شرق تركيا (وأبعد من ذلك).
ولفتت المقاومة البطولية في كوباني، انتباه العالم بأسره، وساهمت إرادة الحركة في الكفاح وقدرتها على حشد الشعب للدفاع الذاتي الجماعي، وتضحيتها في سبيل القضية التي لا تعتبر كأي قضية عادية بل جيدة: يمثل مشروع الكونفدرالية الديمقراطية البديل الوحيد للمنطق السلبي للطغيان والفوضى الحالية التي تمزق الشرق الأوسط إرباً أو كما يسميه أوجلان البديل الوحيد “للحضارة القابعة تحت الهيمنة والتسلسل الهرمي”.
ويعتبر مشروع الكونفدرالية الديمقراطية في بنيته الهيكلية داخل روج آفا تجربة قائمة على الديمقراطية المباشرة والجذرية، والتي تعتمد على جمعيات المواطنين المحمية بدورها من القوات المكونة من المواطنين أنفسهم. هذا المشروع الديمقراطي الجذري يؤكد على التحرر بين الجنسين عبر تطبيق نظام الرئاسة المشتركة ونظام الحصص الذي يعزز بدوره المساواة بين الجنسين في جميع أشكال التمثيل السياسي من خلال تنظيم جمعيات وأكاديميات المرأة إضافة إلى التعبئة العسكرية للنساء في قوات نسائية خاصة.
هذه الكونفدرالية هي مشروع ديمقراطي جذري يعيد صياغة حق “تقرير المصير” كـ ديمقراطية مباشرة ضد الدولة التي تنبذ (بصورة خلافية ومثالية) المساواة بين النضال سعياً وراء الحرية الوطنية مع هدف إقامة الدولة القومية المستقلة، والتي تسعى بدورها إلى التغلب على خطر طغيان الغالبية عبر مأسسة نظام “ثوري توافقي”.
ويقوم هذا النظام التوافقي في “عقده الاجتماعي” بضمان التعدد العِرقي واللغوي والديني وللتذكير مرة أخرى ضمان المساواة بين الجنسين عبر تطبيق نظام الحصص فيما يتعلق بالتمثيل السياسي (بدقة أكثر للعرب وللمسيحيين) من خلال الجمعيات المباشرة للمكونات المختلفة وعبر تعبئة هذه المجموعات في قوى عسكرية خاصة للدفاع الذاتي.
وهي مشروع ديمقراطي جذري يؤكد على أهمية “البيئة الاجتماعية” والاستدامة البيئية على أرض تنزف تربتها نفطاً وتحوم في سمائها وحوش الإمبراطوريات الطامعة.
بالمجمل هذه التجربة هي بديل لمنطق الطغيان والفوضى، بديل لمكائد الإمبراطوريات وتوابعها القائمة على سياسة فرق تسد، وهي مشروع يجمع بين الديمقراطية الجذرية، الدفاع الذاتي، التحرر بين الجنسين، التعدد الثقافي والتعدد الديني إضافة إلى البيئة الاجتماعية. خارطة طريق حقيقية للسلام. خارطة طريق وضعت ممزوجة برسالة نَبَوية من قبل قائد مسجون. عبدالله أوجلان استطاع وبشكل خاص منذ اختطافه وحتى في أقسى الظروف أن يحافظ على بلاغته ونتاجه المثمر بشكل كبير عبر القيام بشرح نموذجه المسمى “الكونفدرالية الديمقراطية” بشكل مفصَّل – وبشكل أساسي كجزء من مرافعات الدفاع الخاصة به في جلسات محاكمته. من المفارقة أن المعتقل وفر مساحة من الحرية الفكرية للسيد أوجلان. تماماً كما وفر المعتقل من قبله مساحة لكل من تروتسكي، جرامشي، مالكولم إكس وحتى مانديلا نفسه. رغم وجوده خلف القضبان، إلا أنه قضى معظم وقته في القراءة (رغم محدودية الحصول على الكتب)، الكتابة والتفكير ملياً حول مأزقه ومأزق شعبه وذاك الذي يواجهه العالم المعاصر.
وترجمت هافن كونسر في الآونة الأخيرة المجلد الأول من مجلدات أوجلان الخمس المعنونة باسم الحضارة الديمقراطية إلى اللغة الإنكليزية. في مجلده المسمى ” عصر الآلهة المقنَّعة والملوك المتسترين” يشرع أوجلان بكشف الجذور التاريخية العميقة والهائلة التي تَعصف بـ “الحداثة الرأسمالية” ويعمل حتى على استعادة المصادر التاريخية الأكثر عمقا للبديل الديمقراطي الذي يقترحه.
وخاصة بالنظر إلى الظروف التي كتب أوجلان خلالها هذا النص، حيث يعيش في عزلة لا إنسانية مُعذبة ناهيك عن القيود المفروضة على الكتب، النتيجة تمثلت بإنجاز وجودي وفكري عال المستوى.
مناهضة النظام الهرمي
في مجلده الأول من سلسلة المانيفستو، يشن أوجلان هجوماً على النظام الهرمي في كل أشكاله. يقاوم أوجلان قيم داروين الاجتماعية العلمية الزائفة المهيمنة والمنتشرة على نطاق واسع والمهيمنة والتي تجسد وتعبر عن جوهر الأنانية التنافسية والولع بالنظام الهرمي، القيم التي من الممكن أن تحدد موقع هذه الأمراض الاجتماعية بالقرب من جوهر الطبية الاجتماعية، كمنتجات لعملية “الانتقاء الطبيعي” أو كأسلاك مترابطة في أدمغتنا أو حتى كرموز أو شفرات في جيناتنا. يصر أوجلان على العكس بأن جذور النظام الهرمي ليست عميقة إلى هذه الدرجة، حيث أنه لا يحدد هذه الجذور على أنها قريبة زمنياً من منشأ الطبيعة البشرية ولكن يعيد ظهورها إلى “ولادة الحضارة” قبل ما يقارب الـخمسة ألاف عام خلال فترة العصر الحجري الحديث. ويمضي أوجلان قدما برسم رواية جدلية قوية بين الهينة والمقاومة وبين الأبوية والحرية، التي حدثت حينها ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا.
وكما ميشال فوكو من قبله، الذي يناديه أوجلان هو ومعه (نيتشه) بـ “فلاسفة الحرية”، يؤكد أوجلان على “الجهود الاستثنائية” الموضوعة في عملية استجواب الأفراد عن طريق عقائد وأساطير لتبرير حالة السكون والخضوع تجاه النظام الأبوي والهيمنة. “يمكن تحقيق التنشئة الاجتماعية فقط عبر جهد متواصل وفي الواقع، يستحيل على أي فرد أن يستطيع التهرب من عملية بنائه وتنشئته وفقاً لـ أوامر المجتمع.” ورغم ذلك يدعي أوجلان قائلاً يستحيل أن تكون جهود مماثلة ناجعة بالمطلق. من الممكن أن يتم قمع الاندفاع نحو “الحرية” والحث على مقاومة “المجتمعات الاستغلالية، الظالمة، الأبوية والطبقية” ، ولكن يستحيل إطفاء نار حريقها. الأفراد “لن يقبلوا باستعداد المجتمعات التي تبني العبودية، رغم المحاولات المستمرة ليس فقط لتحويلهم عبر المؤسسات الاجتماعية التعليمية والظالمة بل للقضاء عليهم كلياً.”(صـ 72) النقطة الأهم هي أن كل هذه الأمور المقنعة والقوية تأتي من شخص قضى ما يقارب العشرين عاما من عمره في زنزانة انفرادية.
نهج أوجلان لا يمثل شيئا ما لم يكن طموحاً. نهجه يتطابق مع وعيه وحساسيته لـ نقد الإيمان الحداثي في ثالوث العلم والتكنولوجيا والتقدم، مدموجة بتقييمه الرصين بأن سجننا ضمن حدود “الحداثة الرأسمالية” يملك في نهاية المطاف قادر على فعل القليل مع “ماله” أو “سلاحه” أكثر من قدرتها على تقليص آفاق وعيينا.
إذا ما كنا سنصدق أوجلان، فأن قول رئيسة الوزراء البريطانية الأولى، مارغريت ثاتشر، المأثور حينما قالت “لا يوجد بديل عن النظام الرأسمالي” وإلى جانب إعلان فوكوياما حينما قال “بلغنا نهاية التاريخ”، هذان القولان المأثوران يعتبران أفضل تفسيرا ولكنهما نبوءات ذاتية التحقق، لأن “القوة الحقيقية للحداثة الرأسمالية” كما يُزعَم “تكمن في قدرتها على خنق الطوباوية – ومن ضمنها الطوباوية الاشتراكية والتي تعتبر آخر وأقوى من كل شيء – مع ليبراليتها.”(صـ 28)
إضافة إلى ذلك، فإن نتائج إفقار مَلكة الخيال لدينا ليست بأقل من المدمرة والمروعة كما يوم القيامة. خلف المظهر المزيف لليبرالية المثالية الغالبة ، يصر أوجلان على أن “الأشكال الحديثة للرأسمالية” قادت إلى تزايد ثقافة العدمية الواسعة الانتشار، مؤدية إلى إفراغ “ثنائية العداء للموت والحياة من معناها”، مما أدى إلى فصل الحياة عن كل جوانبها السحرية والشعرية.” النتيجة: “عصر الموت الأبدي المشابه ليوم الحساب” (صـ 37). عالم غير مستدام متصف بمثل هذه الحالات المرضية كـ “انتشار الأسلحة النووية، الانفجار السكاني، استنفاذ المصادر، تدمير البيئة، النمو المفرط للانقسامات الاجتماعية، وتفكك الروابط الأخلاقية” ناهيك عن “الحياة المرهقة التي فقدت سحرها” وكل ما سبق “يظهر لنا بأن نسق الحقيقة لدينا فشل”. (صـ 51)
كيف يمكن الهرب من هذا الطريق المسدود والمصير المأساوي؟ ثورة في الوعي باتت حاجة ضرورية ويجادل أوجلان مؤكداً أن قيامها ممكن، لأنه وببساطة “السمة الرئيسية في أذهاننا هي بنيتها المرنة”(صـ 73) ولكن عملية كسب “العقلية الجديدة” الضرورية تتطلب في المقابل، النقد الجذري المفصل، الذي يفضح جذور وأسباب وأصل أمراض “الحداثة الرأسمالية” بهدف استعادة وإعادة إحياء الإمكانيات البشرية الأقوى والأكثر استدامة والتي نُسيت على مر الزمان وظلت مكبوتة، وفي الواقع قُمِعَت بشكل مقصود.
ويعرّف أوجلان عبادة السلطة والتسلسل الهرمي وعبادة الدولة باعتبارها تكييف تقاليد متأصلة بعمق في أذهاننا وتقيّد رد الفعل اللاإرادي الإيديولوجي لدينا، وحتى أنها قادرة على استمالة حركات المقاومة، كما اتضح وربما على نحو مفاجئ خلال تجربة الدولة الاشتراكية. إذا ما فَسِدَت عبادة السلطة فإن ممارساتها أيضاً تَفسُد وحتى أكثر من ذلك. في الواقع، يؤكد أوجلان “أن إحدى أكثر الأمثلة بروزاً حول القوة المسببة للفساد يمكن إيجادها في تجربة الاشتراكية الحقيقية. (صـ 165) وهي الصعوبات المماثلة التي يواجهها هؤلاء الذين يريدون مقاومة ديناميكيات التسلسل الهرمي. على الأرجح يواجه هؤلاء صعوبات ومخاطر جدية فيما يتعلق بـ “ثقافة الهيمنة” المُتحَصِنة بقوة، بعد أن تم تحضيرها من قبل “المئات من الأباطرة المتوحشين والعديد من القوى المهيمنة الأخرى.” في الواقع، يستنتج أوجلان قائلاً “الأهمية الحقيقية لتلك المسألة تكمن في الاقتباس المنسوب لـ ميخائيل باكونين: إذا ما أخذت أكثر الثوريين المتحمسين، وخولته السلطة المطلقة، خلال عام واحد سيصبح أسوأ من القيصر نفسه.” (صـ 164 – 165)
كيف يمكن لهذه العقليات وردود الأفعال أللإرادية المتأصلة بعمق أن تنج في المقاومة؟ يؤكد أوجلان، في موازاة خطوط غرامشي، بأن “ناشطي ومنظري الحرية والاشتراكية يجب أن يحضروا حقولهم الخاصة بهم” حيث يجب أن “يشخصوا باستمرار ويعالجوا الأمراض المعدية التي تتولد أو تنتج عن علاقات السلطة” وحتى يجب عليهم أن “يحافظوا على مسافة بينهم وبين علاقات السلطة وكل مؤسساتها وخصائصها.” ولكن أوجلان يتجاوز غرامشي لـيصر على بناء الأشكال الديمقراطية المباشرة والجذرية للحكم الذاتي مثل النموذج الذي أطرّه أوجلاه بنفسه في كتاباته حول الكونفدرالية الديمقراطية. “إذا ما لم تغرس مثل هذه الأشكال الديمقراطية الغنية وإذا ما لم يتم رعايتها في نفس الوقت” يحذر أوجلان بأن هؤلاء المنخرطين في المقاومة “لن يتحرروا من شبكة السلطة، ولكنهم فقط سيعيدون تكرار ألاف المحاولات الفاشلة والتي لم تكن في النهاية مختلفة بأي شيء عن كل تلك أنظمة السلطة والحكم التي سعوا للتحرر منها.” (صـ 166)
تخلى أوجلان عن وهم أي فكرة خطية لـ “التقدم”. بالنسبة له يتطلب إيجاد الطريق نحو الأمام، عودة إلى الماضي العميق. فقط بالعودة إلى الماضي العميق، فقط عبر توفير “تفسير تاريخي صحيح لمشاكلنا”، واسع النطاق مع “إسناده إلى أصوله التاريخية”، نستطيع التأمل بـ”إضاءة مستقبلنا” (صـ 94 – 102). فقط بعد الإفصاح عن هذه الأصول التاريخية واستيعابها، سنكون حينها مستعدين لتجاوز ثقافة الكره والموت، ونحقق الانتقال إلى حياة يكون فيها الحب هو السائد والحاكم” (صـ 94).
ولكن رغم الاستناد إلى فرنان بروديل، فإن لجوء أوجلان إلى الماضي العميق، وشرطه الخاص بـ “تفسير تاريخي صحيح لمشاكلنا”، لم يتم إجرائه عبر التظاهر بأنه مؤرخ محترف سعياً وراء هدف غامض وبعيد المنال من “الموضوعية العليمة.” ولهذا السبب فإن اعتراف أوجلان الذي يقول فيه إن كتاباته “غير احترافية” لا يجب أن يقرأ فقط كلا يجب أن يقرأ فقط كتنويه وإيماءة بالتواضع (صـ 279). أوجلان من مؤيدي “المنهج الأسطوري”، الذي يصر أوجلان على “ضرورة إعادة” هيبته (المنهج).
ويظهر أوجلان التعارض بين منهج الأساطير في “العقيدة الدينية التوحيدية” و”العلم” والتي أنجحته. على الرغم من الاختلافات بين “أنساق الحقيقة” الوريثة بشكل متعاقب، يصر أوجلان على تشابههم ، فعلى الأقل يدعي كليهما إلى درجة الرضوخ أمام “القوانين المطلقة” (صـ 42). ليس كما في الأسطورة.
وبالتالي فإن “التفسير التاريخي” لأوجلان يعتبر الأفضل تفسيراً حيث يزود “أسطورة نبيلة”، لنوع من سرد سقوط الإنسانية واحتمالية استردادها في هذا العالم والذي يمثل في نفس الوقت مانيفستو ارتدادي لصالح الأسطورة ومضادة للعقيدة سواء الدينية أو النوع العلمي العلماني.
ويرثي أوجلان تحويل العلم إلى “دين جديد” والتي تأخذ “شكل الوضعية الفلسفية” مع “قوانينها الموضوعية” تمثل “لا شيء سوى المرادف الحديث لـ”كلمة الله” في العصور القديمة. (صـ 90، 53) العلم مع السلطة ورأس المال يشكلون “تحالف الحداثة المقدس الجديد”(صـ 91). العلم تحول إلى مصدر للتميمة ويتم تأليه العلم وتشكيل عقيدة عبر تحويل الكلمة بإضافة اختصار (-ism) لها لتصبح (scientism) أي “العلموية” ويتهمها أوجلان بالعجرفة. إدامة الإدعاء بأن العلم لوحده قادر على تقديم الحقيقة حول العالم والواقع”، سيؤدي “بهم إلى الاستخفاف ونبذ وإنكار كل ما لا يمكن فهمه عن طريق المنهج العلمي”. (صـ 79 هامش16).
ويؤكد أوجلان على الوظيفة الإيديولوجية لهذه اللاحقة الحديثة السائدة (-ism)، ويصر قائلاً إن “دنيا العلوم أصبحت القوة التي تبني وتشرّع وتحمي مناهج النظام ومحتواه” (صـ 48). ليس فقط نظام “الحداثة الرأسمالية” بل حتى نظام الدولة الاشتراكية أيضاً. ولكن في النهاية، سيزرع البذور لزوال ذلك البديل الكاذب.
وفقاً لأوجلان “لعب المنهج العلمي الموضوعي دوراً حاسماً في فشل الاشتراكية العلمية”(ص 48). وذلك لأن الأيمان بالعلم مرتبط بقوة بحكم الخبراء. “إحدى أكبر الأخطاء التي وقع فيها المنهج الماركسي” كانت إدامة مثل هذه القناعات النخبوية. وبفعل ذلك، ستكون قد ثبطت بنشاط “الثورة الذهنية” المطلوبة للبناء الديمقراطي لمجتمع جديد، بدلاً حقيقياً للتحرر الجماعي(صـ 53).
وحتى أسوأ من ذلك، حيث يزعم أوجلان أن “العقلانية” و”الوضعية” المتضمنة في العقيدة الجديدة للعلم مهدت الطريق وبإيجابية لـ “قطيع الفاشيين”. وفعلوا ذلك عن طريق غرس “الكائنات البشرية الميكانيكية والروبوتات” إضافة إلى “التصورات الزائفة للحياة” في أذهاننا دفعنا تجاه “دمار البيئة وتاريخ المجتمع”.(صـ 80)
الدوغمائية، سواء أكانت دينية أو علمية هي عدو للتحرر. وتقود إلى التشيؤ (إضفاء الطابع المادي)، لتقديم الترتيبات الاجتماعية القمعية والظالمة والهرمية ليس كبنيات اجتماعية، بل كقوانين ارتدادية غير قابلة للتغيير، كـ قوانين “مقدسة”، كقوانين “غير قابلة للتغيير” كقوانين “مؤسسة ألهيا”.(صـ 70 – 71)
التركيز على النظام الأبوي
إحدى الأجزاء الأكثر إثارة للانتباه في سردية أوجلان هي الاهتمام الوثيق الذي يوليه لقضية النظام الأبوي والروابط التي يقيمها بين القمع الذي تتعرض له النساء بشكل خاص والقمع بشكل عام. ووازن أوجلان في مكان آخر ضمن كتابه الأبوية بـ “استعباد النساء” وشخصّها عبر القول إنها “المجال الاجتماعي الأكثر عمقاً وتنكراً حيث يمكن إدراك جميع أنواع الاستعباد والقمع والاستعمار” (الكونفدرالية الديمقراطية | صـ 17).
في مجلده الأول من سلسلة المانيفستو يتوسع أوجلان في شرح هذه القضية. والمفارقة تكمن أنه لا يستشهد أوجلان بـ كارل ماركس أو إنجلس )، بل على العكس بـ نيتشه لتحقيق غايته مشيراً إلى حديث الفيلسوف الألماني الذي يتحدث “حول كيفية تبني المجتمع للسمات المشابهة للزوجة وكيفية استعباد المجتمع من قبل الحداثة” (صـ 82). وعلى نحو أكبر، يعتمد أوجلان على الباحثة النسوية (المدافعة عن حقوق المرأة) ماريا مايس في رسم تحليلات متسمة بحدة الملاحظة والإدراك للعلاقات بين النظام الأبوي والتسلسل الهرمي وفي تتبع أصولهم المتبادلة.
ووفقاً لأوجلان فإن النساء وبشكل منتظم تعانين من الحالة القمعية المسماة (تدجين المرأة في المنزل) – ويطلق عليها “أكثر أشكال الرق تقدماً.” ولكن لتزداد الأمور سوءاً، في الحداثة الرأسمالية، دُمجت مثل هذه العبودية للمرأة أو ربما تمت تغذيتها من خلال “تدجين الرجل في المنزل– بعد عملية إخصائه عبر المواطنية” (صـ 91). الحداثة الرأسمالية المتميزة بسعيها الحثيث لإخضاع الجميع في “المجال العام” – عملية إخضاع مصنوعة ببراعة عن طريق صورة ومظهر إخضاع البعض، النصف والنساء في “المجال الخاص” المنزل.
ويصرُ أوجلان على أن البديل الديمقراطي يتطلب تبديلاً للنظام العائلي الحالي “المُستَنِد على الجذور العميقة لاستعباد النساء” وإقامة نظام جديد كلياً “قائم على جذور عميقة للحرية والمساواة للمرأة.” استيفاء هذا الشرط قد يبشر بالمقابل بالمساعدة “في إلغاء التسلسل الهرمي الذكور النظام الدولتي الذكوري.” (صـ 94)
وفيما يتعلق بمنشأ عملية “تدجين المرأة” وهي “الشكل الأكثر قدماً للاستعباد” يجادل أوجلان مؤكداً بأنه تمت مأسسة هذه العملية كنتيجة لهزيمة المرأة من قبل الرجل القوي ومريديه”، هزيمة “تطلبت حرباً طويلة وشاملة”، في الواقع صراع “شديد وشرس” إلى درجة أنه “مُحي من ذاكراتنا جنباً إلى جنب مع عواقبه التي نتجت عنه.” النتيجة وفقاً لأوجلان: “النساء لا يتذكرن ماذا خسرن، أو أين تمت عملية الفقدان كما ولا يتذكرن كيفية الفقدان. وهي نفسها تعتبر المرأة المطيعة أو المُنقادة حالتها الطبيعية. ولهذا السبب لم تتم شرعنة أي عملية استعباد عبر الاستدماج بحجم الشرعية التي أُضفيت على استعباد المرأة” (صـ 163)
إن حالة فقدان الذاكرة المرتبطة بصدمة الإخضاع والتي تفاقمت عبر التحيز الأبوي الذي بني في السجل التاريخي وينتج عنه التشيؤ، الماهيوية الجوهرية والسكون المتجنس من قبل المرأة، وحتى الهوية المتجنسة وهويتها المتجانسة مع تبعيتها للمجتمع.
هذا التوصيف بالتأكيد ليس جدلياً، حتى وإن كان على أساس نسائي. ويمكن القول إن شيئاً ما من احتقاراً ل نيتشه – إذا ما لم يكن احتقار النساء أو على الأقل الأنوثة – يمكن استبيانه من القيمة الوظيفية لمصطلح أوجلان المستخدم “زوجة البيت”. ازدراء واحتقار ينعكس في إدراج أوجلان “البكاء” بين أعراض الخضوع و”تدجين المرأة”. يبدو أن أخلاقيات الرعاية، ناهيك عن أخلاقيات الحِداد تقع خارج أو في موقع أبعد من الآفاق النظرية التي تطلعنا على شعار أوجلان النسائي كما في كتائب “الدفاع الذاتي”. على الرغم من ذلك، فإن شعاراً مثل الميليشيات النسوية هو في الواقع، جسم وجسد واحد أسس من قبل قوات حركة الحرية الكردية النسائية.
ولكن فلنعد إلى معالم سرديات أوجلان الكبرى حول أصول التسلسل الهرمي. إن التحيزات الأبوية العميقة الجذور والخبيثة التي تعصف بالتسجيلات التاريخية تساعد على تبرير تفسيرات أوجلان الهرطقية – أو في الواقع الأسطورية – حول المساواة الجنسية في العصر الحجري الحديث – وهي فترة أساسية في سرديات أوجلان الأوسع حول ظهور التسلسل الهرمي.
ووفقاً لأوجلان فإنه وقبل سقوط الإنسانية أي قبل انحدارها المحتوم إلى القمع وعدم المساواة، كان هنالك “لحظة خلق” و”لحظة كوانتوم” “وفاصل فوضوي” والذي كانت بؤرته الزلزالية تتموضع في الهلال الخصيب. حيث حدث ما أطلق عليه جوردون تشايلد اسم “الثورة الزراعية”. كانت هذه الفترة إشارة على نهاية “الحياة الرتيبة القائمة على الصيد والتجمع والدفاع” لـ “مجتمعات العشائر التي تعود إلى مئات ألاف السنين”. ومع الانتقال إلى “الحياة المستقرة والزراعة”، وفر مجتمع العشائر الطريق لـ “التركيبات الأوسع” ومن ضمنها “ولادة الروابط الأثنية”. لقد كانت حقبة مليئة بالاضطرابات الهائلة والخصوبة الخلاقة كما وشهدت “ألاف الثورات العقلية”. ومن أبرزها إدخال واختراع “عدد كبير من الأغذية، وسائل النقل، النسيج، الطحن والهندسة المعمارية” فضلاً عن الأشكال الرمزية المعقدة للتعبير الديني والفني.(صـ 122 – صـ 124)
وكانت الآلهة الأم إنانا تُعتبر “رمز مجتمع العصر الحجري الحديث”. عبادة الآلهة الأم زادت بشكل متناسق ومتواز مع انحدار الطوطم “هوية مجتمع العشيرة القديم” والتي تراجعت بشكل كبير.(صـ 122) وعكست شعبية إنانا بالمقابل الدور البارز للمرأة في هذه الفترة الزمنية. في الواقع، وفقاً لأوجلان “خلال فترة العصر الحجري الحديث، كانت المرأة الأم هي القوة الدافعة”. (صـ 139) مما أضفى عليها سمة التقديس.
وتبقى فضلات هذه “اللحظة الكوانتومية” متأصلة كالرواسب التي تنجو في النفس البشرية وهي قادرة على إعادة الإحياء، العودة مرة أخرى لإعادة هيكلة العلاقات الاجتماعية. ليس فقط على صعيد العلاقات بين الجنسين. في الواقع فأن مجموعة كاملة من “القيم الأخلاقية الثمينة .. أغلى” من قيم الحداثة الرأسمالية – قيم مثل “الاحترام، المودة، وعلاقات الجوار والتضامن” – وهي منتجات وبقايا هذه الحقبة الزمنية (صـ 123). وبالتالي لهذه القيم أساس تاريخي عميق وهي تدعم الإرادة الغير قابلة للتمييز لمقاومة الأشكال الاجتماعية الهرمية والقمعية. ولقد تم تجميد ونقلها في ذكريات جمعية لم تتعرض للقمع الكامل. ويتضح ذلك، على سبيل المثال، في “سرديات الكتب المقدسة”، حيث تتسامى ذاكرة هذه الأوقات إلى “فكرة الجنة” (صـ 124). جنة من المستحيل أن تفقد كلياً، جنة يمكن استعادتها.
وفقاً لـ سرديات أوجلان فإن الانحدار إلى التسلسل الهرمي والأبوية وعدم المساواة الطبقية ظهرت مع صعود السومريين الذين تسرد لنا أساطيرهم الأساسية “التنافس بين إله الذكور إنكي وبين الآلهة الأم القيادية”، وهو تنافس كوني بين الآلهة التي يفسرها أوجلان على أنها تعكس وتظهر التحولات في العلاقات المادية والاجتماعية – وبشكل خاص – “التحول من مجتمع قرية العصر الحجري الحديث الذي لم يسمح بالاستغلال إلى المجتمع المدني – المؤسس حديثاً من قبل الكهنة – والذي كان مفتوحاً للاستغلال” (صـ 139).
وهكذا يعود أوجلان ليوظف مذهباً مادياً تفسيرياً للمعتقد الديني. في حين أن بروز إنانا في التعبيرات الدينية للهلال الخصيب خلال فترة العصر الحجري الحديث هو دليل وانعكاس “للقوة الاجتماعية للسلطة القيادية والإبداعية في العصر الحجري الحديث وبشكل خاص النساء” التنافس معها ونهوض العبادة للإله الماكر إنكي كانت إشارة على صعود بروز طبقة اجتماعية جديدة “الطبقة الكهنوتية” والتي تسامت “وتعالت في الدين الجديد”.(صـ 140).
الدين وطبقة الكهنة والنظام الهرمي
تدفع أعمال أوجلان الشاملة والمعقّدة على نحو رائع، الباحث الديني إلى التفكير بشكل معمق حول الأمر، حيث أنه لا يستفيد فقط من تاريخ الدين في تفسيراته لتطورات الدولة الأمة الحديثة ولكنه يضعها في صلب تفسيره. هذا التفسير جدير بالملاحظة بين النظريات الثقافية التي ترى الدين فرعاً للعوامل الأكثر صِلةً بالتغيير الاجتماعي الموجود في أعمال الماركسية الجديدة (ميشيل فوكو – جام ديريدا- النظرية النقدية) أو من قبل الباحثين الدينيين المختصين بتاريخ الدين (إلياده – لونغ – سميث – j.z) الذين وضعوا هدفهم في عالم الدين الخيالي عندما يؤكدون فرادته وتميزه وكأنه شهد تأثيراً سياسياً أو اجتماعياً صغيراً في هيكلة طبيعة المجتمع الديمقراطي الحديث. أوجلان وعبر إسناده المتواصل للحركة انطلاقا من عبادة الآلهة الأم في العصر الحجري الحديث” النيولوتيك” إلى مرحلة ما بعد العصر الحجري الحديث المُهيمن عليه من قبل التصور الديني الذكوري، يضع الدين في مرتبة القيادة إن لم تكن القوة الدافعة الخفية التي فهمتها الحداثة وهيكلت طبيعتها السياسية وفقاً لها.
تلعب “الطبقة الكهنوتية” السومرية بشكل خاص دوراً شائناً في تفسير أوجلان. ولا يقتصر الأمر على تمثيلها لولادة الانقسامات الطبقية، بل يقع على عاتقها اللوم في قضية إخضاع المرأة، وهي المسؤولة عن الانتقال من نظام الإيمان الميثولوجي إلى نظام العقيدة الدوغمائية التجريدية. وفقاً لأوجلان فإن مهمة الكاهن الرئيسية – المهمة العلمانية التامة – “كانت إدارة متطلبات المجتمع الحضري المتنامي” (صـ 142). ولكن في نفس الوقت احتكرت إمكانية الوصول لعالم الآلهة المجردة، لأن “أي شخص أراد الاستماع لكلمة الله كان عليه إطاعة الكاهن الأعلى.” هذا الاندماج بين هذين الدورين جعل طبقة الكهنة “المجموعة التي تحمل المسؤولية الأكبر لتشكيل حضارة الحداثة والحضارة بشكل عام” (صـ صـ 140-141).
عبر تعزيز سلطة الكهنة، رجحت كفة التنافس بين الإله الذكري الماكر” إنكي” والآلهة “إنانا” لصالح الأول. “مع مرور الوقت تقلصت أعداد تماثيل الآلهة المرأة بشكل تدريجي” ومع “بداية الفترة البابلية، دُمِرَت الآلهة المرأة” بشكل تام. وهنالك إشارة أخرى إلى القمع المتزايد بحق المرأة والمتمثل بإخضاعها اليوم عبر الدعارة الرسمية العامة والخاصة فضلاً عن العبودية”. (صـ 146)
الكهنة السومريون كانوا السباقين في إخفاء سلطتهم، وتمكنوا من تشريع عمليات السلب وتجريد الملكية التي نفذوها عقب ظهور الآلهة المقنعة التي قام الكهنة السومريون حينها بتأدية طقوسها الدينية إضافة إلى تنظيمها. ولكن الملوك سوف يتعلمون قريباً من الكهنة هذه الخدعة الأكثر فائدة. (صـ 149) تمكن هؤلاء الرجال المقنعون من إلقاء تعويذة على أولئك المُستغلين والشريحة الكادحة الذين بدوا وكأنهم يعيشون تحت تأثير المخدر وقبلوا وبشكل متزايد أوامر وتعليمات الآلهة التي صُنِعَت حديثاً”.(صـ 159)
لم ينفصل قط اهتمام أوجلان بالتاريخ العميق نسبياً عن مخاوفه حول الحاضر. في الواقع، يُصِر أوجلان على أن التحليل السليم وفهم عملية الانحدار نحو النظام الهرمي الذي حققه المجتمع السومري، يُبشر بـ “تعزيز فهمنا لمجتمعنا الخاص.” وذلك لأن تحليلات كهذه تساعدنا في تعريف و”إزالة الأقنعة التي تغطي هذا النظام” لرؤية الاستعارات الغامضة المُشرعنة والمُهيمِنة في التاريخ، ولرؤية “الوجوه الصحيحة، والمنافع الحقيقية، والوضع الفعلي لمختلف اللاعبين” في المجتمع المعاصر. (صـ 154)
ويجزم أوجلان بأن نوبة الإخضاع ومن ثم النظام الهرمي اللتان تشكلتا في البداية على يد طبقة الكهنة السومرية لم يتم تحطميهما حتى الآن. في الواقع، قام أولئك الذين أدعوا بأنهم تمردوا نصرة لدينهم، لقوميتهم أو لقبيلتهم بالاستيلاء على “تاج السلطة”.(صـ 157) وبقي الانقسام الطبقي الذي أحدثه الكهنة السومريون “سمة أساسية للحضارة” منذ ذلك الحين. على نحو استفزازي، يُصر أوجلان :” في القليل من الحالات التي أطاح فيها الرعايا والطبقة الكادحة أنظمة السلطة، عادة ما كانت الإدارة الجديدة أسوء بكثير من النظام الاستغلالي والقمعي السابق” (ص 160). وجنباً إلى جنب مع ذلك وكأداة لظهور النظام الهرمي وظهور الدولة المكرسة بعبادة حُكامها الذين كانوا وراء ظهور الآلهة المقنعة. الدولة التي يُعرّفها أوجلان بأنها “وحدة علاقات القوة التي يتم من خلالها تمكين الإكراه العام واستغلال المجتمع المُصنّف طبقياً” (ص 158). الدولة التي تميل مع تطور الحداثة الرأسمالية إلى الاندماج مع الأمة في إله جديد أقل تنكراً ألا وهو الدولة الأمة” (ص 54). يستنتج أوجلان قائلاً لا تزال عبادة النظام الهرمي حيّة في ظل الدولة الأمة المعاصرة وهو “الإله الذي أزال قناعه” والذي “يتم تقديسه” في كافة المجتمعات المعاصرة. (ص 81)
وبالتالي يتطلب التخلص من النظام الهرمي فك الارتباط مع أدوات الدولة القوموية، إضافة إلى تبني إستراتيجية منضبطة قائمة على مقاومة القوى المخدرة الناعمة والتابعة للطبقات الكهنوتية المعاصرة. تعتبر عملية فك تشفير وفهم مصدر هذه القوى المنوِّمة الخطوة الأولى في هذا الاتجاه – وهنا تنشط فعالية الفئة الدوغمائية.
سعت طبقة الكهنة السومرية إلى تشريع حالة عدم المساواة الناشئة، تشكيل الطبقات الاجتماعية، وانقسام المجتمع إلى طبقتي المُستغِلين والمُستغَلين عبر الإشراف والتشجيع على زوال “المنهج الميثولوجي” والاستعاضة عنه بـ “التصور الديني الدوغمائي (العقائدي الجازم)”.
وفقاً لأوجلان فإن :” العلاقة بين الطبقات المُشكلة حديثاً من المُستغِلين والمتعرضين للاستغلال تتطلب وجود عقائد غير قابلة للجدل” وقادرة على “التنكُر وتشريع الاستغلال وسلطة التسلسل الهرمي على حد سواء إضافة إلى تشريع مصالح الطبقة.” الحكام المطلقون، المهيمنون، والمستغلون أخفوا أنفسهم خلف قناع الإله، وليس أي إله!! بل ذلك الذي “وُهِبَ ميزات وخصائص لا جدال فيها” وكُشِفَ عنه في نصوص مقدسة تحتوي ظاهرياً على “كلمات معصومة عن الخطأ” (ص 43). وبالتالي فإن الانتقال من “المنهج الميثولوجي” إلى “العقيدة القاطعة والمجردة” أو التي يطلق عليها مصطلح “الدوغما” يرتبط باختراع اللغة المكتوبة، وكانت سلطة الطبقة الكهنوتية قائمة على لعب دور مُفَسِر كلمات الآلهة المعصومة الواردة في النصوص المقدسة والتي لا تقبل الجدل. تعزيز دور الطبقة الكهنوتية كقناة ومُفسر لكلمة وإرادة الآلهة عنى استحداث عملية إخضاع جديدة “شبيهة بالعبودية” وتشكيل “تصور قاتل” لدى الجانب المُسَتغَل. وبالتالي “تأسست” “جدلية الراعي والقطيع” (ص 44).
ويُشخص أوجلان الدوغمائية على أنها مرض روج له في بادئ الأمر من قبل الطبقة الكهنوتية السومرية ولا تزال الدوغمائية تُشكل لُب إيديولوجية التشريع في النظام الهرمي. بخلاف المقالات النقدية الصادرة عن الملحدين الأرثوذكسيين، فإن نقد أوجلان لا يدخل في إطار القيام بـ”إزالة الغموض” بل يركز على عمليات الاستيلاء التي نفذتها الطبقة الكهنوتية إضافة إلى تشريح الدعاية العقائدية المرافقة.
يوضح أوجلان بأنه ليس عدو الصوفية، المُقدس أو الإلهي بحد ذاته. بل على العكس، المشكلة لديه تكمن في أولئك الذين يتنكرون بقناع الآلهة ويدعون أنهم قناة وصل بين الإله والناس عندما يبررون الاستغلال والحكم الاستبدادي. في الواقع، يشير أوجلان من خلال الأسباب التي يقدمها حيال إعجابه بالعصر النيولوتيكي أثناء مقارنته إياه بالحداثة الرأسمالية المعاصرة، إلى تناغم مزعوم بين العصر الحجري الحديث والطبيعة، كما بدا منعكسا في رؤيتهم للطبيعة “مملوءة بالقداسة والإلوهية.” وفقاً لأوجلان:” في العصر الحجري الحديث لم يكن للإلوهية أي علاقة بالإكراه، الاستغلال، والاستبداد” (ص 239).
الطبقة الكهنوتية السومرية كانت من أدخلت هذه العلاقة – حيث كانوا مولعين بالتجريد بإسنادهم الغير مألوف “للعقوبة والخطيئة في فكرة الله” لغرض تطوير “شعور الطاعة.” هذه الابتكارات سمحت لفكرة الله أن تندمج ببطء مع الدولة وأن تتحول إلى الدولة. هذا هو مفتاح “الإصلاح الذي أحدثه الكهنة السومريون” (ص 167).
العقوبة والخطيئة المُرتبِطين بوعد الحياة الآخرة – وهو ارتباط يُزعم أنه ظهر بداية في سومر ولاحقاً في مصر ومن ثم ورثهُ التقليد الابراهيمي. أكثر من مجرد ارتباط هو “نموذج للجنة، الجحيم وحياة قادمة.” يجزمُ أوجلان بأن هذا الارتباط وهذا التصور الفكري وفرا أداة حاسمة وشرعية قوية كانت ضرورية لهم لإقناع العبيد الذين بالتأكيد لم تكن حياتهم سهلة” (ص 194). “أداة شرعية قوية” قادرة على استحضار الخضوع والسكون في هذه الحياة عبر إعطاء الوعود بمكافأة في الحياة القادمة. “إسقاط طوباوي”، “وعد بالجنة”، و”الحديث عن آلاف السنين من السعادة”. يضيف أوجلان قائلاً إن كل ما سبق يذكره بـ “التوق الشديد لواحة خضراء” وبالتالي يُخمن أوجلان انعكاسا لنقيضها “الحياة العقيمة.” تتكرر أصداء عبارة بوب مارلي “لو كنت تعرف قيمة الحياة، لبحثت عن حياتك على الأرض”. ولكن أوجلان يذهب أبعد من ذلك، حيث يستنتج في إطار عِلماني مُحكم، قائلاً “التنقيب عن الجنة ليس إلا وعداً بمستقبل في عالم جديد” “مرفأ بناه حتماً أولئك الذين فقدوا الأمل” (ص 274). نقطة جدلية ولا شكوك حولها لأن الإيمان بالجنة قادر وبسهولة على استحضار الشجاعة للكفاح والاستعداد للموت من أجل قضية بدلاً من السكون والخضوع للوضع الراهن. سجل التاريخ مليء بالأمثلة.
ويدرك أوجلان الأمثلة المتعلقة بذلك. في الواقع يعطي إشارات واضحة للعديد من “الحروب التي نشبت تحت اسم الإسلام، المسيحية واليهودية” ولكنه على الرغم من ذلك يُفسّر هذه الحروب على أنها في “جوهرها صراعات تهدف إلى الهيمنة على الحضارة الشرق أوسطية” حيث يلعب الدين دوراً مساعداً على الحشد كما أنه يكون ذريعة أيضاً “ما يخفي السبب الحقيقي وراء الحروب الدموية.”
الفعالية الذرائعية للمعتقدات الدينية ستصبح أكثر شفافية عندما يتم اعتمادها لاحقاً بشكل مباشر من قبل الدولة وإعلانها “إيديولوجية الدولة الرسمية”. على النقيض من ذلك، وفي إطار المشاريع الوطنية والدينية المهيمنة التي تمأسست في دول بعينها، عكست ووجهت عملية تعبئة المشاعر “الطائفية المخالفة” والموالية “صراع طبقي” وعبّرت عن “توجه ثوري للمجتمعات الهامشية المستبعدة من المجتمعات المتحضرة”. وكما هو الحال في الحروب الدينية بين الدول، يُصر أوجلان، على أن الصراعات الطائفية داخل الدول (مرة أخرى) في أفضل تفسير هي في كثير من الأحيان “ذريعة” تخفي الأسباب “الحقيقة”، في الحقيقة، “نوع من القومية” (ص 169).
ويعرض أوجلان هنا التأثير العميق والمستمر للفكر المادي والإيديولوجي على تأويله – بل يبدو وكأنه يغازل ميزات قائمة على فصل مزدوج للوعي الديني تزامناً مع ميزات مهدئة ومسببة للخلاف على نحو خطير في نفس الوقت. تأثير تاريخي مادي ودافع، ولنكون أكثر دقة، ينظمهما أوجلان بشكل ثابت نسبياً في تفسيره للإسلام في الماضي والحاضر على حد سواء. في الحديث عن ولادة الإسلام، يجادل أوجلان سيادة ما فوق الطبيعة ويخضعها إلى تشريح القوى السببية الدنيوية، مدعياً بأنه لم يكن “معجزة في الصحراء” “ولكنه نتاج مادّي وإيديولوجي مع ظروف تاريخية” (ص 269). وبالمثل، عند الحديث عن “الإسلام السياسي أو المتطرف” في الوقت الحاضر، يؤكد أوجلان “الحاجة لفهم جوانبهما الهيكلية” (ص 272).
بالتناغم مع تأيده للمنهج الميثولوجي، يحد أوجلان من نقده للدين إلى نقد الدوغماتية الدينية. ويرفض ثنائية” الروح- المادة” وحتى أنه ينكر إمكانية “تفسير الغنى في الحياة من خلال عقيدة (دوغما) الخالق الخارجي”. وحتى مع ذلك، يصر أوجلان على موقفه، حيث يقول ” لا معنى أبداً للدفاع عن ضرورة بقائه ضمن إطار الحياة المادية فحسب” (ص 62 – 76 – 77). ولعل الأهم من أنه يعتبر الدافع الديني أقرب إلى الدافع الفني أو حتى الدافع لغرس المعرفة – والأهم من ذلك “الميزات الميتافيزيقية” يزعم أوجلان بأنه “لا مفر” من “دوام الحرب، الموت، الشهوة، الشغف، والجمال.. الخ” (ص 76 – 77).
بالنسبة لأوجلان فإن المعتقدات الدينية ترتبط بشكل وثيق بالذاكرة الجمعية. وهذا يساعد على توضيح دوامها حتى الآن. لا تزال تحظى الكتب الدينية المقدسة بالوقار ليس بسبب جاذبية معتقداتها ومبادئها حول “إلهٍ مُجرد” أو حتى “طقوس” مرتبطة بها بل لأن “الإنسان يمكن أن يشعر بمعنى وآثار حياته وقصصه الخاصة في هذه الكتب.” إنها كتب تحتوي على “ذاكرة المجتمع الحي” التي لن تتخلى عنها الإنسانية بسهولة” (ص 117).
قضية التوحيد
تطورت رؤية أوجلان وتوجهاته عن الدين خلال السنوات العشر الأخيرة. في كتابه جذور الحضارة (صدرت نسخته الإنكليزية عام 2006)، يؤكد أوجلان العلاقة بين الدوغماتية (القطعية) والأديان الرسمية المكرسة لشرعنة وإدامة النظام الهرمي. على الرغم من ذلك، في عمله المذكور آنفاً، فإن توجه أوجلان يعتبر ودود نسبياً تجاه التوحيد، مدّعياً بأن الديانات التوحيدية “كانت قد ظهرت في فترة شهدت أزمات عميقة في التطور الاجتماعي، وفي الواقع، أحدثت ثورة في الطابع الأخلاقي والعقلي للجنس البشري” (صـ 56). بالمقارنة مع المفاهيم “الوثنية” و”الطوطمية” التي سبقت ذلك، أكّد أوجلان بأن التوحيد “مثّل شكلاً أكثر تقدماً من التفكير المنطقي” وربما جذاباً للجنس البشري بأسره ومرتبط “بمرحلة أكثر تعقيداً في تاريخ الفكر البشري” (صـ 62). علاوة على ذلك، في مناقشاته الدائرة حول تاريخ المسيحية والإسلام، ميّز أوجلان بوضوح ودقة بين الاندفاع الثوري الأصيل والاندفاع التحرري السلطوي، والذي اختير فيما بعد من قبل الحكام وحُوِلَ إلى أداة للنظام الهرمي والتحكم.
ومع ذلك، يبدو أن أوجلان قد أعاد النظر في رؤيته ضمن المجلد الأول من مانيفستو الحضارة الديمقراطية. حيث أنه يرثي زوال المنهج الأسطوري واستبداله بالدوغماتية الدينية التي تساعد في تبرير النظام الهرمي، الذي يربطه أوجلان الآن وبشكل مباشر بالتوحيد. إضافة إلى ذلك، يبدي أوجلان الآن تعاطفاً أكبر مع مرحلة ما قبل التوحيد ومع مفاهيم اللاهوت المتأصلة. كما أنه يذهب بعيداً إلى حد الإدعاء بالقول: ” المعتقدات التي لا تندرج في خانة التوحيد وسبقتها زمنياً ظهرت خلال عهد شَهِدَ المساواة القبلية” وبأن “تناقص عدد وترتيب الآلهة حسب تفوقها ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالبروتوكول الإداري” (صـ 168). تعميمٌ مشكوك فيه، في أحسن الأحوال، نظراً للوثنية التي وسمت وخدمت تشريع النظام الأبوي الإغريقي ودولة المدينة التي شرعت ملكية العبيد، ناهيك عن الإمبراطورية الرومانية.
في الواقع، كان التوحيد قوة للاستعباد والإعتاق في نفس الوقت. وينطبق الشيء نفسه على الوثنية. أنظروا إلى اليونان وروما في تحركاتهم نحو الديمقراطية والهيمنة. السرد الكبير للتوحيد مقابل ثنائيات الشرك ينهار في ظل الفحص التاريخي المكثف.
في بعض التقاليد التوحيدية المحددة اسمياً، تكشف نظرة عن كثب للطبقات المضطهدة، وعياً يُقَّدر تعدد أصوات الوجود الإلهي سواء أكان موجوداً في الكابالا، أو الصوفية، الكويكر أو الأنواع الصوفية الأخرى في اليهودية، الإسلام والمسيحية. السير نحو توحيد ذي طابع روحي أقل بدأته نخب مجتمعية منذ أخيناتون، جوشيا، وزرادشت الذين جعلوا من القبول الشعائري والفكري للتوحيد سلاحاً أساسياً ضد طبقات الفلاحين “المؤمنين بالخرافات” ممن لا يزالون متواصلين مع عدد لا يحصى من التعابير التي تدل على الواحد ولكن دون الحاجة إلى تقليص تعابير الآخرين.
ومع ذلك، وحتى في أقوى المجتمعات التوحيدية (المُعلنة ذاتياً)، وجد الفلاحون وقلة من المحظوظين من الطبقات الأخرى أنفسهم في مواجهة أرواح تتجاوز المحرمات الفقهية لعقيدة دينية توحيدية. الحرية (تتجاوز) أطر ومحددات المدبر التوحيدي (الإله التوحيدي) . نات تورنر، فريدريك دوغلاس، هاريت توبمان، ميلك، مالكولم إكس، سورجونر تروث، جون براون، وآخرين اختبروا حُضوراً روحياً حثّهم على التوجه نحو الحرية. على نحو معاكس، تعلمت مجموعة النمور السوداء بأن الناس لا يتخلون عن الله من أجل حرية الروح الماركسية التي تنكر خشيتهم من الحقيقة المطلقة.
هذه النقطة التي أشير إليها، والتي من شأنها أن تشكل ثنائية بين التوحيد مقابل الوثنية، حاسمة وتستحق اهتماماً أكبر. في الواقع، زميلي (دون) قضى الكثير من الوقت الصيف الماضي بحثاً عن أصول التوحيد وأهميتها للغرب. هذا البحث لم يكن مُعداً له سابقاً ولكنه ونتيجة لرغبتنا بإيجاد وجهات نظر مختلفة حيال أصول التوحيد ومكانه في التاريخ كان علينا السعي وراء ذلك على نحو أعمق. التوحيد هو الكأس المقدسة للإيديولوجية الدينية الغربية. عبَّر الباحثون عن اختلافات عميقة في الرأي ولكنهم وبحذر امتنعوا عن توجيه تعليقات نقدية تجاه أي من رفاقهم الباحثين.
الفرضية الأولى: التوحيد بدأ في عصر الفرعون إخناتون (1300 قبل الميلاد) عندما أدعى أن آتون (إله الشمس) هو الإله الوحيد الذي لا شريك له. وليرسخ ذلك قام إخناتون بتغيير اسمه إلى إمنحوتب. هذا الأمر دفعه إلى تدمير صور الآلهة الأخرى (من بينهم الإله أمون) وإغلاق معابدهم التي كانت قد أعلنت ولائها لآلهة آخرين. كان إخناتون عاشقاً أكثر من كونه مقاتلاً وعايشت مملكته هزيمة عسكرية. لا جدية ستواجهها إن كنت تريد عقد جلسات تقدير كبير لإلهك. وفاة إخناتون كانت غامضة والعديد من العلماء يعتقدون بأنه تعرض للاغتيال على يد الكهنة الذين أغلقت معابدهم على يد الفرعون. ويبدو أن عبادته لـ أتون لم تمكنه قط من تحقيق صدى شعبي واسع.
الفرضية الأولى (أ): مختصون آخرون في الشؤون المصرية يعتقدون بأن المصريين أظهروا إيماناً بالتوحيد عبر فهمهم اللاهوتي بأن الله الواحد القدير الغامض، المؤلف من عنصرين ذكر وأنثى بدء الخلق عبر عملية جدلية قادت إلى الآباء الثالوثين (البنية الثالوثية) والتي عُثِرَ عليها بأشكال مختلفة طوال التاريخ المصري. آخرون يسمون ذلك بالهينوثية (أي عبادة وإيمان إله واحد مع قبول وجود أو احتمال وجود إله آخر والذي يمكن أن يُعبد). الهينوثية تُعرف كإله متواجد في قِمة الخَلْق والذي يرتبط بشكل وثيق بالآلهة ذات الدرجات الأقل في السلسلة. الهينوثية ليست “الوثنية” التي ستعني عدة آلهة تعمل بشكل مستقل.
كما يمكنكم رؤية أن هذا العمل المتعلق بتعريفـ “التوحيد” بدقة يزداد تعقيداً بشكل مضطرد بالنسبة للباحثين. ومع ذلك، فإن تطور التوحيد “الحقيقي” يعتبر تطوراً هاماً في الوعي البشري. هذا التطور يُجرّد العالم من القداسة الدينية إلى حد يزيد من احتمالية الاختراع البشري. ولكن لهذا التوجه أهمية سياسية قصوى لأنه يُستخدم لتمييز المجتمعات “المطيعة للإله” من المجتمعات الأقل أي “الوثنية – الغير مطيعة”. تطور التوحيد هو نقطة فاصلة بين الحكمة والحماقة، بين الخير والشر، وبين التحضر وعدم التحضر (الهمجية).
الفرضية الثانية: التوحيد يرجع إلى تعليم زرادشت (500 – 600 قبل الميلاد). اعترف اليهود المنفيون في بابل بهذا الأمر وأدرجوه في فهمهم الديني في مرحلة ما بعد المنفى كشكل من أشكال المعرفة المفقودة والذي انتُشِلَ خلال فترة جوشيا مباشرة قبل نفي الدولة اليهودية. في هذه النسخة، مكتشفات جوشيا للنصوص التثنوية (المصدر التثنوي: أحد مصادر التوراة) أصرت على أن الله هو إله واحد ولأن اليهود قاموا بعبادة آلهة آخرين مزيفين فإنهم سوف يُعَاقبون عبر نفيهم من الوطن. الكَتبة اليهود (الدينيين) لم يعزو أبداً الإشادة لمعتقدات كليهما (المصريين أو الفرس)التوحيدية.
ومع ذلك، لا توجد أدلة تاريخية تظهر بأن شعب إسرائيل ويهوذا أبن يعقوب قد قاموا في أي وقت مضى بممارسة العبادة التوحيدية للإله (يهوه) بصفة الإله الوحيد. الدليل التاريخي يظهر بأن الفلاحين اليهود مارسوا العبادة لآلهة آخرين طوال فترة صعودهم وحكمهم في فلسطين.
ومع ذلك، أصبح هذا الاعتقاد بالتوحيد علامة ميزت الدين اليهودي عن دين الآخرين. ونُقِل هذا المعتقد إلى المسيحيين والمسلمين، الذين بدورهم عندما وصلوا للحكم، جعلوا من هذا المعتقد اختباراً للمصداقية (المستمر على المنشطات). أولئك الذين فشلوا في اجتياز الامتحان تعرضوا للاضطهاد. وبما أن التعبيرات الرئيسية الثلاث للتوحيد كان لها معاني مختلفة عن مضمونها الظاهري، فإنهم قاموا باضطهاد بعضهم البعض بسبب “معتقداتهم الغير تقليدية”.
على المستوى الاجتماعي واللاهوتي يعتبر هذا المعتقد ضعيف لأن اليهود، المسيحيين، والمسلمين لا يختلفون عن بعضهم البعض فقط في كيفية بناء الفكرة العامة وممارسة “التوحيد” بل هنالك تنافس في التعبيرات المتعلقة بالمعتقد التوحيدي داخل نطاق معتقداتهم الخاصة.
ولكن لنعود إلى طرح أوجلان. في المانيفستو، لا يزال أوجلان على استعداد لقبول بعض الجوانب الإيجابية للتوحيد. يؤكد أوجلان على سبيل المثال بأنه، مع العبرانيين، “معتقدهم التوحيدي ربما كان له علاقة كبيرة بمقاومتهم الصهر في الحضارة” (صـ 202). ومع ذلك، ينتقد أوجلان “الشكلانية المتطرفة للنزعة القبلية العبرانية” ويلقي اللوم على هذه الشكلانية بأنها أدت إلى ظهور “مفهوم عدم قابلية تغيير القانون” ومعه تحول المقدس إلى صورة ملك ذو سيادة، المُشرع، الذي أصدر “قوانين وأوامر أبدية” (صـ 270).
الإسلام والمسيحية
فيما يتعلق بالإسلام، يُصر أوجلان على أن مصطلح “الله” بنفسه واسع من الناحية النظرية بحيث يمكننا القول من منطلق (سوسيولوجي) بأنه يملك القدرة على دمج الإلهي في الطبيعة مع مثيله في المجتمع، ولكن لأن “الأتباع يريدون فهم القضايا الدينية على أنها – أوامر وقوانين أبدية – يصبح الأمر غامضاً بشكل كبير.” يجادل أوجلان بأنه وعلى الرغم من أن “فهم القانون على أنه – ثابت – ربما كان مفيداً في التغلب على الفوضى القبلية ولكنه في قرون لاحقة قاد إلى نزعة محافظة كبيرة في المجتمع الإسلامي” (صـ 270).
ويظهر أوجلان بعض الاحترام للنبي محمد، حيث يمدحه لأنه “نجا من التعاقد مع المرض المألوف ولم يصبح الإله” ولكنه يعود سريعاً ليضيف قائلاً “إحدى إخفاقاته تمثلت في عدم قدرته في التغلب على الصرامة اليهودية” (صـ 270). ولكنه لا يزال يشيد بـ محمد بسبب “تأكيده على الأخلاق”، الأمر الذي يشير “إلى أنه كان على دراية بالمشاكل المتأصلة في المجتمع المتحضر.”
في هذا السياق يشير أوجلان إلى محمد بوصفه “مُصلٍحاً كبيراً، وحتى ثورياً” وباستحسان يعطي أوجلان ملاحظات على “مبادئ محمد تجاه المصلحة” بالإضافة إلى إعطاء إشارات عن “نزعاته المعروفة المؤيدة لإبطال الاسترقاق” وموقفه الودود والمؤيد لـ “الحرية” ولكنه يشير أيضاً إلى أن “محمد وعلى الرغم من أنه لم يكن راغباً بأي حال من الأحوال أن تحصل المرأة على الحرية والمساواة إلا أنه كان يحتقر استرقاق النساء.” أخيراً، يثير أوجلان الانتباه (باستحسان) إلى أن محمد “اعتراف بالاختلافات في الطبقة والملكية في المجتمع” إلا أنه يبدو وكأنه يعاقبه لأنه “يشبه اشتراكياً ديمقراطياً” ويحاول “أن يمنع تشكيل الاحتكارات وهيمنتها الاجتماعية عبر استخدام الضرائب المفرطة” (صـ 271).
وفقاً لأوجلان فإن “السمة الأقوى للإسلام” هو التوازن الذي أقامه “بين الثقافة المادية والثقافة الإيديولوجية.” على عكس المسيحية، حيث يزعم أن “الجانب الثقافي” سائد. في هذا السياق، يقتبس أوجلان باستحسان إحدى أحاديث محمد ” اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا”، والتي يشير أوجلان بأنه (أي الحديث) يسلط الضوء على التوازن الإسلامي بين المخاوف الدنيوية والمخاوف في الحياة الأخرى بشكل جيد (صـ 271).
ويتابع أوجلان عن الموضوع عبر التعليق على العلاقة بين “صدام حسين والقرآن فقط قبل إعدامه” حيث يصفها بـ”المثيرة للاهتمام” وخَلصَ إلى إن “القرآن يوفر قوة استثنائية لبناء عقول أولئك الذين لم يبقى لديهم أمل.” يعود أوجلان إلى تناول موضوع الجنة ويصر مرة أخرى على أن الجنة هي إسقاط للأمل في ظروف ميؤوس منها، وآلية ملائمة في الاستجابة للقمع الموجود في كل مكان، العبودية، والاستعباد – “لا يمكن للمرء وبشكل صحيح فهم الرسائل التي نقلتها الكتب المقدسة دون فهم ظروف الاستعباد.” ومع ذلك يضيف أوجلان وبشكل عابر الظروف الاجتماعية الجائرة ليست الوحيدة التي جعلت طوباوية الجنة (ونقيضها – جهنم-) بالإضافة إلى العديد من الأمور الطوباوية الأخرى أمراً محتوماً بل لعبت “الطبيعة الميتافيزيقية للإنسان” دوراً رئيساً في هذا التحويل لأنه “بدون الكفاح للحصول على حياة أفضل لا يمكن أن تستمر الحياة – لا يمكن للإنسان أن يعيش” (صـ 275).
من المشكوك فيه إذا ما كان الكفاح من أجل الجنة والسمو يمكن أن يتقلص إلى “كفاح لتحقيق مستقبل أفضل” والسبب وراء ذلك، إذا ما تحدثنا بدقة، وفقاً لتقاليد أبراهام ليس فقط لأن الجنة تتواجد خارج وقت الفراغ المتجانس كما يُزعم ولكن ربما السبب الأكثر الأهمية هو أن الكفاح من أجل الجنة، على الأقل، يعكس غالباً رغبة وتوق عميقين لإعادة الاتحاد (الالتقاء) مع الماضي وبالأخص مع أولئك الذين يحبهم الإنسان وفقدهم. ناهيك عن الرغبة في الخلود لأنفسنا ولأحبائنا. رغبة يُساويها أوجلان بـ “الخوف من الموت” مُدعيا أنه مجرد بناء اجتماعي ويضيف أوجلان (بشكل عفوي) من منطلق هايدغري بأن “إدراك الموت ومعرفته هو أثمن جانب من حياة الإنسان” (صـ 275).
حسب أوجلان فإن “الإسلام والمسيحية كلاهما تعهدا، على نحو مثير للاهتمام، بإنهاء الاستعباد.” إلا أن أوجلان يواصل حديثه بالقول إنهم تملصوا من مسألة تقديم البديل عن العبودية والاضطهاد من خلال الوعد بحياة تشبه الجنة وذلك عبر الانسحاب من العالم العلماني إلى “مجتمعات الأديرة والمدارس” والتي أرادوا بها أن تكون أمثلة أو نماذج “لتشكيل المجتمع الجديد.” وتعرضت الإمكانات الثورية لهذه الأديان لمزيد من التقويض عبر استقطابهم واستخدامهم في إطار أداتي على يد “رؤساء الكنائس المسيحية إضافة إلى قادة الفتح الإسلامي”، الذين “شكلوا وبسهولة نظام مُلكية حديث ومُعَدل للرقيق.” الأهم من ذلك، يضيف أوجلان، هو أن تسمية ذلك “بالحضارات الإسلامية والمسيحية سيكون غير منصفاً” فعلى الرغم “من وجود بعض أنظمة الحكم، إمارات، دول مُدن، وإمبراطوريات عَدّلت مُلكية الرقيق باسم هذه الأديان” لأخذهم بعين الاعتبار كأنظمة مسيحية أو إسلامية إلا أن هكذا تصرف يُمثل “تحريفاً إيديولوجياً”، في الواقع، إن الهدف من هذه اليوتوبيا لم يكن خلق حضارات جديدة بل إنقاذ الحياة وتحويلها إلى شيء جميل” (صـ 276 ).
ويخلِصُ أوجلان إلى النتيجة الآتية: “على الرغم من أهدافهم” انتهى الأمر بطوباويات الإسلام والمسيحية “في خدمة ظهور الرأسمالية” حتى في حالة عدم وجود إمكانية “وصف الصراع بين عناصر الإسلام والمسيحية هذه والتي أصبحت الدولة نفسها، صراعاً بين الإسلامية والمسيحية.” في الحقيقة ترجع أصول مثل هذه الصراعات إلى ديناميكيات النظام الهرمي والحضارة والدين استخدمَ فقط كتمويه لهم” (صـ 279). مرة أخرى، الدين، كفكرة أساسية، هو كقناع ومموه للتخفي. هذه الطوباويات لم تخدم ظهور الرأسمالية فقط، بل هي “لا تملك المهارة لإعادة جذب العالم في الحياة الرأسمالية”، الأمر الذي يؤكد أوجلان بأنه لا يمكن الحصول عليه أو تحقيقه إلا عبر “قوة ومهارة سوسيولوجيا الحرية” – نوع جديد من السوسيولوجيا نستطيع فقط أن نبدأ بتخيله، حيث أنه وقع في شرك (كما نحن وقعنا) آفاق الحداثة الرأسمالية، والذي يعد أوجلان أن يساهم فيه ضمن عمله القادم (صـ 277). تفكيك أدائي للعقيدة الإسلامية التقليدية القائمة على أن محمد هو خاتم الأنبياء، إذا ما كان هنالك أحد ما في أي وقت مضى.
خفض رتبة لأنواع من الإسلام والمسيحية، على الأقل فيما يتعلق بالأثر المزعوم لهذه التقاليد على شؤون هذا العالم. ولكنها وفي نفس الوقت تعفي جزئيا الرسائل القيمة والأصلية لكل من الإسلام والمسيحية، حيثُ أن أوجلان وبمهارة يُميّزها عن التاريخ الطويل للممارسات الفاسدة، وهي بالفعل عمليات الاستيلاء على السلطة والتي نٌفذت من قبل الحكام ورجال الدين، الذين سعوا إلى تبرير النظام الهرمي، الاستغلال والظلم غبر ظهور الآلهة المقنعة وتشويه معنى الإسلام والمسيحية.
وعادة ما يعتبر الإسلام أحد المصادر الرئيسية للثقافة الشرق أوسطية تماماً كما ينطبق الأمر على المسيحية عند تناول الثقافة الغربية. يعارض أوجلان تعريفاً كهذا ويصر بدلاً من ذلك على أن “المصدر الحقيقي لكلتا الثقافتين هي الهياكل الهرمية والمنادية بالدولانية والتي يبلغ عمرها خمسة ألاف عام” (صـ 88).
وفي الوقت الذي يظهر أوجلان احتراماً كبيراً للرسائل الأصلية والأساسية والثورية للإسلام والمسيحية المبكرتين، يظهر أوجلان احتراماً أقل بكثير (لدرجة لا يمكن المقارنة بينهما) للممارسات المعاصرة الفاسدة لأولئك الذين يتكلمون باسم إلههم بلا طائل. موقفه قائم على الازدراء عندما يتعلق الأمر أو الحديث بـ الإسلام “السياسي” أو “الراديكالي”. ويصرف أوجلان النظر عن هذه الحركات بوصفها مزيفة ويؤكد بأنه وعلى الرغم من انتقاد هذه الحركات “للحداثة الأوروبية” وحتى “معارضتها بعنف” وعلى الرغم من أنهم ربما “يرتدون الملابس ويطيلون اللحى وفقاً للتقاليد”، في الحقيقة “هم في أرواحهم وأجسادهم مثقلين بالبقايا الأكثر تخلفاً للحداثة” (صـ 89). باختصار يعتبر أوجلان ما يسمى بـ “الإسلام السياسي” أو “الراديكالي” مقاومة زائفة، حيث أنها حركات تُديم وتجسد القيم نفسها التي تدّعي مقاومتها. هي في نظره شكل من أشكال القوموية (صـ 87).
مناهضة الإستشراق
يصر أوجلان وبتعنت على أن نهجه “مناهض للإستشراق”. ولكنه تمكن من التقدم في دراسة نقد الإستشراق بشكل أعمق وربما على وجه الخصوصية عمل إدوارد سعيد، الذي ينتقده أوجلان على نحو غريب على أنه متحالف مع الإسلام الراديكالي، حتى أن أوجلان يدّعي بأن، سعيد كما حزب الله، ربما يبدو ظاهرياً أنه “مناهض للإستشراق وعدو للحداثة الغربية” ولكنه في الحقيقة محصور داخل حدود هذه الحداثة ” (صـ 89). أقل ما يمكن قوله إن تفسير أوجلان لقوة رسالة إدوارد سعيد شحيح.
يوضح أوجلان وبالتفصيل ما يمكن تسميته بـ سردية “الهلال الخصيب المركزية” الكبرى حول قوس التاريخ البشري، بما فيها صعود ومسار “الحضارة.” إنها سردية كبرى تعتمد بالمحصلة وبشكل كبير على التأريخ الأوروبي المركزي، وهو التأريخ الذي (في بعض الأحيان) يعيد حتى إنتاج استعارات محددة بل ومشكوك في أمرها حول الآريين مقابل السامية. في الواقع، بشكل مشابه للكثير من التأريخ الأوروبي المركزي الذي يعتمد عليه أوجلان في سرده، يظهر أسلوب أوجلان في التعامل مع الأثنية غالباً نزعة نحو المفارقة التاريخية، الماهيوية (الجوهرية)، والتشيؤ، وغالباً ما يتجاهل أوجلان المساحات الحدية بالإضافة إلى أنه غالباً ما يقلل من قيمة انتشار التهجين.
وتعيد سردية اوجلان أيضاً تقديم استثناءات مميزة. الأكثر تعبيراً ووضوحاً بالنسبة لأوجلان هي بأن قصة تاريخ البشرية تبدأ بخروج من أفريقياً. في سرده باتت مِصر مُشتقة ونفى أفريقيتها تماماً. هذا الأمر إشكالي بشكل كبير نظراً لطموح أوجلان بتقديم سردية كبرى قادرة على تعزيز ودعم المقاومة ضد الحداثة الرأسمالية لصالح بديلها المتمثل بـ “الحداثة الديمقراطية.” وكما أكد سيدريك روبنسون بحق فإن “محو الماضي الأفريقي من الوعي الأوروبي كان ذروة عملية (في جذور الهوية التاريخية الأوروبية) طالت لمدة ألف سنة” (الماركسية السوداء صـ 82).
للأسف، أوجلان ليس معصوماً عن الخطأ ومع ذلك سرده مفعم بالقوة. الهدوء والرضا من ظلم الرأسمالية النيوليبرالية ناهيك عن دعم العنف المتصاعد وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الحرب الأوريلية الجارية على “الإرهاب” – هذه المواقف المتمثلة بالسكون، الرضا، والدعم يتم تعزيزها وتطول أكثر من خلال نشر الخرافات المهيمنة. المقاومة الفعالة للتخلص من هذه الخرافات تتطلب أكثر من مجرد تفكيكها. ويتعين أيضاً تشجيع الاعتقاد والرغبة بوجوب وجود بدائل للنظام الحالي.
في هذا السياق، لا ينبغي الاستهانة برؤية أوجلان التاريخية الكاسحة للنضال الجدلي بين الهيمنة والمقاومة باعتبارها محرك التاريخ. في الواقع، فإن جهوده الجدلية المناصرة للطبيعة (المستمدة من أفكار بوكشين) الرامية إلى إزالة التسلسلات الهرمية وتحديد أصولها وحتى كشف بدائل أكثر مساواة وتحرراً وهو الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير، لا سيما إذا نظرنا إلى ظروف الإكراه التي نشأت فيها.
ولكن المعرفة دوماً اجتماعية ومانيفستو أوجلان بالطبع ليس الكلمة الأولى ولن تكون الأخيرة. بالتأكيد يشير أوجلان على الأقل إلى بعض الاتجاهات الصحيحة. سواء إلى الأمام أو الوراء (إن لم يكن للأعلى. رغم صدور الحكم بالإجماع الآن بأن نيتشه تُوفي، لم تصدر هيئة المحلفين بعد قراراها بخصوص إله إبراهيم ووعد العدالة الإلهية).