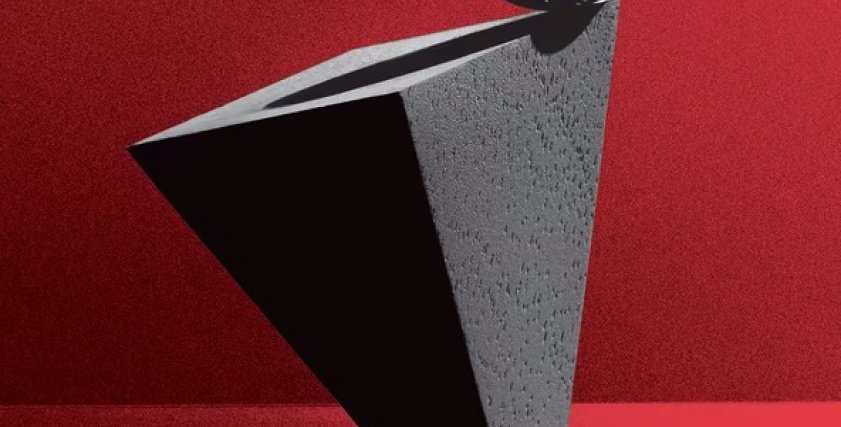آن أبلباوم
في شباط / فبراير عام 1994، ألقى الرئيس الإستوني لينارت ميري خطاباً مؤثّراً في قاعة الاحتفالات الكبرى (قاعة الفرسان) بمدينة هامبورغ الألمانية، أشاد من خلاله بقيم العالم الديمقراطي التي كانت إستونيا تتطلع للانضمام إليه. وأمام سكان هامبورغ قال ميري :« إن كل من حرية الأشخاص والاقتصاد والتجارة، فضلاً عن حرية الفكر والثقافة والعلم جميعها تصب في وعاء واحد، وهي مبادئ أساسية لاستمرارية الديمقراطية. لقد تمكّنت إستونيا من نيل استقلالها عن الاتحاد السوفيتي منذ نحو 3 سنوات، وكانت سباقة لتبني هذه القيم الديمقراطية”، حيث أضاف ميري: «لم يفقد الشعب الإستوني مُطلقاً إيمانه بهذه الحرية خلال عقود من عمليات القمع والاضطهاد الشموليّة».
من جهة ثانية، كان خطاب ميري يوجّه رسالة تحذيرية للغرب، ألا وهي ” إن الحرية في إستونيا وأوروبا باتت على المحك”. على ما يبدو أن الرئيس الروسي بوريس يلتسين والدوائر المحيطة به بدؤوا بتبني لغة الإمبريالية، وباتوا يستذكرون أمجاد الإمبراطورية السوفيتية السابقة وأن روسيا سيكون لها اليد الطولى بين القوى العظمى كانت موسكو قد أصبحت في عام 1994 أكثر عدوانية ومُتطلعة إلى ماضيها الاستعماري، وبدأت تطور مفهوماً غير ليبرالي للعالم، وكانت تعمل جاهدة لتنفيذه. في مقابل ذلك دعا ميري العالم الديمقراطي إلى مواجهة الطموحات الروسية والذي رأى بأنه يتوجب على الغرب أن يرسم الخطوط الحمراء لروسيا بشأن أي توسع استعماري مستقبلي.
ورداً على ما ورد في خطاب ميري وقف بوتين، الذي كان يشغل نائب رئيس بلدية سان بطرسبورغ، مُغتاظاً وغادر القاعة.
لم يكن خوف ميري يقتصر فقط على دولة إستونيا، بل كان نقطة مشتركة تربط جميع دول وسط وشرق أوروبا، وقد دفعت هذه المخاوف الحكومات في إستونيا وبولندا وأماكن أخرى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونجحوا في ذلك لأنه في تلك الفترة لم تكن واشنطن أو لندن أو برلين تعتبر الدول التي انضمّت حديثاً للحلف ذات أهميّة. ويعود سبب عدم الاهتمام هذا إلى اعتبار الغرب أن حقبة الاتحاد السوفيتي قد ولّت، وأن بوتين شخص ضعيف، بالإضافة إلى رؤيتهم أنه لا داعي لنشر قوات في إستونيا لحمايتها لعدم وجود تهديدات، وبناءً على ذلك لم يُسلّح كل من الرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش الابن أعضاء حلف شمال الأطلسي الجُدد. وفي أعقاب الغزو الروسي الأول لأوكرانيا، سارعت إدارة أوباما عام 2014 إلى نشر قوات أمريكية محدودة بالمنطقة في محاولة لطمأنة حلفائها.
كان الغرب يعيش حالة من الوفاق والسلام. وعلى مدى 30 عاماً ازداد عدد شركات النفط والغاز الغربية في روسيا التي قامت بعقد شراكة مع الأوليغارشية الروسية (رؤوس الأموال) الذين سرقوا الأصول التي يسيطرون عليها بشكل علني. كذلك جنت المؤسسات المالية الغربية أموالاً ضخمة من خلال عملها في روسيا، حيث أقامت أنظمة بغية تسهيل عمل الحكّام المستبدين الفاسدين في روسيا لنقل أموالهم التي اختلسوها ووضعها في البنوك والمؤسسات الغربية، دون الكشف عن هوية أصحابها. لقد كنا نغضّ الطرف عن تمويل وزيادة خزينة المستبدين ومن يدور في فلكهم، من باب أن ذلك لا يشكّل تهديداً لنا، وأن التجارة معهم ستقوّي شركائنا، فضلاً عن أن الثروة ستجلب الليبرالية وأن الرأسماليّة ستجلب الديمقراطية، وبالمحصلة سينتج عن هذه الديمقراطية السلام.
لقد شهد الغرب أحداثاً مماثلة لذلك، فبعد كارثة الحرب العالمية الثانية التي امتدّت من عام 1939 إلى 1945 تخلّت الدول الأوروبية برمتها عن الحروب الاستعمارية التي أدت إلى تدمير تلك الدول. وعوضاً عن ذلك أسّست القارة، التي كانت بؤرة لأسوأ حربين شهدهما العالم، “الاتحاد الأوّروبي”، وهو منظمة هدفها إيجاد حلول للنزاعات عن طريق المفاوضات وتعزيز التعاون والتجارة. وبسبب التحول الأوروبي، خاصة التبدّل الاستثنائي لألمانيا من الديكتاتورية النازيّة إلى مركز ثقل القارة وازدهارها، ظنّ الأوروبيون والأميركيون أنّهم تمكّنوا من وضع مجموعة قواعد ساهمت في الحفاظ على السلام ليس فقط في القارتين الأوروبية والأميركية بل للعالم أجمع.
اعتمد هذا النظام العالمي الليبرالي على شعار “لن نسمح بتكرار ما حدث سابقاً”، ولن نسمح بحدوث إبادة جماعية مرة ثانية أو محو الدول القوية لنظيراتها الضعيفة من على الخارطة، كما لن نسمح بعودة الديكتاتوريين ممن تلطّخت أيديهم بالدماء. يعلم الأوروبيون أكثر من غيرهم حجم المأساة التي عانوها في السابق لذلك سيبذلون جهوداً جبّارة لكي لا ينزلقوا في أُتون الحرب مرة ثانية.
في الوقت الذي كُنا نعيش فيه بسعادة تحت وهم عبارة “لقد ولّت الحروب ولن تحدث مرة ثانية” كان قادة روسيا، الذين يمتلكون أكبر مخزون نووي في العالم، يُعيدون تأسيس الجيش ويخوضون الحرب الإعلامية المضللة لتسهيل عمليات الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أن روسيا أقرب إلى ما يكون إلى “دولة مافيا” يُسيطر عليها ثُلّة من الرجال، وهي على النقيض من الرأسماليّة الغربية.
منذ فترة طويلة جداً لم يعي أو يستوعب الأوصياء على النظام العالمي الليبرالي هذه التغييرات، فلم يكترثوا بما حلّ بالشيشان بعد أن أقدمت روسيا على تهدئتهم في أعقاب قتلها لعشرات الآلاف من الشيشانيين، الأمر ذاته بالنسبة لسوريا حيث لعب القادة الغربيون دور المتفرّج عندما كانت روسيا تقصف المدارس والمستشفيات، معللين عدم تدخّلهم بأن سوريا لا تخصّهم، إلا أنّه بعد أن غزت روسيا أوكرانيا للمرة الأولى بدأت تنتابهم مشاعر القلق، خاصة بعد ضمّ بوتين لشبه جزيرة القرم. وعند غزو روسيا لأوكرانيا للمرة الثانية واحتلالها أجزاءً من إقليم دونباس كانوا واثقين بأنه سيتوقف عند ذلك ولن يتوسّع مجدداً.
وعلى الرغم من زيادة ثراء الروس بسبب نظام الفساد الذي سهّلناه لهم وشرائهم لأصوات ساسة الغرب وتمويلهم للحركات اليمينية المتطرفة وإدارتهم لحملات تضليل خلال الانتخابات الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا، لايزال قادة أميركا وأوروبا متمسّكين بآرائهم ولا يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، حيث اقتصرت ردودهم على ذلك ببضع منشورات على الفيسبوك يقولون فيها: ما الخطر في ذلك؟ لقد كنا نرفض فكرة أننا في حالة حرب مع روسيا، بل كنا نعتقد أننا أحرار نعيش في عالم آمن تحكمه المعاهدات وضمانات عدم التعدّي على حدود الدول الأخرى، بالإضافة إلى قيم و قواعد النظام الليبرالي.
مع الغزو الروسي الثالث والوحشي لأوكرانيا اتضح أن تلك المعتقدات كانت عبثيّة، فقد نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحةً وجود دولة أوكرانيا، مرجعاً ذلك إلى “طبيعة العلاقة التي تربط الروس والأوكران وأنّهم يمثّلون شعباً واحداً”. وخلال هذا الغزو عمد جيشه إلى قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس، حيث تهدف سياسة بوتين إلى الدفع بمزيد من اللاجئين بغية زعزعة أمن واستقرار أوروبا الغربية.
وفي ظل المشاهد القاسية للإبادة الجماعية التي يتعّرض لها الأوكران على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، تبيّن زيف شعار “لقد ولّت الحروب ولن تشتعل مرة ثانية”. في المقابل، دأبت الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم إلى مراقبة ما يحصل في أوكرانيا، فهي أيضاً إلى جانب روسيا لها أطماع في جيرانها وتسعى إلى محق شعوب عن بكرة أبيها، ولا تترد لتحقيق ذلك في استخدام الإبادة الجماعية والعنف المفرط.
بإمكان كوريا الشمالية غزو جارتها كوريا الجنوبية في أي وقت تشاء، فضلاً عن امتلاكها أسلحة نووية قادرة أن تضرب بها اليابان. أما الصين فتسعى للقضاء على الأقلية العرقية المسلمة “الإيغور” داخل البلاد، بالإضافة إلى نواياها الاستعمارية تجاه تايوان.
لا نستطيع العودة للماضي وبالتحديد لعام 1994 لنأخذ بنصيحة وتحذيرات لينارت ميري، لكن نستطيع مواجهة المستقبل وتحديد التحديات والاستعداد لمواجهتها.
لن يكون هناك نظام عالمي ليبرالي طبيعي أو قواعد تحكم هذا العالم بدون وجود قوى بمقدورها فرض ذلك. وفي حال لم تتحد الديمقراطيات مع بعضها البعض فإن النظام الاستبدادي سيدمّرها. أنني استخدم عمداً كلمة “القِوى” بالجمع وليست قوة واحدة لأسباب مقنعة، يفضّل كثير من الساسة الاميركيين تركيز جهودهم على المنافسة طويلة الأمد مع الصين، لكن طالما أن بوتين رئيساً لروسيا فإن الأخيرة ستبقى في حالة حرب معنا. علاوة على ذلك، فإن دول مثل بيلاروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران ونيكاراغوا والمجر بالإضافة إلى دول أخرى، قد لا نرغب في التنافس معها ولكنهم يضنون العداء لنا. فهم يرون أن منطق الديمقراطية ومكافحة الفساد ونشر قيم العدالة تشكّل خطورة على أنظمتهم الاستبدادية ويعلمون أن هذا المنطق نابع من عالمنا الديمقراطي.
إن هذه المعركة ليست حبراً على ورق بل إنّها تتطلب جيوشاً واستراتيجيات وأسلحة وخططاً طويلة الأمد، وتعاوناً وثيقاً بين الحلفاء ليس فقط في أوروبا ولكن في المحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. على حلف شمال الأطلسي (الناتو) تطوير قدراته واستراتيجيته كما كان يفعل سابقاً إبّان حقبة الحرب الباردة مستنداً في ذلك إلى جاهزيته للرد على أي غزو قد يحدث بين ليلة وضحاها. وما قرار ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 100 مليار يورو إلا بداية في المسار الصحيح، كذلك إعلان الدنمارك أنها ستعزّز من إنفاقها الدفاعي. لكن التنسيق العسكري والاستخباراتي عالي المستوي قد يتطلب مؤسسات جديدة، ربما فيلقاً أوروبياً تطوعياً مرتبطاً بالاتحاد الأوروبي أو تحالف لدول البلطيق يضم كل من السويد وفنلندا، ورؤية مختلفة حول أين و كيف سنستثمر باستراتيجيّة الدفاع في أوروبا والمحيط الهادئ.
إذا لم تتوفر لدينا الوسائل التي تستطيع إيصال رسائلنا إلى العالم الاستبدادي، فلن تلق كلماتنا أذاناً صاغية في أوساطهم. كما قمنا بتوحيد وزارة الأمن الداخلي من عدة وكالات مختلفة في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، نحن بحاجة اليوم أيضاً إلى توحيد المواقف الأمريكية المتباينة التي تفكر في التواصل ليس للقيام بالبروباغندا الإعلامية، ولكن للوصول إلى مزيد من الأشخاص حول العالم بأفضل المعلومات، ولمنع الأنظمة الاستبدادية من تشويه تلك المعرفة. لماذا لم نؤسس محطة تلفزيونية ناطقة باللغة الروسية لمنافسة الماكينة الإعلامية لبوتين؟ لماذا لا يمكننا إنتاج مزيد من البرامج بلغة الماندرين (الصين) أو الأويغور؟ لا تقتصر حاجة كل من إذاعة أوروبا الحرة راديو ليبرتي وراديو آسيا الحرة راديو مارتي في كوبا إلى المال من أجل الاستمرار في تقديم البرامج الهادفة، بل هي بحاجة إلى استثمار كبير في البحوث والدراسات، فنحن لا نعلم الكثير عن طبيعة الشعب الروسي أو ما يقرؤونه وما قد يشد اهتمامهم.
كذلك تمويل قطاعي التعليم والثقافة بحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المتعلقة بهما. ألا يجب أن تكون هناك جامعة تُدرِّس اللغة الروسية في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) أو وارسو (عاصمة بولندا)، لاستضافة جميع المثقفين والمفكرين الروس الذين غادروا موسكو؟ ألسنا بحاجة إلى إنفاق المزيد على تعليم اللغات العربية والهندية والفارسية؟ يتوجب علينا إعادة صياغة البرامج لتواكب التطورات والعصر، فعلى الرغم من أن العالم أكثر قابلية للمعرفة من أي وقت مضى، إلا أن الأنظمة الاستبدادية تسعى إلى إخفاء تلك المعرفة عن مواطنيها.
إن التجارة مع المستبدّين تقوي دعائم الاستبداد على حساب الديمقراطية. لقد حقق الكونغرس بعض التقدّم في الأشهر الأخيرة في الحرب ضد نظام الكليبتوقراطية العالمي، وكانت إدارة بايدن على جادة الصواب عندما وضعت مكافحة الفساد في سلم أولويات استراتيجيتها السياسية. بإمكاننا الغوص في ذلك عميقاً كونه لا يوجد سبب مقنع لإبقاء الشركات أو الممتلكات أو الودائع سرية ولا يتم الكشف عن أصحابها. يتوجب على الولايات المتحدة وكل دولة ديمقراطية أن تعلن أمام الملأ هوية أصحاب هذه الممتلكات بشفافية، وأن تكون الملاذات الضريبية غير قانونية، فكل شخص يقوم بإخفاء ما يملك سواء أكان عملاً أو سكناً أو دخلاً يعتبر مداناً بالاحتيال والتهرّب الضريبي.
نحن بحاجة إلى تحوّل جذري وعميق في استهلاكنا للطاقة وليس فقط بسبب تغير المناخ. لقد أسهمت مليارات الدولارات التي أرسلناها إلى روسيا وإيران وفنزويلا والسعودية إلى تقوية بعض من أسوأ الديكتاتوريين وأكثرهم فساداً في العالم، لذلك يتوجب التحوّل من الاعتماد على النفط والغاز إلى مصادر طاقة بديلة بأقصى سرعة ممكنة وأكثر جدّية، فكل دولار يُنفق في شراء النفط الروسي يسهم في تمويل آلة الحرب الروسية التي تقصف المدنيين الأوكران.
ينبغي أخذ مفهوم الديمقراطية على محمل الجد ونشره ومناقشته وتطويره والدفاع عنه. قد لا يوجد نظام عالمي ليبرالي خال من العيوب، إلا أن هناك مجتمعات ليبرالية ودول منفتحة ومتحررة تقدّم للناس فرصة أفضل لعيش حياة ذات معنى، بعكس الأنظمة الديكتاتورية المتقوقعة على نفسها.
إن شعوب النظام الديمقراطي تسوده عيوب كبيرة وانقسامات عميقة ونكسات تاريخية يندى لها الجبين، حيث يعتبر ذلك سبباً إضافياً للدفاع عنها وحمايتها وقلّة منها كانت موجودة عبر تاريخ البشرية. بإمكان استهداف هذه الشعوب والنظام الديمقراطي من الخارج أو من الداخل عبر زرع الانقسامات والتغيير الديموغرافي.
لقد قدمت الأزمة الأوكرانية لنا الدروس والعبر، فمنذ عدة عقود وإلى يومنا هذا لازلنا نخوض حرباً ثقافية بين القيم الليبرالية من جهة والنزعة القومية من جهة أخرى. يعلمنا الأوكران أنه بإمكاننا التوفيق بين الاثنين، فمنذ لحظة بدء الغزو الروسي لبلادهم تغلبوا على انقساماتهم السياسية الكثيرة والتي لا تقل مرارة عن انقساماتنا، وحملوا السلاح للدفاع عن سيادة وديمقراطية أوكرانيا. لقد برهنوا أنه من الممكن أن تكون قومياً ومؤمناً بمجتمع متحرر وأن الديمقراطية بإمكانها الصمود وهزيمة أعتى خصومها.
وفي ظل غياب نظام عالمي ليبرالي والقيم والقواعد التي تسود هذا العالم يتوجب علينا (الديمقراطيين) أن ندافع بشراسة من أجل مبادئ وآمال الليبرالية إذا أردنا استمرارية وجود مجتمعاتنا المتحررة.
المصدر: مجلة ذا اتلانتك
ترجمة: المركز الكردي للدراسات