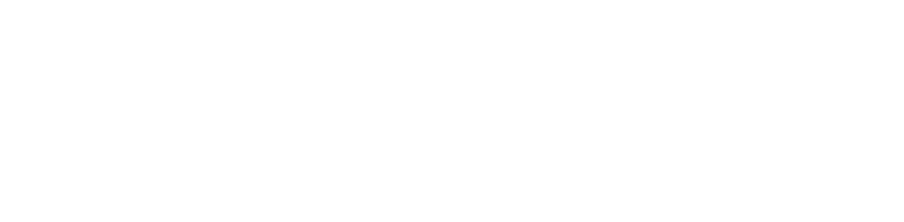عقيل سعيد محفوض
من الصعب تحديد ما يمثل «أصلاً» أو «فرعاً» في أساس ومعنى المجتمعات (أو ما يُعدُّ مجتمعات) في الإقليم، وما «العوامل الأكثر تأثيراً» فيها أو «العوامل المُرجِّحَة» لتشكلها، في لحظة ما أو حيز جغرافي وبشري واجتماعي واقتصادي وسياسي ما. وهذا يفسر –مع عوامل أخرى– صعوبة التنبؤ بالشكل الذي تتخذه، أو أنماط الاستجابة لدى المجتمعات في الإقليم، وخاصة في أوقات الأزمة والصراع.
يتسم التشكل الاجتماعي ومعنى مجتمع بـ«الخلاسية»، في مستويين رئيسين: أولاً، صعوبة القبض على المعنى. وثانياً، صعوبة الإمساك بديناميات التشكل والتحول. وقد تظهر مدارك واتجاهات هوية لم يكن مُوعى بها أو لم تكن متوقعة. وثمة على الدوام ما هو مفاجئ في الهوية، من حيث «تمثلاتها» الاجتماعية والسياسية والثقافية والقيمية، وخاصة في لحظات الحروب الداخلية أو الأهلية، لتبرز تجاذبات وتداخلات وتخارجات كثيرة، بين: جماعة وطنية «متخيلة» أو «مفترضة» أو «مدعاة» أكثر منها متجسدة في الواقع الاجتماعي والسياسي، وجماعات أو هويات ما دون وطنية، ومنها ما هو «لا وطني» و«لا دولتي»، منقسمة بقوة على بعضها. وثمة إلى ذلك تأثيرات وتدفقات ذات طابع عولمي.
أولاً – في معنى الهوية
الهُوية، هي ما يحدد معنى الفاعل ونظرته لـ«أناه» ولـ«الآخر»، وتفاعلاته وسلوكه، وموقعه ودوره في حيز زمانيّ ومكانيّ ما، سواء أكان فرداً أو جماعة. وللهوية مصادرها المادية والرمزية، التي تتسم عادة بـ«الثبات النسبي» أو تتشكل وفق ديناميات ثبات وتغيير. وهي في الوقت نفسه «حصيلة» تفاعلات وتداخلات وتخارجات كثيرة. وعلى الرغم مما يحيل إليه تعبير «الهوية» من تحديد و«ثبات نسبي» لمعنى «الأنا» وتمييزها عن «الآخر»، إلا أن الهوية هي في نهاية المطاف نتيجة عملية وسيرورة مستمرة.
والهوية مسألة تقديرية ومخيالية بالأساس، فإذا أراد الفاعل (الفرد، الجماعة) أن يضع نفسه في إطار فكرة أو قيمة أو انتماء ما، أو قرر أن «يتمثلها»، ويتحرك في أفقها، فهذا قد يتفوق على المحددات والاشتراطات المادية والرمزية الأخرى. ولو أن الأمور لا تتوقف على ذلك. إذ إنها ليست محض اختيار ذاتي، ولا محض نتاج عوامل موضوعية. وتحيل ديناميات الهوية إلى عدد غير محدد من الفواعل والمحددات، وهي مفتوحة على عدد غير محدد أيضاً من التأثيرات والمسارات والتمثلات والرهانات. والواقع أنها مُدخَل ومُخرَج، بانية ومبنية في الوقت نفسه!
ويمكن الحديث عن «أركيولوجيا الهوية» أو «طبقات الهوية»، لا ينسخ بعضها بعضاً أو لا يقطع بعضها مع بعض. ثمة ما يظهر في لحظة ما، وثمة ما يتنحى نسبياً، الأمر الذي يجعل الهوية ظاهرة مركبة من «رواسب» أو «تشكلات» متداخلة ومتراكمة، وقد يُعاد ترتيبها بتأثير عوامل مختلفة. ويمكن الحديث أيضاً عن «هويات متوازية»، على مبدأ «الأكوان المتوازية» في الفيزياء. وهذا على مستوى الأفراد والجماعات، لدرجة يصعب معها تحديد «المحكم والمتشابه» فيها.
ثانياً – سياسات الهوية
كثيراً ما يكون موضوع الهوية «أمراً سياسياً». وتهتم فواعل السياسة بـ«هندسة» أو حتى مجرد ادعاء وجود هوية وطنية. وتهتم السياسات بتعميم أفكارها ومنظورها لـ«مجتمع» و«دولة» من خلال مؤسسات التربية والتعليم والإعلام والثقافة، وبالطبع ثمة مؤسسات الإكراه المختلفة. ولكن الأمور لا تقف هنا، ذلك أن فواعل السياسة ونظم الحكم يمكن أن تُخفق في صناعة أو هندسة «هوية وطنية»، لاعتبارات كثيرة، منها: تأسيس سياسات الهوية على مقولات إيديولوجية ومعارف غير مطابقة للواقع الاجتماعي، والأدلجة المفارقة للواقع، والفساد أو الخلل في تطبيق السياسات، وفرض القيم على المجتمع (أو ما يُعد مجتمعاً).
وثمة بالمقابل: التحولات في أنماط القيم لدى الأفراد والجماعات، خلافاً لما يريده أهل الحكم، بتأثير التفاعلات والتدفقات مع الفواعل والعوالم الأخرى. وتأثير التدخلات والإكراهات من الخارج، وهي كبيرة ومعقدة لا شك.
ثالثاً – البنى أم التفاعلات؟
إن «الأصل» في «التشكل الاجتماعي» و«الجماعة الوطنية»، ليس البنى والأوزان العددية والكتل النسبية والتشكلات الاجتماعية: أكثريات وأقليات بالمعنى الجماعاتي الوشائجي والعضوي في بلد ما، وإنما «ديناميات التفاعل» فيما بينها. وليس التكوينات والهويات والأفكار والعقائد واللغات، إلخ، بما هي تكوينات في المجتمع فحسب، وإنما بالأولى ديناميات تفاعل واتصال اجتماعي متعدد الأنماط والأشكال، مفتوح في أفق وعي بأن كل ما في إطار الدولة وفي أفقها، هو «تكوين اجتماعي» و«روح اجتماع» و«أساس دولة».
إن «ديناميات التفاعل» لا تقتصر على البنى والتكوينات والشرائح الاجتماعية فيما بينها فحسب، وقدرة الأفراد على تشكيل شبكات ومؤسسات خارج الجماعة والملة وفي أفق المجتمع؛ بل تشمل أنماط التفاعل فيما بينها وبين السلطة والدولة أيضاً. وينسحب ذلك على ديناميات التفاعل العابرة للحدود أيضاً وأيضاً.
رابعاً – الأصل أم الدور؟
لا يتعلق الأمر بـ«أصل» البنى والتكوينات الاجتماعية: العرقية واللغوية والدينية والثقافية، إلخ، من أين أتت؟ وهل وجودها قديم أم حديث؟ وهل هي «أصلية» أم «مهاجرة» و«وافدة»؟ وإنما بـ«دورها»، وموقعها واتجاهها، ورهاناتها أو ما تنشده أو تتطلع إليه. وهل ثمة اتجاهات هووية «متمركزة حول الذات»، وعلى حساب خط المعنى الرئيس للهوية الوطنية أو بالضد منه؟
ينطوي ذلك على مفارقة حادة نسبياً، ذلك أن «التفضيل» أو «المزاودة» على أساس من هو «الأصل» ومن هو «الوافد»؟ يتناقض مع «أولوية الأمة» بالمعنى الديني على المجال والجغرافيا، كما هو الحال في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط مثلاً.
وفي الوقت الذي يُقال للكرد مثلاً إنهم «وافدون» إلى بعض مناطق الإقليم، مثل الجزيرة السورية، فهذا «تبرير» لـ«إقصائهم»، بما هم كرد، من ديناميات السياسة في سوريا، أو لإعطائهم «وضعية أقل» حضوراً وتأثيراً، بما هم كرد أيضاً، في ديناميات المعنى والقوة في البلاد والإقليم. وبالمقابل، ثمة عمل حثيث لـ«تمكين» جماعات وأفراد «وافدين» إلى البلاد من مناطق بعيدة وقريبة، من الانخراط في تلك الديناميات والسياسات، مع إعطائهم أفضليات ومزايا نسبية استثنائية.خامساً – الماضي أم المستقبل؟
وبالطبع، فإن المهم ليس ما كان في «الماضي» وإنما الحاضر الذي يؤسس للمستقبل. لا يمكن «الفصل» أو «القطع» مع ما كان، وإنما «تدبيره» و«تجاوزه»، ليس بالكبت والقمع والتسلط، ولا بسياسات محو الذاكرة والذكر والأثر، فهذا يخلق مظلوميات بالغة الخطورة، وبيئة صراع داخلية وأهلية، قد تنفتح على «ديناميات تغلغل» خارجية، ونزعات انقسامية. وإنما تدبير الذاكرة والتاريخ والمدارك حيال «الأنا» و«الآخر»، بالنسبة لكل جماعة أو تكوين، بحيث تكون القَوَامة لـ«العيش المشترك»، على ما في التعبير من التباس، في أفق مجتمع ودولة تعدديين بالمعنى الحداثي والديمقراطي للكلمة.
سادساً – التقليدي أم الحداثي؟
لم تتمكن بلدان الإقليم من التَشَكُّل مجتمعات بالمعنى الحداثي، بل تشكلت بنوع من الهجنة أو التداخل بين التقليدي والحداثي. وبرزت تيارات ومقولات وبُنى ومؤسسات وأحزاب حداثية الطابع وعابرة للجماعات والتكوينات، إلا أن البنى العميقة للتفاعلات وديناميات الاجتماع والسياسة لم تكن حداثية بالتمام، بل كانت هجينة أيضاً، إنما بغلبة أو قَوَامة نسبية للتقليدي وما قبل الوطني (الدين والطائفة والقبيلة والعائلة، إلخ) على المجتمع والدولة (أو ما يُعد مجتمعات ودولاً) في الإقليم.
لم يمنع ذلك فواعل السياسة والحكم من حديث متواصل عن «جماعة وطنية» أو «مجتمع» و«دولة»، إنما من دون الإيفاء بمقتضيات ذلك ومتطلباته الفعلية. لم تتشكّل في الإقليم «مجتمعات» و«هويات وطنية» بالمعنى المعروف للكلمة، ولم تتأسس السياسة على المواطنة، لا تزال الأمور بعيدة جداً عن ذلك.
يتطلب «التشكل مجتمعاً»، بالمعنى الحداثي للكلمة، وبناء «جماعة وطنية» على أساس التعدد الاجتماعي والسياسي، عملية «انتقال كبرى» أو «عبور» من أنماط القيم والتفاعل التقليدية إلى الحديثة، أي من العلاقات والتفاعلات والتشكلات العمودية القائمة على الملة والنحلة والقبيلة والطائفية، إلخ، إلى العلاقات والتفاعلات والتشكلات الأفقية القائمة على فكرة مواطنة وأحزاب وطنية عابرة للجماعات والتكوينات، وطبقات، إلخ. ومن الانتظام التقليدي الديني والقبلي، إلى الانتظام الحداثي والمؤسساتي والمدني والمهني والطبقي. وأن تكون المواطنة وعلاقة فرد – دولة هي أساس السياسة، بالإضافة إلى عوامل وروائز أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
سابعاً – الواقعي والمخيالي
العلاقة بين الواقعي والمخيالي ملتبسة، يحتاج التشكل الاجتماعي والهوية الوطنية إلى قدر من هذا وذاك. غالباً ما يكون الواقع حاكماً، باعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومدى التماسك الداخلي واتجاهات القيم الحاكمة، إلخ. وأما المخيالي أو المتخيل، فهو مهم من أجل قيام فكرة وطن ودولة، وصياغة إطار عام والتعبير عن «روح مجتمع»، لا يكون بالتمام «حاصل جمع» التكوينات الاجتماعية، ولا هو «منفصل» عنها.
لا يتشكل «المجتمع» أو «الجامعة الوطنية» على معطيات واقعية فقط، ولا بد من جانب مخيالي وتصوري، ومن تَمَثُّل أفكار ومقولات لـ«هندسة»، «تخليق» و«بناء» مجتمع ودولة. إنما لا تجب المبالغة في ذلك، إذ إن ازدياد الفجوة بين الواقع والمتخيل يهدد الظاهرة الاجتماعية وفكرة وطن ودولة. ومن المهم تجاوز المدارك النمطية عن «الوطن» و«الوطنية» و«الأمة» و«القومية»، إلى مدارك تداولية وتعددية، الأمر الذي يبني الجسور بين التكوينات الاجتماعية والأقوام والهويات، إلخ، بدلاً من أن يدمرها. ويساعد في تشكيل حيز أو إطار للوعي والتفكير في الواقع والسياسة والعيش والعمل والإنتاج، في أفق العدالة والمشاركة والديمقراطية.
ثامناً – الثابت والمتحول
الثابت والمتحول في معنى وطن ومجتمع ودولة، سواء في محدداتها أو تجلياتها وتمثلاتها. الواقع أن الحديث هو عن «ما يُعدُّ» أوطاناً ومجتمعات ودولاً. إذ إن «الوطن» في تاريخ وثقافة وأنثروبولوجيا واجتماع الإقليم ليس قيمة عليا في السياسة، وليس وعياً اجتماعياً، وبالتالي ليس من العوامل والمحددات الثابتة في معنى الهوية، أو أن الوزن النسبي لمعنى الوطن أقل مقارنة بعوامل ومحددات أخرى مثل: الجماعة والقبيلة والمنطقة الطائفية وغيرها، التي تمثل «ثوابت» في مدارك وأفعال واتجاهات الوعي والتفكير.
وعلى العموم، ترتبط فكرة «مجتمع» و«جماعة وطنية» بـ«الدولة»، وهذه الأخيرة ليست أفضل حالاً، باعتبار أنها لم تنل الشرعية والمقبولية ولم يمكن إقامتها بشكل مستقر، وهي أقرب لـ«سلطة» منها لـ«دولة» بالمعنى الذي تعرفه العلوم الاجتماعية وبلدان العالم الأكثر تنمية وتقدماً. ومن هذا المنظور، ليس من اليسير أن ينتج «ثابت» عن «متغير». وهذه دينامية بالغة التركيب والتعقيد في التشكلات الاجتماعية في الشرق الأوسط، وعموماً في المجتمعات خارج أوروبا، يتداخل فيها الديني والثقافي والقيمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأنثروبولوجي، إلخ.
تاسعاً – هويات متوازية!
إن التشكلات الاجتماعية عندما تدخل في تفاعل متبادل فيما بينها، في إطار الدولة التعددية الديمقراطية، فهي لا تفقد «هويتها» أو «ذاتها»، بقدر ما تبنيها وتؤسسها ببناء «هوية موازية» لها، هي «هوية وطنية». وهي كما سبقت الإشارة، «لا تقطع مع» تلك الهويات والتشكلات و«لا تتماهى بها» بالتمام. وهذا هو أساس «التشكل مجتمعاً» متوازناً، و«دولة» قابلة للاستمرار والاستقرار.
لكن الحديث هنا هو «غائب» أكثر منه عن «حاضر»، عن «متغير» أكثر منه عن «ثابت». وتظهر أحوال بلدان الصراع في الإقليم مثل: سوريا وليبيا والسودان، وهي خير أمثلة لاختبار مقولات الاجتماع والهوية والدولة في الإقليم (والعالم)، عن صعوبات كبيرة ومتزايدة في هذا الباب. ثمة نكوص حاد إلى مدارك واتجاهات هووية «لا دولتية»، أو تريد أن تجعل «الدولة» والمدارك حولها، بما في ذلك فكرة وطن وخطاب هوية وطنية، «غنيمة» تُغتنم، وستاراً تتستر به قوى وفواعل السياسة والقوة، من أجل تبرير وجودها!
الجماعة الوطنية والهوية الوطنية – ويبدو أننا نكرر هنا – ليست «بديلاً» للجماعات أو التكوينات أو الهويات المتعددة في المجتمع (أو ما يُعد مجتمعاً)، وإنما هي «كيان موازٍ» أو «تشكل موازٍ» قائم على صياغة وتشكيل وتعميم ثقافة عابرة للتشكلات والتكوينات الفرعية، تحتويها وتظللها بالمعنى الموجب، ولا تحل محلها. ولا تقوم الجماعة الوطنية على «الصهر» أو مجرد «الإلحاق» الهامشي و«التكييف» بالإكراه.
عاشراً – هوية الهويات!
وبالتالي، فإن «الجماعة الوطنية» و«الهوية الوطنية» ليست مجرد «جمع» أو «حصيلة» أو «توليف» بين «تكوينات»، بل هي «نتاج» تفاعلها الحيوي والتعددي، في أفق ثقافي وتاريخي وقيمي وحضاري يحدده توافق «فوق سياسي» و«فوق دستوري»، إلخ. وهي شيء جديد، ليس «من» الهويات في داخل الدولة (أو ما يُعد دولة)، أي لا يصدر عنها أو ليس محض تعبير عنها بالضرورة، وإنما هو «فوقها». هو «فوقها» ولكنه «غير منفصل» عنها.
إن الجماعة الوطنية – وهذا من باب التأكيد – لا تهدد أو تلغي التكوينات والهويات الأخرى: الاجتماعية والدينية واللغوية والثقافية والمناطقية، إلخ، إنما تمثل إطاراً لها، في أفق المواطنة ودولة القانون. فأن تكون سورياً أو تكوني سورية مثلاً، ليس ضد كونك عربياً أو كردياً أو شركسياً، ولا ضد كونك مسلماً أو مسيحياً، ولا كونك سنياً أو علوياً أو موحداً درزياً، إلخ. وأن تكون عراقياً أو تكوني عراقية، فهذا ليس ضد كونك عربياً أو كردياً أو تركمانياً، ولا ضد كونك مسلماً أو مسيحياً، ولا كونك شيعياً أو سنياً، إلخ. وأن تكون مصرياً أو تكوني مصرية، فهذا ليس ضد كونك مسلماً أو قبطياً، إلخ.
سوف تبقى النداءات المذكورة، إنما يُفترض أن تكون في أفق «مجتمع» تُدرك أطرافه وفواعله أن فيه انتماءات وهويات دينية ولغوية وثقافية ومذهبية ومناطقية، إلخ، وأن يكون ذلك طبيعياً، وفي أفق نظام سياسي ودولة، على أساس المواطنة.