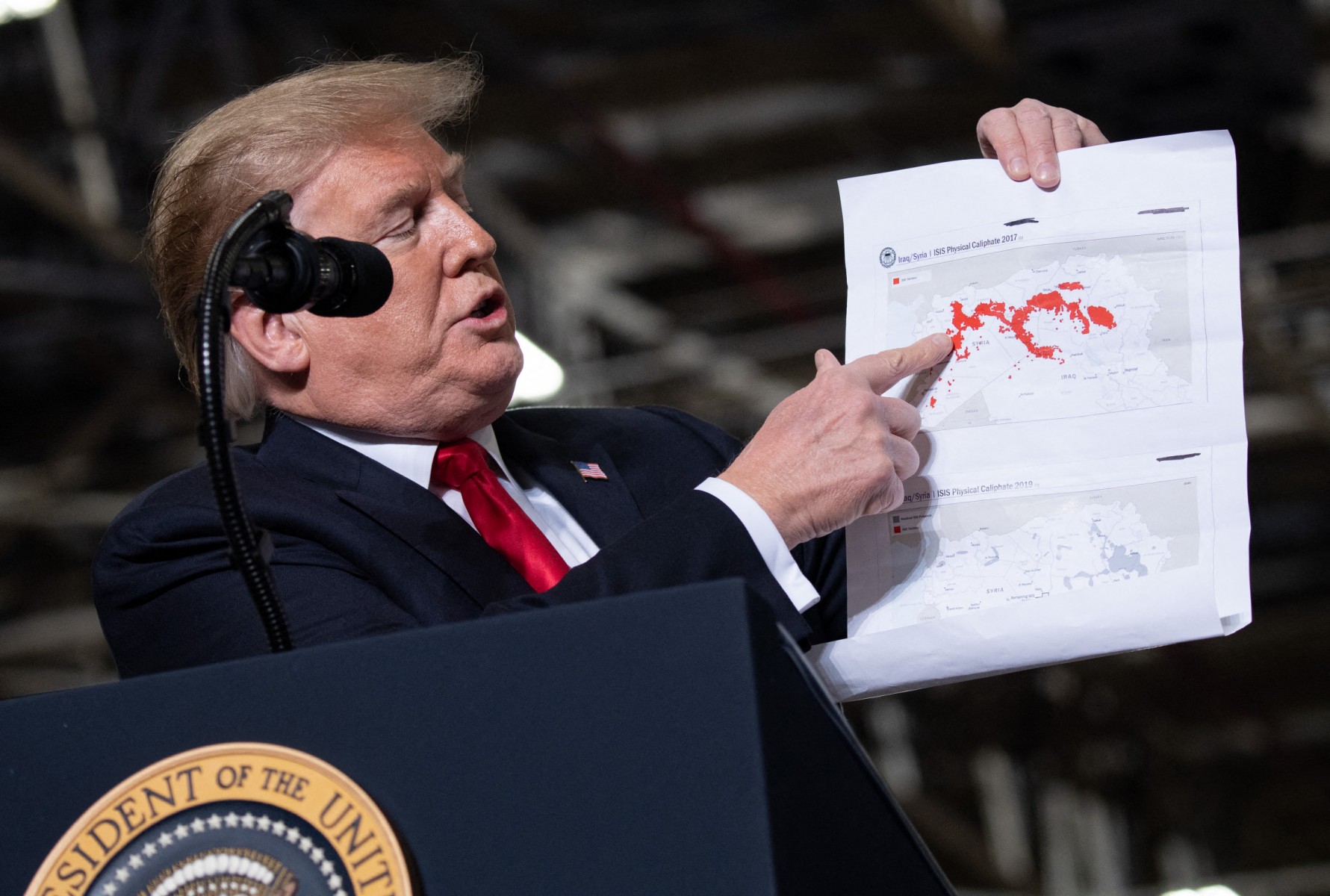شورش درويش
لا يمكن انتخاب كلمة تصف ما يجري في مناطق الساحل السوري بغير اعتبارها حملة إبادة للعلويين، وأيّاً تكن مبررات العمل العسكري في تلك المناطق فهي بالمعاني القانونية والإنسانية والسياسية: إبادة جماعية متولّدة عن مجازر متتالية ومستمرّة.
بدأت عملية تعقّب فلول النظام السابق أو ما نجم عنها من «مطاردة الساحرات» على وقع مهاجمة عناصر من بقايا قوات النظام السابق لقوات تتبع لحكومة أحمد الشرع، لتبدأ إثر ذلك سلسلة من المجازر وحلقات الإعدام الميداني وإلقاء الذخائر من المروحيات دون تعيين، وحملات دهم وترويع وسرقة وتعفيش نفّذتها القوات المختلطة المؤتمرة لدمشق.
على أنه يمكن رسم الطريق إلى مجازر الساحل بأنه بدأ بما أسمته أذرع السلطة الإعلامية ومؤيّدوها «الأخطاء الفردية» التي كانت مزيجاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون وحالات ثأر وانتقام أنذرت بالقابلية للقتل والتطهير على أساسٍ طائفي، فمرّ الطريق بمشاهد تعنيف وإهانة العلويين لاسيما سكان القرى العلوية في حمص وحماه وتفشّي خطابات الغلبة الطائفية وتحميل العلويين وزر بطش النظام وكل تركته البشعة. إلى ذلك مثّلت سياسة تطهير جهاز الخدمة العامة من آلاف الموظفين من أبناء الطائفة مقدّمة للتشكيك بنوايا حكومة الشرع، إذ جرى عزلهم تحت بند «موظفون وهميون» وكل ذلك في ظل تردّي الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة في الساحل، مضى الطريق إلى المجازر أيضاً عبر التوترات العسكرية المتقطّعة في قرى وقصبات الساحل، ولعل فقدان الأمل بمشروع الانتقال السياسي، مع وضوح رغبة الشرع وفريقه الحاكم حبس السياسة خارج المجتمع، مثّل الجانب غير المباشر الذي يمكن إضافته إلى جملة العوامل الأخرى، هذا فوق تغليب لغة الإقصاء والتهميش على منطق الحوار والاعتراف بوجود مشكلة طائفية وإثنية وجهوية مزمنة في سوريا بحاجة لمعالجة سياسية وقانونية.
ويمكن كذلك القول بأن قابلية سلطة دمشق إلى الانزياح السريع نحو الحلول العنفية بدل الوسائل السياسية لمعالجة جذر المشكلات السورية يأتي للحفاظ على «هيبة الدولة»، والهيبة هنا هي الجزء القاتل في تفكير أي نظام يريد إثبات نفسه لحاضنته الشعبية وخصومه المحتملين على السواء، وأنه قادر على مزاولة القمع وما ينجم عنه من مجازر ساعة يشاء. المبالغة في استعراض الهيبة استلزم الاستعانة بالغوغاء والجهاديين الأجانب والقتلة أيّاً كانوا لأجل ترويع المدنيين، قبل فلول النظام. هل يذكّر هذا السلوك بما قامت به قوّات الدولة الأسديّة وشبّيحتها؟ واقعياً، نعم ولا توجد إجابات أخرى.
لم يكن العنف المشهديّ وعمليات الإعدام الموثّقة بالصوت والصورة أمراً اعتباطياً بالنسبة لقوات منضبطة وشديدة المركزية كقوات هيئة تحرير الشام التي تفرّع عنها «الجيش العربي السوري» الجديد، إذ إن التصوير الدعائي لعمليات القتل والوعيد كانت جزءاً من مكينة الإعلام الحربي لتطويع المجتمعات الطائفية والإثنية كلها، ويمكن النظر إليها كرسالة للعلويين وسواهم من طوائف وإثنيات وقوى تعترض مشروع الحكم المطلق، كما أن إقحام الفصائل المنضوية في هذا الجيش كفصيلي «العمشات» و«الحمزات» على ما يحملونه من شراهة للقتل والسلب والتعفيش لم يكن تفصيلاً عارضاً، ذلك أن الاستعانة بهذه الفصائل جاء نتيجة حاجة هيئة تحرير الشام لتغطية المنطقة الواسعة مناط العمل العسكري نتيجة ضعف إمكانياتها المادية والبشرية، إضافةٍ إلى إيكال الأعمال الأشد وضاعةً إلى تلك الفصائل؛ فالمعروف عن هذه الفصائل أنها خاضت تجارب «ناجحة» لتطهير منطقة عفرين من قسم من سكانها وأخضعتهم لنظامٍ بربريّ قائم على القتل والنهب والطرد والإحلال السكانيّ ومصادرة الممتلكات.
إلى جانب ما يجري يمكن التنبّه إلى أن الإدارة المؤقّتة في وضع حرج رغم ما تبديه من خطابات تطغى عليها الشدّة والإيحاء بالقوّة، فالغالب على الظن أنه ما عاد بوسع دمشق ضبط فوضى المجموعات المسلّحة التي انفلتت في الساحل حتى وإن أوكلت مهمّة ضبط الساحل لقوات الأمن العام في وقت لاحق. وعليه، فإن سلطة دمشق أمام خيارين يمكن التكهّن بتحقّق أحدهما: إما أن تدخل في دورة تطاحن عسكري مع المجموعات المنفلتة وتفكيك التحالف القائم معها تحت مظلّة «وزارة الدفاع»، أو القبول بالوضع الحالي وما يستصحبه من مواقف دولية رافضة للمجازر وارتفاع نسبة قتل المدنيين، إلى جوار زيادة منسوب الاستقطاب الوطني وتضييع فرصة الحوار مع الشمال الشرقي والجنوب السوري.
والحال أننا أمام صورتين لأحمد الشرع في هذه الأثناء: الأول يحكم ولا يملك ولا قدرة له على ضبط المسلّحين الذي غلّفهم بورقة وزارة الدفاع التي تشفّ ما تحتها من فصائلية مزمنة وولاءات مختلفة يصعب معها الانصياع لقرارات «رئيس الجمهورية» ووزير دفاعه، فيما الصورة الثانية هي لحاكم يعرف ما يحصل ويريده أن يحصل على هذا النحو الدامي، وفي كلتا الحالتين هذا فشل عظيم لأوّل المطالبات العربيّة والغربية التي أكّدت مراراً على وجوب حماية الأقليات وإدماجها في العملية السياسية.
وفي خضم ما يجري من المهم التفكير في أن المجازر تصنع وعي الجماعات وأنها تستقر في لاوعيها كذلك، وبالتالي فإن ما جرى في الساحل من مجازر وترويع سيحفر كثيراً في وجدان هذه الجماعة الأهلية وسيثير قلق بقيّة السوريين غير المؤيّدين لمشاريع الانتقام، وبالتالي فإن أولى الإجراءات التي تتطلّب الحكمة تبدأ بمحاسبة الجناة وردّ الاعتبار لذوي الضحايا المدنيين وإيكال المهمّة للجنة حياديّة محميّة، على ألّا تكون كلجنة «مؤتمر الحوار الوطني»، أو لجنة إعداد الإعلان الدستوري، فإنعدام الثقة بفكرة «اللجان» بدأت مع الأولى واستمرّت مع الثانية، وإلى جانب ذلك يبدو أن تكسير فكرة الجيش الطائفي باتت خشبة الخلاص للشرع نفسه إذا ما أراد ذلك، فالضروريّ الآن أن يتم إيكال جزء من مهمّة حماية الساحل لأبنائه، علويين وإسماعيليين وسنة ومسيحيين، أي لعموم السوريين من أبناء الساحل بلا تمييز، وبخلاف ذلك سيذكّر وجود عناصر من لون وعقيدة واحدة بالمجازر التي حصلت وأن المجتمع المحليّ يرزح تحت وطأة «احتلال داخليّ» على ما قالته التجربة الأسدية، ومن هنا ستصبح مهمّة فلول النظام أسهل مرّة أخرى لبث فتنة جديدة في وقت آخر.