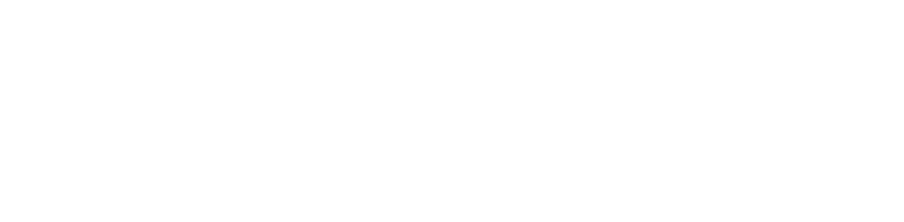د.عقيل سعيد محفوض
سوريا التي كنا نعرفها انتهت. الفكرة ليست وليدة سقوط النظام، الصحيح أنها قبل ذلك. وعندما كتبتُ في مقال قبل عدة سنوات، أن سوريا التي كنا نعرفها لم تعد موجودة، مجتمعاً ودولةً، وأن استخدام تلك الكلمات والتسميات هو “بحكم العادة” و”بقوة العطالة”، وبحكم السياق الإقليمي والدولي؛ بدت الكتابةُ سوداوية بنظر البعض، ونافرة بنظر آخرين. وتلقيت رسائل تحفُّظ واعتراض أو عدم رضا. ولن نجادل في السؤال: هل كنا نعرف سوريا حقاً، وما كانت طبيعة معرفتنا بها، وأي معرفة أو معارف كانت لدى السوريين والمعنيين بسوريا عنها؟
كان الحديث عن سوريا، خلال العقد ونصف الأخير، هو “بحكم الأمل” بوجود مجتمع ودولة سوريين، ولو أن الأمل تراجع إلى حد كبير. والصحيح أن جانباً من ذلك _أي الأمل_ كان “بحكم الخوف” من انهيار المجتمع والدولة، أو ما كان يُعدُّ مجتمعاً ودولة، ودخول البلاد في حالة “حرب الكل ضد الكل”.
الأرجح أن سوريا، التي كنا نعرفها، لم تكن محل تطلُّع أحد، لا بالعودة إلى ما كانت عليه قبل 2011، ولا سوريا خلال الحرب، أي أن الأمل بسوريا جديدة في ظل نظام الأسد كان متضائلاً وصولاً إلى درجة الموات. والمقصود هنا هو مجتمع ودولة سوريين، وليس مجرد عنوان منقطع أو ضعيف الصلة بالواقع. وفي السنوات القليلة الأخيرة قبيل سقوط النظام، كان أمل السوريين بالمستقبل قريباً من “الدرجة صفر”. وكان مجرد التفكير بالمستقبل أمراً أشبه بـ”مزاولة المستحيل”!
أما لماذا كان كذلك، أي أشبه بمزاولة المستحيل؟ فهذا يعود لـ”عقبات إدراكية” و”مدارك نمطية” بالغة التركيب والتعقيد، وللتمركز حول النظام السياسي، و”المماهاة” بين رأس النظام-والنظام نفسه-والدولة، بكيفية جعلت مجرد التفكير بالتغيير نوعاً من “التفجير الداخلي” أو “التدمير الذاتي” للنظام، وبالطبع للدولة والمجتمع!
وبعد سقوط النظام مباشرة، اكتشف كثيرون أن جانباً من “الاستحالة” إياها كان هو “المعادل” أو “النظير” لفكرة “الأبد” التي زرعها النظام، وعمل عليها لعدة عقود، وحاول “إعادة إنتاجها”، بل “تأبيدها”، بما أمكنته الحيلة والوسيلة. واكتشف كثيرون أيضاً أن الحكم قام في جانب منه على “إدارة المخاوف” أكثر منه إدارة أو خلق عوامل الاطمئنان والأمان. كان ذلك نوعاً من “تفخيخ” المجتمع بالعنف والانفجار.
حدث في سوريا أنماط من التوحش القاسي والتحول إلى الحياة العارية، أي مجرد القدرة على العيش، بالمعنى الفيزيولوجي والبيولوجي، وهذا طال شريحة واسعة من الناس، قدرتها بعض الإحصاءات بين 90-95 بالمئة من السكان. هل بعد هذا معاناة وتوحش؟ وما زاد الأمور قسوة، هو غياب أي أفق لتغيير الأحوال، وغياب أي إرادة لدى فواعل السياسة والحكم للاستجابة لمتطلبات الحل/التسوية.
ثمة مسار كانت البلاد تسير فيه ببطء، ثم بتسارع، إلى الهاوية، وليس فقط الصراع والحرب. ولو ان الانهيار أو السقوط ما كان قدراً، لا حتمية هنا، بل كان حصيلة سيرورات وتدافعات مختلف فواعل الحدث السوري والظاهرة السورية. وكانت سوريا، منذ العام 2011، عبارة عن مجال تتنازعه رهانات مختلفة إلى حد التناقض القاتل. وتطورات الأمور بشكل قاتم. تهتكت الخرائط والعناوين والشعارات، وتعفنت الخطابات والمقولات، وبالطبع المنظمات والمؤسسات، وتحولت “الدولة” تدريجياً إلى أشبه بـ”الميليشيا”، فيما تحولت “الميليشات” تدريجياً إلى “شبه دولة” أو “كيانية”. وأصبحت البلاد مِزَقاً، ومناطق سيطرة وأنماط إدارة وحوكمة، وحتى أنماط فساد واستبداد متعددة، ولو أنها ليست سواء.
وهكذا، تآكلت فكرة سوريا، مثلما تآكلت كيانيتها وخرائطها ووجودها. وأصحب بلاداً أو شبه بلاد، كما لو أن “الباقي فيها مفقود، والخارج منها مولود”. وهذا يفسر –مع عوامل أخرى- النزوع المحموم بل الهستيري للهجرة إلى الخارج، والابتعاد عن كل ما يتعلق بالسلطة أو الدولة ومؤسساتها. وترك الوظيفة العامة، والتملص من الخدمة العامة، وبالأخص الخدمة الإلزامية.
وإذ وصلت الأمور، في سوريا التي كنا نعرفها، إلى “انحباس” في المعنى والقوة، و”جمود” في التقديرات والمسارات، فقد اندفعت الرهانات الحادة بشكل مفاجئ، ومعها تفاهمات وتوافقات بين فواعل الحدث السوري، في الداخل والإقليم والعالم، وأدت –مع عوامل أخرى- إلى سقوط النظام وفرار مُذِلّ وهَزَلي لرئيسه وعصبته، الذي أجمعتْ التقديرات تقريباً على أنه كان “منفصلاً عن الواقع”، وأنه فكر بـ”أنوية فائقة” أدت إلى الكثير من الفساد والموت والدمار، والذي أتى -في نهاية المطاف- عليه هو نفسه. ومَثَّلَ النظامُ أحد أكثر مصادر التهديد –بالمعنى الوجودي- للمجتمع والدولة.
لم يمكن التوصل إلى حل أو تسوية، ولم يقدم النظام مبادرة واحدة للحل/التسوية، ولم يتقدم النظام خطوة واحدة في تغيير أنماط السياسة والحكم. بل واصل بعناد غريب سياساته المدمرة للمجتمع والدولة، وبالطبع مدمرة له هو نفسه. ولم يتمكن فواعل الحدث السوري، من دفعه للقبول بالقرار 2254 أو أي صيغة منه، ولا حتى أي شكل من أشكال “نقل السلطات” حتى بعدما تبين له أنه في ساعاته الأخيرة.
الواقع أن النظام كان “غير قابل للإصلاح”. وكل عملية “إصلاح” أو “ادعاء إصلاح”، لم يكن الهدف منها صالح الدولة والمجتمع، وإنما استمرار النظام نفسه، و”إعادة إنتاجه”. ولكن ما حدث في الواقع هو أن كل خطوة في هذا الاتجاه كانت تُفضي إلى “عكس المطلوب” من قبل النظام. أي أنها كانت تُعَجِّل في انهياره.
وفي الختام،
انتهت سوريا كما كنا نعرفها، صحيح أنها تشكلت قبل أكثر من مئة عام، بـ”إرادات دولية” و”قابليات محلية”. ويبدو أن “الخارج” كان “عامل الترجيح الرئيس” في تحولاتها الرئيسة خلال تاريخها، بما في ذلك قيام النظم وانهيارها، إلا أن ثمة “فرصة سانحة”، بالمعنى التاريخي، لأن يشكل السوريون بلدهم، أقرب ما يكون لصورتهم وتطلعاتهم ورهاناتهم هم، قبل أن يعود “الخارج” إلى دورة تدخلاته فيهم وفرض إكراهاته عليهم!