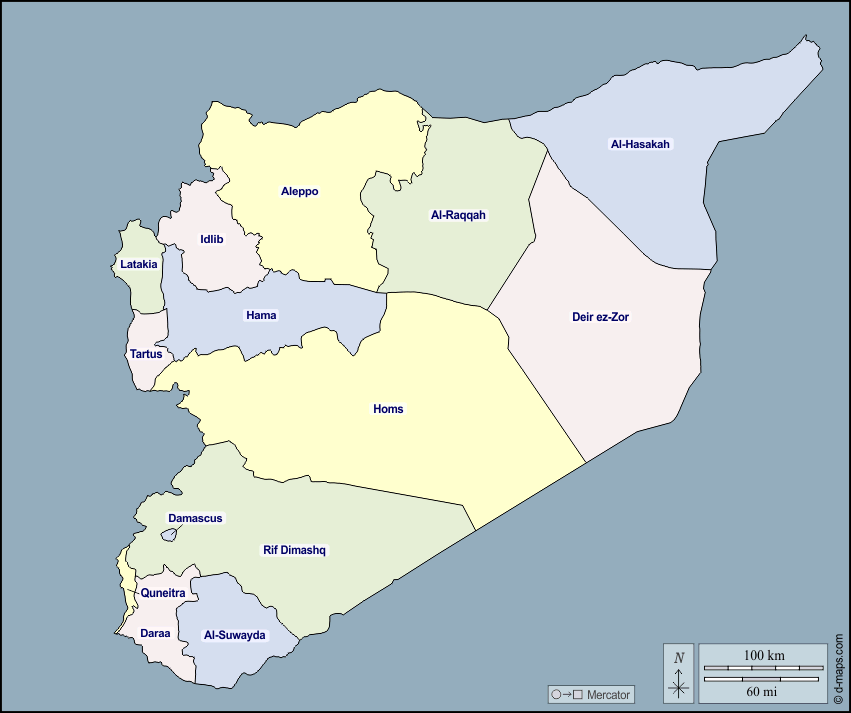موفق نيربية
منذ عام 2016، أصبح التشرذم الكبير أو الهائل للمعارضة السورية، مع تفاقم تعقيد وتركيب الصراع، مساهماً رئيساً في استنتاج كون ذلك هو ما يجسّد «النمط الجديد» للحروب الأهلية. والمصطلح الأخير محطّ غضب- مشروع- من قبل الكثير من السوريين الذين ما زالوا يحلمون بأن تنتصر ثورتهم التي قاموا بها في 2011؛ ولكنّ ذلك للأسف أصبح من بديهيات المتعاملين مع القضية، خاصةً من بين أصدقاء الشعب السوري ومؤيّدي مطالبه. يؤثّر ذلك التشرذم على آليات الصراع وديناميكيته، كهيمنة العنف عليه وضراوة الصراع وما يحيق بالمدنيين ودرجة دعم المعارضة المسلحة، ومن ثمّ دورها في أيّ تفاوض، شكلياً كان أم جدّياً.
كان ذلك التحوّل موضوعاً أساسياً لمنتدى أوسلو الذي انعقد في منتصف ذلك العام، بمبادرة من الخارجية النرويجية ومركز الحوار الإنساني المعروف. وشارك فيه مئة شخصية بينها عدد من رؤساء الدول السابقين ذوي العلاقة بالموضوع مثل كارتر وخاتمي ومبيكي وأونغ سان (فكّ الله أسرها) وهيتساري وأوباسانجو وجيري آدامز (الشين فين) وكوفي عنان والأخضر الإبراهيمي والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
يمثّل المنتدى واحداً من أهم- ما لم يكن الأهم بالفعل- ملتقيات وسطاء النزاعات، ويعتمد في عمله على سلسلة من الخلوات الجانبية المتحفّظة، ما يساعد على تبادل الآراء بصراحة وهجومية تقارب الاستفزاز، لخلق جوّ من التفكير المختلف والتشاور البنّاء، وقد يساهم أيضاً في ذلك طرح أفكار الجهات المتحاربة، حتّى في مضامينها القصوى. لا تصل الخلوات إلى اقتراحات وتوصيات بمقدار ما تقدّم أفكاراً تساعد على الوساطة وتطوّر فاعليّتها. كان موضوع المنتدى يومها هو التكيّف مع الصراع بمعالمه الجديدة المذكورة. وكانت الورقة الأكثر أهمية أمامه فيه بعنوان «فهم التشرذم في النزاع وتأثيره على آفاق السلام». ما تقوم بفعله هذه المقالة هنا هو ليس التعميم أو انطلاقاً غير ملتزم، كما لا تحدّه تلك الدراسات والنقاشات المغلقة، بل التخصيص- المزيد من التخصيص- في الحالة السورية.
في أسباب التشرذم هنالك أولاً وبشكل رئيس سبب هيكلي يتعلّق بالمجتمع المعني. كمثال على ذلك حالة إثيوبيا، حيث حكمت اللجنة العسكرية «الديرغ» – ومعناها اللجنة – المؤلّفة من عدد من صغار الضباط، منذ قادت عملية انقلاب في 1974 على الإمبراطور هيلاسيلاسي وتصفية حكمه. بعد ذلك، قام منغستو هيلا ميريام بالانفراد بالسلطة وتصفية خصومه بدوره تحت غطاء إيديولوجي يساري ودعم سوفييتي. وانعكست تركيبة المجتمع الإثيوبي على النظام والمعارضة. اعتمد هيلا ميريام على التأميم والقمع الدموي والرطانة الثورية المتطرّفة لتثبيت سلطته وسلطة «الديرغ» معه. ولكن عقدين من الصراع وتحالف القوى المناوئة، التي كان معظمها يسارياً بالمناسبة، وشنّ الهجمات المسلحة من قبل تحالف المعارضة من دون هوادة، التي لم يردعها «الإرهاب الأحمر» أو «الكي شيبير» أو المجازر، أدّت في النهاية إلى فرار منغستو إلى زيمبابوي حيث لا زال حياً حتى الآن.
كان المجتمع الإثيوبي يتألّف وقتها من مركبّات قبلية عدّة بينها الأمورو والأمهرة والتيغراي والإريتريين والصوماليين وغيرهم، ومن المسيحيين الأرثوذوكس القدامى والمسلمين وديانات قديمة، يتكلّمون لغات عديدة جداً، حتي في إطار الإثنية الواحدة. وعند التحالف في وجه طغيان منغستو، اتّحد معظمهم. لكنّ تلك التعدّدية انعكست فوراً على درجة التجانس والصراع الداخلي. ولم يستطع مئات الآلاف من ضحايا النظام أن تنهي ذلك التعدّد أو تمنع ظواهره وآثاره واستمراره. من بين هؤلاء أيضاً، من كان طامحاً إلى تقرير مصيره كالإريتريين والصوماليين بدرجة أقل. حالياً، هنالك صراعات على السلطة بين هذه الأطراف تنعكس بقوة على درجة قوة تماسك المجتمع.
كانت تركيبة المجتمع الإثيوبي، ذات الهويّات المتصادمة المتعدّدة، سبباً في حالة التشرذم الاجتماعي- السياسي، وتشبههاً، ولو عن بعد، تركيبة المجتمع السوري، حيث المناطق المتمايزة والإثنيات أو القوميات المختلفة والأديان والطوائف المتنوّعة أيضاً. لا يغني تبنّي أكثرية إثنية أو قومية أو لغوية أو دينية أو طائفية عن المسار المنحدر الذي يمكن أن تقود إليه العصبيات المتناحرة في هذا المجال. حدث هذا في الصومال بعد إسقاط سياد بري مطلع عام 1991.
يتعلّق سبب آخر لتشرذم المعارضة بقمع النظام وضغطه المستمرّ دائماً أو على موجات تتناوب مع موجات إغراء وإغواء بمنافع جانبية للسلطة. بعد إلغاء حافظ الأسد لمعارضته الأكثر خطراً لطموحاته في نظام البعث في خريف 1970 وانقلابه عليهم، عن طريق سجن قيادات تلك السلطة «إلى الأبد»، وملاحقة الآخرين بشكلٍ متفاوت وحتى يلينوا مع الزمن، إن لانوا، اشتغل ومنذ مراحل مبكّرة على تلبية طمع العديد من القوى «التقدمية» وإغرائها بالوزارات وعضوية مجالس المحافظات وعضوية قيادات الجبهة التي استُحدثت في عام 1972. قاومت أطراف وخضعت للضغط ولانتهازية أطراف، فانشقّت غالبية القوى الموجودة آنذاك. حتى الإسلاميين والإخوان أنفسهم تعرّضوا لاهتزاز في بنيتهم وظهرت تبايناتهم بين من يريد التأنّي والاستفادة من الاسترخاء لخدمة «الدعوة» بقيمتها الاستراتيجية، ومن يريد الإسراع وحسم الصراع مع «العلويين». ظهرت احتجاجات إسلامية، وابتدأت مقاومة ما حمل لاحقاً اسم الطليعة المقاتلة، المنشقة – وغير المنشقة – عن الإخوان. في الوقت نفسه، ظهر حزبان شيوعيان، وحزبان للاتّحاد الاشتراكي، وحزبان للوحدويين الاشتراكيين، وآخران للاشتراكيين العرب، وهلم جرّاً…
نجح النظام والبعث العراقي والطليعة المقاتلة بتحويل اتجاه الصراع في عام 1980 باتّجاه العنف. وتعرّضت تلك القوى المعارضة سلمياً لزلزال لم تسلم منه حتى بعض القوى الإسلامية. فبعضها أحسّ بخطر العنف موضوعياً، لكنّه أحس بخطره الذاتي أكثر وآثر السلامة. اضطرّت القلّة ممن بقي للنزول تحت الأرض وأخذت ريح العنف تشطرهم أيضاً وتفتّت بنيتهم. كان عنف أطراف أخرى سبباً أيضاً للتشرذم ما زالت آثاره تفعل فعلها فيه. لقد حكم استحكام التسلّح والعنف حتى في فترة ثورة 2011 بمزيد من التفتّت والتشرذم، حتّى أصبح عديد القوى المعارضة، مسلّحة كانت أم مدنية، لا يمكن إحصاؤه، ولا إيقافه لساعة يمكن عدّ أطرافه فيها. والحديث بالطبع عن بلدي سوريا.
كان ذلك العنف مع قوى النظام، لكنّه كان بينيّاً أيضاً وبوضوح كبير وفاضح. إذ ظهرت مئات القوى المعارضة المسلّحة واختفى مثلها من الوجود في بيئة تنافسية وتصفوية، أو تحوّلت إلى كيانات أخرى تتبع هواها أو أمانها أو مصلحتها الماديّة المباشرة. كان ذلك التنافس على أساس الهيمنة المادية على الأرض أو فرض الإيديولوجية المعنيّة أو لالتماس دعم معيّن أو ما في حكم ذلك.
من تلك الزاوية، يمكن النظر مباشرة أيضاً إلى الخلافات الاستراتيجية أيضاً وليس الإيديولوجية فحسب. في المعارضة السورية خيّمت الأهداف الطائفية تدريجياً وبصمت أو موّهت على صراعات المعارضة المكتومة، وكان حتماً في تلك الأجواء أن يكون الطرف الأضعف هو القوى والعناصر الديموقراطية من دعاة الحداثة الذين انفصل بعضهم باتّجاه الرأي والموقع المقابل وبقي الآخرون أكثر ضعفاً وعزلة وأقلّ فاعلية وتمثيلاً أيضاً.
وفي هذا المجال أيضاً، كان هنالك دوماً عناصر تشتيت للقوى تتعلّق بدرجة الراديكالية، ليس بالطائفية وحدها، بل أيضاً حول شعارات الثورة وقبول أو رفض العروض الدولية الوسيطة: رفض المجلس الوطني السوري بيان جنيف ذاته في ساعته على سبيل المثال. وبقي هنالك شعور دائم بالنصر الكامن وراء الباب. زادت حدّة بعض الشعارات وغلوّها حتى في أكثر لحظات التراجع وضوحاً، الأمر الذي أضعف دعم المعارضة السورية دولياً وعربياً وضيّع من يديها حرفة السياسة وزاد بشدّة من تشرذمها، حتى بين أصحاب الصوت الواحد.
أحسّت بعض أطراف المعارضة في وقت مبكّر بأخطار التدخّل الخارجي عسكرياً وسياسياً وماديّآً، كما فعلت هيئة التنسيق الوطنية، لهذا السبب، وغالباً لأسباب أخرى تتعلق بالاعتدال واليقظة وتقليل الأذى المحتمل. وحدث مثل هذا التدخّل من قبل إيران وروسيا وتركيا بشكلٍ مباشر، ومن قبل الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي حاول الالتزام فقط بهدفه المعلن. حدث أيضاً بشكلٍ غير مباشر عن طريق إقحام حزب الله والميليشيات الأفغانية والباكستانية والصينية والشيشانية، وهذه كلها كان يدفعها العامل الإيديولوجي المحض أو المنافع الخاصة سياسياً أو معنوياً.
بعد بداية الثورة بوقت ليس طويلاً بتاتاً، ابتدأت القوى الإقليمية بتطوير موقف ملموس منها ومن استراتيجيتها. واجتمعت مصلحة بعض تلك القوى على إضعاف الدور المستقلّ للمعارضة، إضافة إلى دعم وتشجيع العمل المسلّح. وحين تبلورت اتّجاهات الانشقاق عن الجيش وتشكلت فصائل مسلّحة، كان الاهتمام منصبّاً على قطع الطريق على أن تكون المعارضة السياسية متحكّمة بالمسار والقرار العسكري، الأمر الذي كان له تأثير أيضاً على مناحي تفتّت المعارضة المدنية والسياسية.
لعبت البيئة الدولية دوراً كذلك. وكان لدول الخليج مع تركيا دور على هامش تشكيل المجلس الوطني وما نتج عنه من تعزيز دور الإسلاميين، وما يعنيه ذلك على الصعيد العسكري لاحقاً، وعلى غلوّ المجلس الوطني في عملية السعي والتحريض على التدخّل الخارجي. وحين لم يعد ممكناً للمجلس الاستمرار على تلك السياسة مع تغيّر الظروف، تمّ تفويض قطر بتشكيل الائتلاف، فجاء على النمط الذي تراه من دون أن يكون مساعداً للعملية السياسية التي أراد المجتمع الدولي تشجيعها ورعايتها.
حظي ذلك كلّه بأطراف معه وأطراف ضدّه وأطراف بين بين، وتعمّقت الشروخ بين المعارضة، التي بدأت الندوب تعلو وجهها أيضاً، وهي التي لم تعد قادرة على الحفاظ على وحدتها وواحديتها إلّا من حيث الشكل الذي لا يغني ولا يثمر.
حين ازداد خطر تنظيم داعش وتمدّده من العراق إلى نصف الخريطة السورية تقريباً، أحسّ الغرب بالخطر وحاول مواجهته عن طريق المعارضة السورية وقواها العسكرية، وابتدأ بالخطوات العملية لذلك. اشترط على من يحارب التنظيم بالتحالف معه أن تكون قواه وأفعاله منسقة ومنصبّة باتّجاهه. ورفضت المعارضة الرسمية ذلك بالتوازي مع رفض قواها المسلّحة، بدفع من تركيا، وتحت عنوان عدم قبول أيّ عمل يلهي عملية إسقاط النظام.
في الوقت نفسه، كانت القوى المنضوية في إطار وحدات حماية الشعب جاهزة وتطابق عملها مع استراتيجية واشنطن الرامية إلى محاربة تنظيم داعش، وإلحاق الهزيمة بالتنظيم، ما منحها الأفضلية على الأرض تجهيزاً وسيطرة ودفعها للتواصل مع الآخرين والانفتاح النسبي من خلال قوات ومجلس سوريا الديموقراطية. وما بين ذلك المسار والعقدة التركية الخاصة بالأمن القومي و«الخطر الكردي» ، زاد الانقسام الإثني تعمّقاً، وزاد معه انقسام آخر كردي- كردي، ما بين من تدعمه الولايات المتحدة؛ ومن يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق، وتركيا حين يكون الأمر لازماً وضرورياً، مع غياب نسبي ولا إرادي عن الأرض.
دعمت تركيا أيضاً تسليح وتسييس الأقلية التركمانية، التي عانت طويلاً بدورها من النظام البعثي. وتأسست قوى عسكرية كان طبيعياً- ربّما- أن تكون عضوية أكثر مع تركيا، تستطيع من خلالها، ومن خلال القوى الأخرى في الشمال الغربي، أن تنفّذ ما تريده في الوقت المناسب، حتى وصل الأمر إلى حدّ إرسال مجموعات منها مع إغراءات مادية مباشرة إلى حرب بعيدة في ليبيا وفي آذربيجان على سبيل المثال.
لم نصل الأمور إلى حالة تشرذم وتفتّت هائلة التعدّد والتفرّع فحسب، بل إلى حالة مزرية وقاع لا قرار له، قد يجعل العملية السياسية مستحيلة في وقت قريب من دون صدمة عملية وفكرية واستراتيجية كبيرة، لا يراها السوريون حتى الآن في أفقهم الرمادي الغائم.