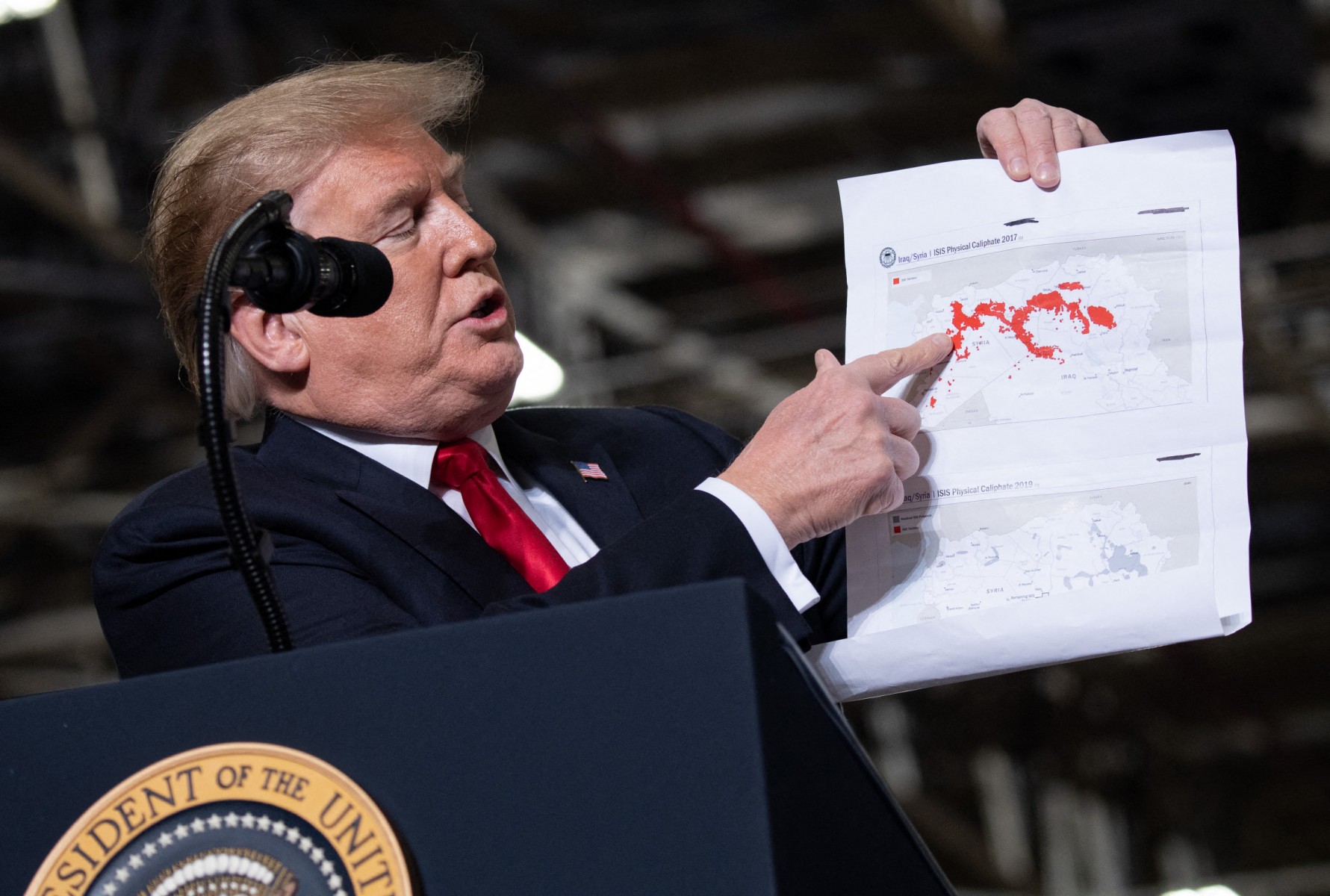شورش درويش
نجحت قوات سوريا الديمقراطية في احتواء الاضطرابات الأخيرة التي وقعت في دير الزور، وأعادت إطباق السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتها خلال مدّة وجيزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات فيما خص السياسات التالية لقسد والإدارة الذاتية لئلّا تتكرّر حالة الاضطراب، وتمكّن أطراف الصراع السوري، الإقليمية والمحلّية، من تغذية الخلافات والنعرات الجهوية والعشائرية مجدداً، خاصة أن أطراف الصراع هذه، رغم تباين مصالحها ومشاريعها، اكتشفت «حصان طروادة» جديد يمكن من خلاله النفوذ إلى المنطقة التي أحكمت «قسد» سيطرتها عليها. يمكن الوصول إلى استنتاجات وتصوّرات تساهم في صناعة استقرار مستدام في ريف دير الزور الشرقي، بما يقطع الطريق على تنشيط الحروب البدائية التي تدخل في حسابات الدول الإقليمية وتزيد من تعقيد المشهد السوري ومفاقمة مشكلات السكان المحليين.
حملة «تعزيز الأمن» نجحت سياسياً أيضاً
أُخذ على «قسد» تأخرها بمحاسبة المتورطين من مجلس دير الزور العسكري في سلسلة انتهاكات ارتكبت خلال العام الحالي. قرار عزل وثم اعتقال أحمد الخبيل (أبو خولة) في 30 أغسطس/آب الماضي، بررته في بيان رسمي بارتكاب الخبيل «العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية»، فيما بدت مناشدات الأفراد والعشائر لوضع حد لتجاوزات وانتهاكات الخبيل أسبق على قرار العزل بعدة أشهر. يمكن تفهّم الشرط السياسي والاجتماعي المتحكم بالمشهد في ريف دير الزور الذي حاولت «قسد» التخفيف من آثاره حال محاسبة الخبيل، إلّا أن الواضح هنا أنه لم يكن هناك من مفرّ عن المحاسبة ومواجهة الفوضى في المحصّلة.
في خضم عملية «تعزيز الأمن» التي أطلقتها قسد لاستعادة السيطرة، جرى الحديث عن العشائر و «انتفاضتها» بشكل مغاير لما يحدث على الأرض. تم تنزيه بعض المتمردين الذين كان النظام والمعارضة يصفونهم بالمتورطين بارتكاب جرائم، كما في حالة الخبيل وأشقائه. صوّر الإعلام الرسمي والمقرب من النظام السوري، وبالمثل الإعلام التركي والسوري الموالي لها، أحداث دير الزور الأخيرة بأنها جزء من بداية انهيار سلطة الإدارة الذاتية، على الرغم من أن الواقع الميدانيّ بدا شديد الاختلاف عمّا جرى الترويج له، ذلك أن حوالى خمس قرى فقط، من أصل ما يزيد عن 120 قرية وبلدة تسيطر عليها «قسد»، شهدت اضطرابات على خلفية اعتقال الخبيل.
في المحصلة، أعادت «قسد» سيطرتها على المنطقة بعد وقت قصير من التمرّد، وكانت بلدة ذيبان آخرها، لكن محاولة زج العشائر في مجرى الصراع التنافسي بين القوى الإقليمية والدولية في شرقي سوريا يبرز كملمح جديد للديناميات التي ستتبعها القوى المتنافسة لاحقاً، والتي يجب التعايش معها في الوقت الحالي والحد من إمكانية تفاقمها.
من نتائج عملية «تعزيز الأمن» أنها مكّنت «قسد» من تحقيق نصر سياسيّ إلى جانب إعادة بسط سيطرتها العسكرية، وعلى عدّة مستويات:
أولاً، لم تضطّر قسد للاستعانة بالقوّة الأميركية الموجودة على الأرض، وهو ما عنى أن مسألة إحلال الأمن وضبط الفوضى هي مهمة «قسد»، وبالتالي لا تسبب الاضطرابات المحلية أيّ صداع لواشنطن، وأن بقاء جنودها شرقي الفرات في مأمن عن الصراعات المحلّية قد تحقق، والتخفيف تالياً من ذرائع الاتجاهات الداعية للانسحاب من سوريا في واشنطن.
ثانياً، لم تنجر «قسد» إلى صراع مع المليشيات الإيرانية، بل اقتصر عملها على صد ووقف كل تقدّم لتلك المليشيات التي حاولت عبور نهر الفرات إلى الضفة الشرقية، ولعل فشل نواف البشير المتعاون مع إيران في إحداث أي اختراق يذكر في شرقي الفرات كشف ضعف هذه القوّات وانعدام أي آصرة شعبية وعشائرية لها خارج مناطق سيطرة النظام وإيران، وبالتالي تجنّبت قسد الانخراط في حرب لا تريدها. بكلمات أخرى: نجحت «قسد» في الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن مجرى الصراع الأمريكي الإيراني.
ثالثاً، أثبت نموذج حرب العشائر البدائيّ، الذي حاولت تركيا الاستثمار فيه، ضعف أنقرة في العمق العشائري العربي بدير الزور والرقة والحسكة، ونجاح «قسد» تالياً في حركة التشبيك مع الأطر المحلية وقطع الطريق على تركيا التي قيل إن لها حضوراً عبر الشخصيات العشائرية السورية المعارضة المقيمة في تركيا. حاول رئيس الائتلاف المعارض سالم المسلط ارتداء عباءة العشائر خلال أيام الاضطراب لكنه فشل في مناشداته العشائرية لشن حرب واسعة على «قسد»، ما كشف عن هشاشة دوره المحلّي أمام المسؤولين الأتراك، وبدا معزولاً، مثل نواف البشير، بشكل واضح في شرقي الفرات.
أبعد من اضطرابات محلّية
على الرغم من تعدّد الجهات التي تسعى إلى تقويض سلطة «قسد» وتفكيك شراكتها مع العشائر والمجتمع المحلّي واستدامة المعارك وتغذيتها، فإن تلك الجهات بدت أكثر حماسة من أي وقت للنفوذ إلى شرق الفرات على وقع حالة الفوضى وإعادة تركيب الصراع على أسس عشائرية هذه المرّة، ولتشهد مناطق الإدارة الذاتية، خارج دير الزور، هجمات من فصائل «الجيش الوطني» بمسمّى «جيش القبائل» في تل تمر وعين عيسى، وهجمات موازية لجهاديي «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) على أطراف منبج تحت اسم «الفزعة» ، الأمر الذي عكس إحلالاً للعصبية القبلية مكان العصبية الدينية.
لكن على الرغم من ذلك، بدا واضحاً، ومبالغاً فيه أيضاً، تعويل المعارضة والنظام، ومن خلفهما تركيا وإيران، على تنامي الاضطرابات وانضمام العشائر إليها. غايات هذه الجهات بدت متضاربة وإن كانت الهدف المشترك تمثّل في السعي لإنهاء سيطرة «قسد» وضرب تماسكها الداخليّ. وبمعزل عن محاولة إقحام لاعبين محليين في مجرى الاضطرابات والفوضى التي حصلت، ينبغي النظر إلى ما يجري في دير الزور كصراع تنافسي بين واشنطن وطهران، وآخر يعكس الخلاف بين أنقرة وواشنطن.
يدفع سعي إيران الحفاظ على حركة مرور مليشياتها إلى سوريا ومحاولة تثبيط مساعي واشنطن ضبط الحدود السورية-العراقية إلى الاعتماد على المليشيات المحلّية و«قوات الدفاع الوطني» لأجل إحداث اضطراب في مناطق سيطرة قسد حيث تتمركز قوات التحالف الدولي، والتحرّش بقاعدة التنف ومحيطها (منطقة الـ 55كم). شرق الفرات بهذا المعنى هو عمق استراتيجي للإيرانيين، وستبذل لاحقاً جهود كبيرة لزعزعة استقراره، إلّا أن هذا المنحى الإيراني قد يصطدم بتواجد «قسد» الكثيف، ما قد يخلق مشكلة للأخيرة وربما يدفعها إلى التخلي الجزئيّ عن سياسة النأي بالنفس لصالح ما تقول «قسد» إنه ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.
في مقابل ذلك، لدى تركيا مخطط موازي، فهي لا تحتكم على موالين لها في شرقي الفرات وعلى خطوط التماس مع «قسد» في دير الزور، لكن مخططها ظهر من خلال شنّ هجمات إشغال شمالاً في تل تمر وعين عيسى ومنبج بغية تشتيت «قسد» وتحويل معركتها في القرى الخمسة بدير الزور إلى مجموعة معارك صغيرة متفرقة ومنهكة. يمكن فهم أن تركيا ليس لديها مشكلة في تقدّم إيران والنظام السوري بمناطق «قسد»، بل إنها دعت إلى شكل للتعاون في سبيل محاربة «قسد»، وتجلى ذلك بوضوح عبر البيان الختامي للدول المشاركة في جولة أستانا 20. تضع تركيا مسألة التعاون بينها وبين النظام السوري في مصافي الشرط الأساسي للتطبيع مع دمشق. إن التنسيق، أو لنقل الاتفاق، غير المعلن بين دمشق وأنقرة وطهران فيما خص تأييد حركة التمرد في دير الزور والدخول على خط المواجهة هو في الحقيقة جزء من رؤية مشتركة ظهرت سابقاً في أستانا 20.
الخاتمة
يبدو أن طهران وأنقرة ستستمران في استثمار ورقة العشائر على الرغم من ضعف فاعليتها؛ فهي تؤمن غطاءً في دفع المنطقة لفوضى أوسع ومواجهة واشنطن بشكل غير مباشر عبر حرب الوكلاء. لا يمكن التغافل عن أن اللاعبين المحليين وبعض وجهاء العشائر تحوّلوا إلى مادّة لتنفيذ سياسات استراتيجية لهاتين القوتين في سوريا، وعنصر شغب إضافيّ.
وعليه، فإن على «قسد» والإدارة الذاتية أن تطوّر مقاربات جديدة في عملها بدير الزور:
– يمكن أن يكون لتوسيع سلطات المجلس المدني، على حساب الدور السابق للمجلس العسكري، دوره في تعزيز ثقة السكان بالجهاز الإداري القائم.
– تقديم عامل الجدارة والكفاءة في تقلّد الوظائف العامّة والعسكرية على بقية الاعتبارات؛ فالملاحظ أن سياسة ممالأة الوجهاء المحليين وتمكّنهم من مراكمة السلطة والثروة أدت إلى ظهور حالة أحمد الخبيل وسواه من مراكز نفوذ غير ضرورية، والتي قد تتكرّر إذا ما اتبعت الإدارة المنحى السابق.
– تشكل العقبة الاقتصادية وضعف موارد الإدارة الذاتية أهم التحديات التي تواجه سياسات الإدارة في دير الزور، خاصة أن المنطقة تفتقر لسياسات تنمية مستدامة، ولدعم المنظّمات التنموية كما في نموذج الرقة. على الإدارة أن تؤمّن المزيد من الخدمات الأساسية والتأكد من وصول الخدمات والدعم للمستحقين الحقيقيين، ودون أن تمرّ تلك الخدمات بشبكات وساطة اجتماعية / عشائرية.
– الإسراع في عقد مؤتمر عام في دير الزور يناقش جملة المشكلات التي تعانيها المحافظة، على أن تتحوّل مقررات المؤتمر إلى برنامج عمل يساهم في التشبيك بين السكان المحليين وقسد والإدارة المدنية، ويساهم تالياً في تمكين السكان المحليين من بلوغ صيغة لحكم محلي رشيد بعيد عن التجاذبات العشائرية والتدخلات الخارجية.