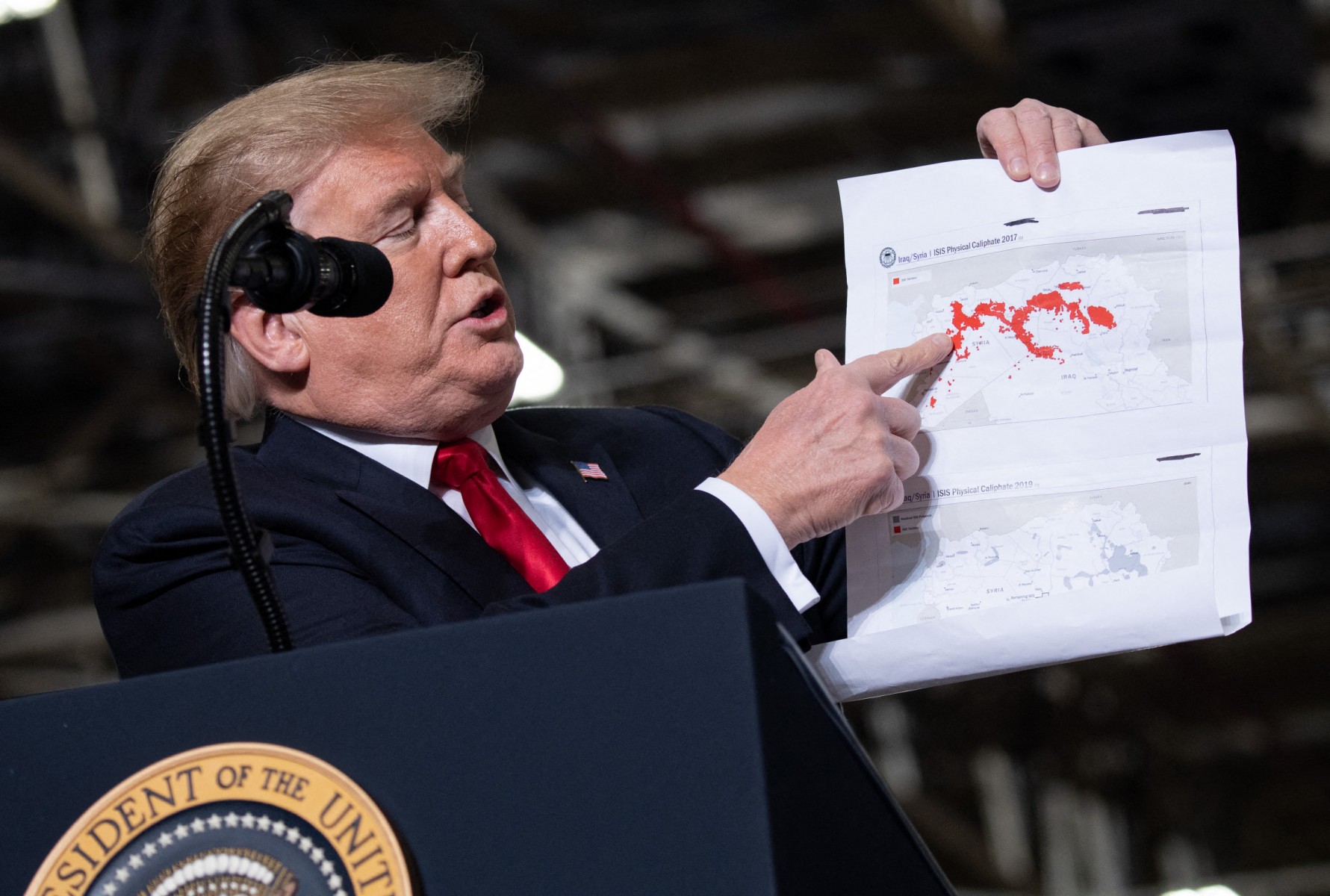موفق نيربية
هنالك أسباب موضوعية عديدة للحراك الذي يشهده جنوب سوريا، وخصوصاً السويداء وجبلها بأغلبيته الدرزية. كما ابتدأت مظاهر غضب عارم في الساحل وجبله بتكوينه العلويّ الغالب، من خلال تسجيلات على الإنترنت كان يمكن أن انتحارية في أزمنة سابقة. هذا المقال محاولة للتفكّر فيما يجري، وأسبابه أو آفاقه. إضافة إلى شعار النظام الشهير: الأسد أو نحرق البلد، الذي شاع في مشارق الأرض ومغاربها، بعد أن صدق الأسد وعده؛ ظهر شعار آخر منذ العام الأول للثورة السورية هو: الجوع أو الركوع. تمّ ظهور وتنفيذ الشعار الأخير أولاً في حمص منذ الربع الأخير من العام 2011 في حمص، التي اشتهرت يومذاك بلقب عاصمة الثورة السورية، وارتبط الموضوع يومها بالتوتّر الطائفي الذي حرّضته حوادث قتل طائفية في أحياء داخلية أولاً، ثم في بابا عمرو والحولة لاحقاً في أوائل العام التالي. بعد ذلك ظهر كثيراً، في الزبداني ومضايا وحلب. وحمل مواصفات خاصة إضافة إلى طول زمنه مع حصار الغوطة، التي عانت من ذلك بعنف بالغ أوقع مئات ضحايا الجوع خصوصاً بين الأطفال. وصل سعر كيلو
الخبز مثلاً داخل الغوطة إلى إثني عشر ضعفاً من سعره في دمشق!
حالياً تقع سوريا كلّها تحت الحصار الكبير الذي يقوم به العالم للضغط على النظام وطاغيته وطغمته، والحصار الأكبر الذي ينفّذه النظام بذاته على شعبه، بالسلوك العدواني المباشر، أو بفساده وجشعه وممانعته للقرارات الدولية ولأيّ مسار للحلّ السياسي للمعضلة السورية، التي يشكّل- هُوَ هُوَ! – عقدتها الأساسية في الواقع.
لا بدّ قبل الاسترسال في هذا الموضوع، من الإشارة إلى عطب رئيس في المسألة السورية نتحمّل كلّنا مسؤوليته إلى هذا الحدّ أو ذاك، في الثورة بتحوّلاتها بعد أشهر من بدايتها، بالتساهل مع السلاح والعنف والانتقال من تبربره بالدفاع عن النفس إلى الطرب لنجاحاته؛ والاسترخاء مع الأسلمة واستسهال التحريض الطائفي وغضّ الطرف عنه أو حجبه عن الأنظار. لم يكن إلّا ذاك ناقصاً لإنجاح جهود النظام الدؤوبة، ليس لاستخدام الطائفية بتركيز خاص من قبله، بل أيضاً لإثبات ادّعائه بطائفية الحراك، وارتباطاته بالسلفية، ومن ثمّ خطورته على «الاستقرار والأمان؟» الذي يؤمّنه هو بذاته لذلك الشعب «الجاهل». لم يكن عديم الجدوى ولا مضحكاً ذلك الشعار الذي ظهر في بروباغندا النظام بتضخيم خاصّ ومركّز، على أنه من أهمّ شعارات الثوار داخل الأحياء: «المسيحية ع بيروت، والعلوية ع التابوت!».
من دون ذلك كلّه، كان من الطبيعي أن تتّخذ الأقليات- ليس بمجملها بالطبع- موقفاً متحفّظاً متخوّفاً وجاهزاً لتلقّي محفّزات القلق من أيّ طرف تأتي. كان الثوّار الأوائل أكثر وعياً ودقة وتخطيطاً، حين رفعوا شعارات الوحدة الوطنية أوّل ما رفعوا، بل كانت طاغية على كلّ الشعارات المشروعة الأخرى. كذلك كان للثوار الأوائل توجّههم اللافت إلى الأناقة والضحك في سياسة تجمع ولا تفرّق، تغري ولا ترهب.
وعلى الرغم من تحذيرات عديدة، كانت تؤكّد أن من المستحيل نجاح ثورة تعتمد على البنية والشعار الطائفيين، وأن من أهمّ مستلزمات النجاح أن يكون هنالك اهتمام يعاكس النمط السائد من استسهال الطائفية كسلاح للتحريض السريع، فيستمرّ بتركيزه بحزم على كلّ ما يجمع الطوائف، ولا يعطي المجال لاستخدامها ضدّ الثورة، أو على حواشيها الرمادية، كما كانت تُسمّى. كان ذلك سيكون استراتيجية وتكتيكاً صحيحين، علماً وفنٌّاً في الوقت نفسه.
لم تقف الأقليّات الطائفية السورية وحدها تترقّب السياق ومواصفاته، أو تنغمس في الفعل المضادّ للثورة بأشكلٍ مواربة، بل شمل ذلك أيضاً الأطراف القومية، والكردية منها خصوصاً. لتلك القومية بوصفها من المكونات المهمة حجماً ونوعاً في الجسد السوري تاريخ من الاضطهاد الذي مارسته السلطات المتعاقبة، وخصوصاً في الزمن البعثي. وانضمت قوى الكرد السياسية وشخصياتهم إلى الأنشطة المعارضة منذ ربيع دمشق، وخاضت انتفاضة مجيدة في 2004، ثمّ كانت من المكوّنات الرئيسة في الائتلاف الذي حمل اسم «إعلان دمشق» في خريف 2005. لكن تركيبة تلك الأحزاب وقضيتها الخاصة وحمولة التاريخ الكردي وتركيز السلطة عليها، جعلها دائماً متوزّعة الهوى متباينة المواقف من حيث الجذرية أو الهدوء والحكمة ما بين السلطة والمعارضة؛ كما جعلها هشّة إلى هذا الحدّ أو ذاك أمام تأثيرات وتداخلات أو ضغوطات النظام. لذلك كلّه، تأخّر بعض تلك القوى جزئياً أيضاً في الاندماج بالثورة، وتخلّف عن موقف الشباب الكردي الذي كان أكثر حماساً للانتفاض في أكثر من مكان، فقام بتشكيل تنسيقياته الخاصة أو المشتركة مع الآخرين، من عامودا في أقصى الشمال الشرقي إلى حيّ ركن الدين في قلب دمشق.
لعلّ الناحية الأكثر غرابة في مسار الثورة، هي الموقف الظاهري الذي بدا على وجوه المدن، خصوصاً في دمشق وحلب، ذلك الموقف الذي يشبه في النتيجة حذر وخوف الرأسمالي وحساباته المتأنّية. كما يشمل أيضاً موقف بعض النخبة المثقفة والمفكّرة، التي تقلق من مسارات الفوضى واحتمالاتها، ومن دون الشعبوية الذي قد يودي بمجتمع بهشاشة المجتمع السوري، ومن الانجراف بعيداً عن العقلانية وروح التقدّم. ذلك ليس بعيداً؛ في النتيجة على الأقل؛ عن دواعي تردّد الأقليّات أمام منعطفات التغيير الحادّ.
ذلك كلّه مفهوم، لا يعني أن هنالك من يألف ويقبل الظلم والمذلّة والتمييز والحرمان، بل قد يكون أحياناً شيئاً معاكساً في طبيعته، كما هو موقف كثير من الدروز والعلويين والكرد. ينطبق ذلك أكثر حين ترى كثيرين يرفضون ذلك التصنيف ويستنكرونه، ويصرّون على أن السوريين سواسية كأسنان المشط، في مواصفاتهم وانتمائهم وحصّتهم من بلدهم على الأقل.
منذ أعوام، يستغرب البعض صبر المقيمين في مناطق النظام على ما يتعرّضون له من ضيم وفاقة، لكنّه كان مفهوماً، ما لم يصل إلى الحد الحرج الذي وصل له في
العامين أو الثلاثة الأخيرة، وبالخصوص في هذا الوقت. جاءت زيادة الرواتب الأخيرة لتحسم الموقف من نوايا النظام وقدرته وتركيبته، ولتكون القشة التي قصمت ظهر البعير بصبره وجَلَده على المكاره. زادت الرواتب بمقدار الضعف، وهي نسبة خارقة للمعتاد والمفهوم أساساً، لكنّ صورة الوضع تتغيّر إذا عرفت أن هذه النسبة زادت كفاية تلبية الراتب لمتطلبات الحياة والمعيشة من يومٍ إلى يومين، أو أقلّ من ذلك على الأغلب. لقد كان الحد الأدنى للراتب يعادل ثمانية دولارات، وأصبح بالمضاعفة 16 دولاراً، قبل أن تبدأ مفاعيل الاقتصاد المنهار والنهب الهائل بتقليص تلك النسبة بطريقة درامية، معتادة ومعروفة من قبل سكان البلاد.
بحسابات بسيطة: زادت الرواتب من 120 ألفاً إلى 24- ألفاً، والدراسات تقول إن الكلفة المتوسطة للأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص تزيد عن ستة ملايين في الشهر. ما حدث كان انفجاراً من قهر وصبر مستدام جعل الدماء تفور في البنى التي قيل عنها إنها رمادية: في الجبلين، في السويداء والساحل. لم تتجدّد «الثورة السورية» بذلك الحراك المنعش كما يأمل الكثيرون. لكنّ هنالك طرقاً جديدة من الوعي والحراك تجد سبيلها للحياة، ما زالت تحتاج إلى الكثير حتى تكون قادرة على إحياء بلدٍ كاد وجهه يغيب، وكادت أقسامه الثلاثة الرئيسة في الشمال الشرقي والشمال الغربي وحيث ما زال النظام يتنفس الحياة من موت بلاده، كادت تصبح ثابتة تنتظر المزيد من التهشيم والتفتّت.
هل يستطيع سكان تلك المناطق والنازحون إليها أن يستوعب بعضهم بعضاً، ويستعيدوا ما حدث، ويستخلصوا دروساً صعبة لا يرغب الكثير منهم باستخلاصها ويستعيضون عنها بالأماني والأحلام حتى يبقى لكلّ صَوابُه الأزلي؟! هل يكفي الوقت المتاح لتفهّم أهميّة الوحدة مع الاختلاف والتعدّد، والأهميّة الحاسمة لعزل كلّ مكوّنات التطرّف والعبث والتسرّع؟! ليس هنالك إلّا القليل القليل مما يبعث على الأمل، الذي لا يكفي ولا يسكت الغربة والقهر والجوع، ولكننا محكومون كبشر بالتمسّك باحتمال ضعيف كذلك، قد يراه أولادنا. هنالك ما ينبغي للسنة والعلويين والدروز وللعرب والكرد والسريان والتركمان ولليساريين والقوميين والإسلاميين والليبراليين أن يتفقوا عليه، على جدول أعماله ومكوناته، قبل البحث عن خارطة طريق مستحيلة ووعرة.
ربّما لا تكون بدايتها معقدة كثيراً: يتشبّث الجميع بحقوقهم ويعبّرون عن هواجسهم ويطالبون بتلبيتها وتأمينها، ويتمسّكون بانتماءاتهم الثانوية بعد التسليم بأولوية الانتماء لسوريا المسكينة وليدة اتفاق سايكس بيكو، ولا يعلو على هذا الانتماء إلّا الانتماء للإنسانية، بقيمها وحقوق إنسانها بالحرية والكرامة والتنمية، ويمكن للعالم أن يساعدنا إذا قبلنا بتحكيمه وحكمته. لا بدّ في النهاية من تحية حراك أهل السويداء ومن يتضامن معها مباشرة في الجنوب أو في الشمال، ولا بدّ من الانحناء أمام الجرأة الأسطورية لأولئك الذين يعرفون أن عقابهم يمكن أن يكون أضعاف غيرهم، وهم يتحدّون أقدارهم نفسها، بعد أن لم يبق هناك ما يخسرونه. وجاء ذكر ذينك الجبلين منذ سبعين عاماً على لسان واحد من عسكر سوريا كما قيل، وهو يغادر إلى منفاه حقناً لدماء مواطنيه ورفاقه في السلاح، حين حذّر منهما وهو يختزن الغضب من معارضتهما له وتسبّبهما في سقوطه. هل يضمر هذا الكلام بعض التفاؤل؟! ليس ذلك مؤكّداً، أبداً، ولكن، لعلّ المفاجأة تأتي من حيث لم نرَ، ولا نرى في حساباتنا الباردة!