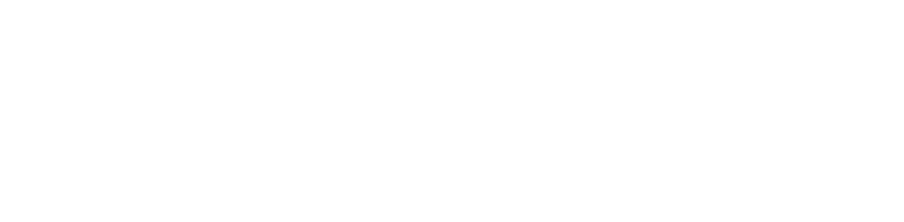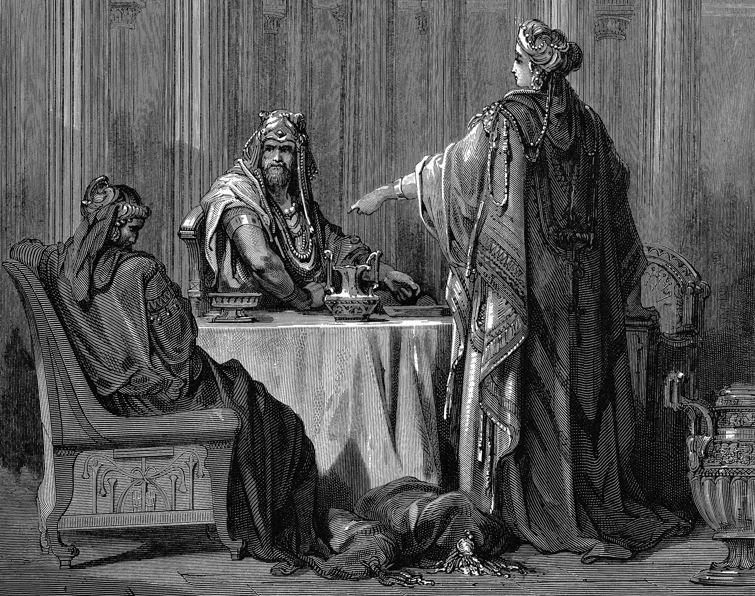محمد سامي الكيال
تنبني السياسة السورية اليوم على مفهوم لـ«الأمر الواقع» يصعب فهم نتائجه الفعلية. إذ يبدو أن مختلف الأطراف في سوريا اقتنعت أن ما يسمى الإدارة الجديدة في دمشق حازت على الدعم الإقليمي والدولي الكافي لبقائها واستمرارها. وبالتالي، فليس من الحكمة معارضتها بشكل جذري، والأجدى العمل معها نحو بناء دولة أياً كان نمطها ونظامها، ثم «العمل من الداخل» لانتزاع ما يمكن من حقوق وحريات ومنها الاعتراف القومي والإثني كما في الحالة الكردية والدرزية؛ وتخفيف الاعتداءات على الأقليات، خاصة الأقلية العلوية؛ وتحقيق بعض المشاركة في ملفات مثل العدالة الانتقالية في حالة الناشطين الذين يميلون إلى وصف أنفسهم بالمجتمع المدني، فضلاً عن مناشدة السلطة ببعض التسامح الاجتماعي والديني لتجنّب الوصول إلى حالة أفغانية.
يبدو هذا الأفق فقيراً للغاية. كما أن وصفه بـ«السياسي» إشكالي إلى حد كبير. فهو يقزّم المفهوم إلى مستوى «الدهائيات» و«الآداب السلطانية». بمعنى أن الفعل في الحيز العام يقتصر على محاولة التوصّل لمساومات الحد الأدنى مع القوة المسيطرة من طريق نوع من التعاطي المخاتل الذي يشمل التحايل والاستجداء والخطاب المزدوج. وهي مساومات ذات طابع شفوي غير معلن غالباً، ولا تُدَوَّن بوصفها حقوقاً أو قواعد ضمن أي مدوّنة منظّمة وشاملة يمكن العودة إليها؛ فيما يتحوّل النقد إلى نوع من النصائح للحاكم ومناشدته بتغيير سلوكيات وإجراءات معيّنة بناءً على الحرص عليه وعلى حكمه. تتطلّب «السياسة»، لكي تستحق هذا الاسم، وجود قوى بمفهوم واضح عن الذات الجماعية واستقلالها واختلافها وحقوقها ومصالحها؛ وكذلك مشاريع واضحة المعالم وقابلة للقياس؛ ومحاولة تأطير توازن القوى ضمن إطار مرجعي مقونن حتى لو كانت الغاية تغيير تلك التوازنات على المدى المتوسّط والبعيد؛ والقدرة على الرفض والاحتجاج الفعّال على الإجراءات السلطوية القمعية والأحادية، لا تبريرها وتزيينها أو مجرد المناشدة لتغييرها، بما يكرس أحادية السلطة والخضوع غير المشروط لها. بالتأكيد، لا توجد سياسة بلا «دهائيات». ولكن الاقتصار عليها وجعلها «الكل» في الممارسات المتعلّقة بالشأن العام، يجعلنا في شرط تحت سياسي. وهذا يحيلنا إلى التمييز الشهير بين أصل مفردة «سياسة» في العربية (الرعي، القيادة، التكليف، الأمر والنهي) والأصل اليوناني لمفردة Politics (شؤون المدن). وربما يجب الانطلاق من هذا الشرط لفهم طبيعة السلطة في سوريا ومعارضيها، أو بالأصح، ممارسي «الآداب السلطانية» فيها.
قد يكون السؤال الأهم هنا: هل التعويل تحت السياسي على قوى الأمر الواقع في سوريا لبناء دولة، ومن ثمّ التخفيف من ميلها إلى التسلّط والأحادية، عبر المناشدة أمر ممكن واقعياً؟ تتطلب الإجابة، مجدداً، اتخاذ مسافة من الدهائيات المبتذلة وما يترتب عليها من عبارات إنشائية، والنظر في الوقائع والإجراءات الفعلية القابلة للقياس والتحليل التي تتخذها السلطات الحاكمة؛ ومن ثمّ محاولة توصيف بنية تلك السلطات نفسها.
يمكن هنا تلخيص ما أنتجته سلطات الأمر الواقع، التي لم تصل إلى مرحلة نظام، في عدد من الإجراءات والوقائع، أبرزها الإطار العام للحكم وشرعيته (مؤتمر النصر، الحوار الوطني، الإعلان الدستوري، الحكومة الموسّعة)؛ وطبيعة القوى والمؤسسات الفاعلة التي تشكّل الذراع التنفيذي الضارب له (الفصائل، «المنفلتة» وغير المنفلتة؛ الوزارات السيادية؛ الهيئات الإدارية)؛ وكذلك الآليات الأساسية لعمل عنف السلطة وهيمنتها الأيديولوجية («النفير العام» كما في حالة مجازر الساحل، العمل الدعوي، الرواية المؤسِّسة للحكم). وكل هذه الإجراءات والوقائع لا تشير حتى الآن إلى أي منطق للدولة، حتى بمعايير شرق أوسطية. ولكن هل من الممكن أن تتطور مستقبلاً بهذا الاتجاه، عبر إجراءات مثل دمج الفصائل والحوكمة وإعادة الإعمار؟ هذا ما يراهن عليه كثيرون، خاصة مع ما يقال عن ضغط دولي واسع على السلطات الحالية لن يمكنها تجاهله إذا أرادت البقاء والاستمرار.
لا يمكن للضغط الدولي أن يخلق من العدم، فهو أيضاً يتعامل مع وقائع وبنى موجودة على أرض الواقع. ولذلك، فربما كانت العودة إلى الآلية والقوة والإطار هي الطريقة الأمثل لفهم الحكم الحالي في سوريا ومآلات تطوره الممكنة.
بنية «النفير العام»
يمكن اعتبار «النفير العام»، بتاريخ السادس والسابع من مارس/آذار 2025، لحظة تأسيسية للسلطة الجديدة. فبأمر «وزير الدفاع» مرهف أبو قصرة و«رئيس الأركان» علي نور الدين نعسان، ارتفعت دعوات الجهاد من سلسلة من المساجد في كثير من المحافظات السورية، لتندفع ميليشيات كثيرة نحو الساحل السوري وتسيطر بشكل كامل عليه وترتكب بعدها عمليات انتقامية ضد المدنيين لا يمكن وصفها إلا بجرائم الحرب، وفي إطار عام من الاستهداف الطائفي/الإثني قد يرقى لدرجة الإبادة الجماعية.
حققت آلية النفير مكاسب ميدانية سريعة للسلطة الحاكمة، إذ إنها استفادت من «بنية تحتية» مرنة إن صح التعبير: عشرات المساجد المتوزعة في كل مدينة وبلدة وفصائل، بل حتى أفراد متحمسون يمكن حشدهم بسرعة وتوجيههم ضد عدو داخلي لا تحتاج هزيمته لكثير من التقنية أو الاستراتيجية الحربية. في هذا النمط من المعارك، ومع هذا النوع من الأعداء، يبدو النفير آلية مثالية.
إلا أن مرونة النفير لا تقتصر على النواحي الميدانية، فهو قد يكون تعبيراً عن بنية السلطة الجديدة بأكملها، أو على الأقل العقلية التي ترتاح إليها حتى الآن وتجيد التصرّف وفقها: التنظيمات المرنة التي لا تخضع لسلطة قانون مدوّن أو إجراءات بيروقراطية محكمة أو مؤسسات ذات تقليد مترسّخ، وإنما تجمعها «روح» واحدة تنبني على أنماط معقدة من علاقات الولاء والتبعية غير المدوّنة. وكذلك، انتماء عقائدي عمومي لا يهتم بتفاصيل شرعية دقيقة بقدر اهتمامه بنصرة هوية معيّنة، بما يتضمن الدفاع عن حكمها والالتفاف حول «مظلوميتها». تؤمّن هذه المرونة قدرات كبيرة على الحشد وبناء التحالفات وتوزيع العوائد والامتيازات وحلّ الخلافات دون الحاجة لسلسلة من الهياكل التنظيمية الصلبة والصارمة التي لن تعيق حركة ائتلاف الفصائل الحاكمة فحسب بل ستغير طبيعتها نفسها، ما يجعلها تخسر كثيراً من مكاسبها ويطيح بعدد من أبرز وجوهها.
وإذا كان نموذج التحرّك الميداني، الذي عبّر عنه «النفير» هو التجسيد الأمثل للطبيعة الميليشياوية للسلطات، فيمكننا أن نرصد نماذج أخرى مقاربة في مجالات مثل الاقتصاد. فقد سيطرت هيئة تحرير الشام إبان حكمها لإدلب على القطاعات الأساسية، ومنها الطاقة والخدمات والتمويل، عبر مجموعة من الشركات «الخاصة» التي يديرها أعضاء في الهيئة ومقرّبون منها، لينشأ نوع من «القطاع السلطوي» الذي يحتكر العمليات الاقتصادية الأساسية اعتماداً على علاقات الولاء والتبعية سالفة الذكر وخارج إطار أي قانون يعتدّ به أو تشريع أو رقابة، ومع قدرة على انتزاع ملكية هذه الشركات وحلّها، ومعاقبة مديريها في حال انتهت الحاجة إليها أو تجاوزت الحد في الفساد لدرجة استفزازية. الاحتكار هنا ليس مجرّد منفعة اقتصادية للهيئة وأفراد فيها، بل أيضاً ضمان للهيمنة. وربما يكون هذا النموذج حاسماً في مستقبل إعادة الإعمار في سوريا، مع التدفّق المتوقّع للمساعدات بعد التعليق الجزئي للعقوبات. كما أن مرونته ستتيح سيطرة شاملة على كل أشكال الاستثمار والعقود المُبرمة مع الشركات الأجنبية. وأبرمت السلطات الحالية بالفعل صفقات كبيرة مع أطراف فرنسية وإماراتية وصينية بدون أي تعقيدات بيروقراطية وخارج أية إطار قانوني ناظم يمكن تتبعه، وبدون حضور سلطة تشريعية أو جهات رقابية، بل فقط بإرادة السلطة الحاكمة وتعريفها الخاص لمصالحها.
الأمر نفسه فيما يتعلّق بالتعيينات، سواء في المناصب العسكرية أو الإدارية أو حتى السياسية. فرغم الحديث المتكرر عن التكنوقراطية والحوكمة، فإننا نشهد بالفعل تعيين قادة ميليشيات شبه أميين في مناصب جنرالات ضمن «الجيش السوري» ومسؤولين يبدون أقرب لـ«الأمراء» و«الشرعيين» على رأس عدد من أهم المؤسسات، ومنها مثلاً وزارة العدل. وكل هذه التعيينات أقرب لمحاصصة فصائلية تُفرغ المؤسسات مما تبقى من مضمونها الإجرائي والتخصصي لحساب نوع من المرونة القادرة على ترسيخ سلطة بهذه المواصفات و«تَنفُر» لأجلها عند اللزوم.
قد تكون هذه البنية المرنة مضرّة على المدى الطويل للحكم الجديد حتى لو ضمنت كفاءة ميدانية معيّنة له، إذ إنها ستعرقل بناء أي شكل للدولة واحتكارها للعنف وستبقيه بصفة ائتلاف ميليشيات، ما يزيد من الفوضى والاعتداءات والجرائم الطائفية ويمنع تدفّق أية استثمارات جديّة، فيما يتجاوز أصول الدولة القابلة للرهن (الموانئ، الأراضي، المناطق الحرة، ما تبقى من بنى تحتية أساسية) ويحرج حكّام دمشق أمام حلفائهم الإقليميين. فهل يمكن لسلطة من هذا النوع تجاوز بنيتها الأساسية نحو الحوكمة القوية؟
بناء «الائتلاف السياسي»
يوجد طرح دارج حول وجود نية لدى السلطة الحاكمة، خاصة رئيسها أبا محمد الجولاني (أحمد الشرع)، بتجاوز طابعها الميليشياوي والجهادي نحو ضبط الفصائل ودمجها في مؤسسات دولة وربما الإطاحة ببعض رؤوسها. وكذلك معالجة مسألة الجهاديين الأجانب عبر إبعادهم من المناصب القيادية وتذويبهم في المجتمع السوري. أيضاً، فإن التدفقات المالية المتوقعة من الحلفاء الإقليميين ستجبر القيادة الجديدة على الحوكمة وبناء مؤسسات موثوقة ومنح بعض الحريات الضرورية في المجالات الاستثمارية والسياحية. فضلاً عن هذا، فإن إدماج الحكم في النظام الدولي سيدفعه إلى إشراك فئات من السوريين في الحكم وتنفيذ بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، ما سيساهم بالتوصل إلى حالة أقل مركزية وأكثر تشاركية.
لا يوجد ما يؤكد وجود مثل هذه النوايا. فالإجراءات التي تقوم بها السلطات واضحة للغاية منذ تعيين الجولاني رئيساً عبر «مؤتمر نصر» عقدته الفصائل، ما يجعلنا أمام ما يمكن تسميته «شرعية فصائلية»؛ مروراً بـ«الإعلان الدستوري» الذي مَركَزَ كافة السلطات بأيدي الرئيس؛ وصولاً إلى التعيينات الأخيرة في «وزارة الداخلية» وتسليم قيادة «الأمن الداخلي» في المحافظات السورية إلى ضبّاط من لون واحد تم ترفيعهم على عجل؛ وكذلك تقسيم الجغرافيا السورية إلى «قواطع» أمنية وعسكرية على الطريقة القديمة لجبهة النصرة. لقد باتت حالة الائتلاف والمحاصصة الفصائلية شديدة الوضوح فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية. فباتت «وزارة الداخلية» مجال سيطرة هيئة تحرير الشام الأساسي. أما «وزارة الدفاع»، فتُفرِد مجالاً لبقية الفصائل، ومنها فصائل «الجيش الوطني» وكذلك تنظيمات المجاهدين الأجانب. ويمكننا، خارج المنظومة الأمنية/العسكرية، وهي الأهم في أي حكم شرق أوسطي، رصد أشكال مماثلة من الائتلافات والمحاصصة التي لا يخففها تعيين بعض الوجوه المدنيّة بصفة واجهة أو ديكور للحكم الجديد. كما أن تصريحات السلطة حول الاتفاق مع «قسد»، خاصة في لقاءات ممثليها مع الجانب التركي، لا تبشّر بأي اعتراف بمبدأ اللامركزية والإدارات الذاتية.
لكي تتجاوز السلطة طابعها الميليشياوي، يجب أن تخرج من حالة «الائتلاف الفصائلي» إلى بناء أكثرية سياسية، عبر إقامة ائتلافات اجتماعية خارج الحالة الفصائلية لا تقوم فقط على إفراد مساحة للمشاركة السياسية وإنما أيضاً تمكين فئات متعددة من الاستفادة من عوائد أي إعادة إعمار مستقبلي، وتوفير مؤسسات إدارية واجتماعية وثقافية تؤمّن اندماجها في النظام الجديد بما يتناسب مع أوضاعها وتساهم في جعلها «شعب» الدولة. وكل هذا غير متحقق ولا بوادر لتحقيقه. إذ أنشأت السلطة، منذ الآن، بنية تمكّنها من الاستئثار الكامل بكل سلطة وعوائد ممكنة وتوزيع المكتسبات على الموالين لها بعد توزيعهم ضمن نوع من الهرمية العصبوية والفئوية والمناطقية. كل هذا سيشكّل، في المركز السلطوي، نمطاً من «القوة النابذة» التي تدفع غير المستفيدين من السلطة، وهم الأكثرية، إلى الأطراف، أي نحو التقوقع على الذات أو التمرّد. وهذا لا يمكن أن يكون أسلوباً لبناء دولة، أياً كان نوعها، بل سيرسّخ الحالة الميليشياوية بوصفها الطريقة الأنسب لحكّام سوريا الجدد.
تعطّل «الاندماج الاجتماعي»
يعتبر «الاندماج الاجتماعي» إحدى أهم الوظائف في أي دولة معاصرة، إذ لا يمكن في مجتمعات معقّدة وحديثة الاعتماد على البنى الأبوية التقليدية، التي توصف أحياناً بـ«العضوية»، لإعطاء توجّه وأنماط من الالتزام القانوني والأخلاقي والسياسي للأفراد والجماعات المتنوّعة. ولا بد من بناء سلسلة متكاملة من المؤسسات الوسيطة، على كل المستويات وفي كل المجالات، لضبط القنوات والأطر التواصلية والسلوكية بين الشرائح المجتمعيّة المتعددة.
في دولة حافظ الأسد، رغم توحشّها وقمعيتها، قام النظام ببناء ما يشبه ذلك النوع من المؤسسات بمعايير عالمثالثية ووفق مبدأ «الديمقراطية الشعبية» المستورد من بعض دول الكتلة الشرقية، مع تعديلات محليّة. وهكذا، تم إدماج فئات كثيرة، خاصة الفئات الفلّاحية وشبه الفلّاحية، في دولة البعث عبر سلسلة من المؤسسات الحزبية والنقابية والتعليميّة والثقافية. كما أدّى فتح مجال التطوّع والتجنّد في المؤسسات الأمنية والعسكرية دوراً في ذلك «الاندماج» ضمن دولة أمنيّة أقرب للشمولية. أنشأ نظام الأسد أكثريته الاجتماعية، التي قُدّمت بوصفها «الشعب العربي السوري»، ودمّر بذلك هيمنة بعض الطبقات الاجتماعية القديمة وأقصى مكوّنات اجتماعية عدّة ودفعها لموضع «الأقلية»، على رأسها الشعب الكردي في سوريا.
عرفت دولة الأسد التراتبية الهرمية لعصب النفوذ، بما يسود بينها من علاقات ولاء وتبعية وتوزيع معيّن للمكاسب والموارد والريوع والسلطات، ولكن تحت خطاب عابر للطائفية أساسه القومية العربية ومقاومة الاستعمار والقضية الفلسطينية. واستمر النظام قوياً باستمرار مؤسساته وهيمنة خطابه في الوسط العربي. وأدى اضمحلال تلك المؤسسات وعجز الدولة عن الاستمرار في تقديم الدعم لطبقتها الأساسية وإدماجها في أجهزتها المتضخّمة إلى انهيار النموذج الأسدي/البعثي برمته ودخول البلد في حرب أهلية لم تنته حتى اليوم.
لا يبدو الحكم الجديد في سوريا مهتماً بوظيفة الاندماج الاجتماعي، أو قادراً على فهمها أساساً، وإنما يعمل وفق منظور تحت مؤسساتي، إن صح التعبير، يهتم أساساً بإرضاء الموالين والأتباع وتأسيس منظومة أمنيّة تضمن السيطرة على الفئات غير المحظوظة وسحق أي تمرّد محتمل لها. أما من ناحية الخطاب، فلا يمكن لذلك الحكم الخروج من أساطيره المؤسِّسة، وعلى رأسها «حكم الأكثرية» و«الثورة السورية ضد حكم الأقليّة العلوية» و«مظلومية السنّة» التي ينشرها عبر شبكة من المؤثرين والناشطين. وكل هذه الأساطير ذات طابع طائفي فاقع تُقصي فئات واسعة، ليس فقط من الأقليات الدينية والإثنية، بل حتى من الأكثرية العربية السُنية التي سيتم ترتيبها وتصنيفها وفق ما يُفترض أنه دورها في «الثورة» وما قدّمته لها. كما ستعجز فئات كثيرة منها عن التماهي مع الصور الشمولية لـ«المسلمين السُنة» التي يفرضها الحكم الجديد. سنصل غالباً إلى نمط من الائتلاف الميليشياوي/الريفي، إسلامي الأيديولوجيا، الذي لن ينجح بأن يكون «أكثرية» أو يصبح وحده «الشعب».
كل هذا لن يجعل سوريا دولة. ولن يفيد في هذا السياق التعويل على الشروط الغربية. فهي متعلّقة أساساً ببعض المطالب الأمنية التي تخفف من ضرر سوريا على محيطها وتؤمّن مناطق نفوذ للدول الإقليمية المتنافسة وتتيح إدارة ملف الجهاد العابر للحدود وإعادة تدويره داخل الحدود السورية بأقل الخسائر الممكنة. أما طابع الحكم، فليس ضمن قائمة الاهتمامات الغربية، طالما ينجح الائتلاف الميليشياوي الحاكم بتأدية الوظائف المطلوبة منه.
سيبقى طابع الحكم وبنيته وإجراءاته شأناً سورياً. وربما على السوريين التفكير ملياً في مصيرهم تحت هكذا سلطة، والسعي بدورهم، قدر الإمكان، إلى تخفيف ضررها عليهم وإيجاد آفاق للحماية الذاتية وربما الانتقال السياسي نحو وضعية الدولة. ولن يكون ذلك غالباً إلا بالسعي الفعلي نحو التغيير الديمقراطي، حتى لو باتت كثير من نخب «الربيع العربي» السابقة تعتبره تقليعة قديمة.