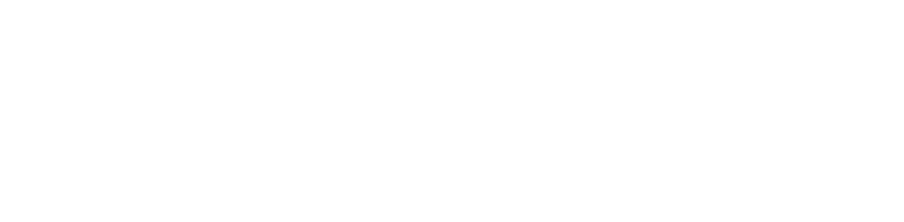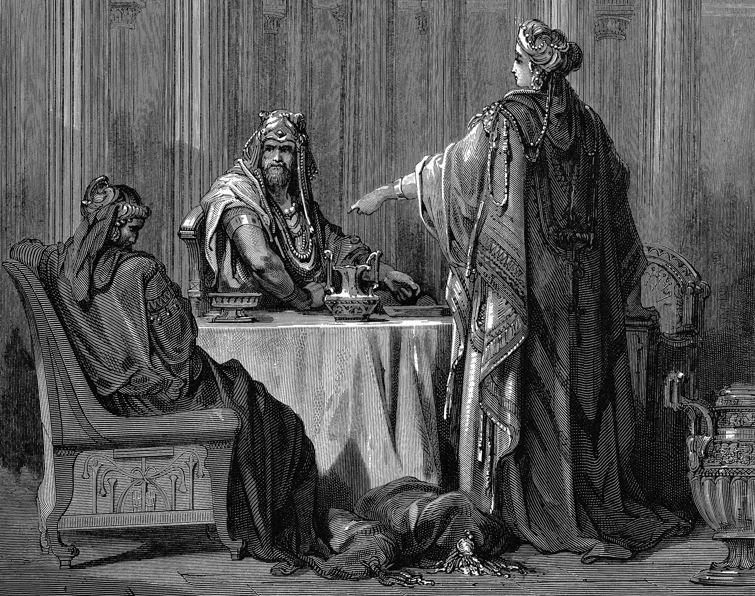محمد سيد رصاص
لا يمكن تفسير الصراعات الطائفية التي حصلت في الغرب الأوروبي بتغييب العامل الاقتصادي لها. ففي الحرب الأهلية الفرنسية 1562-1598 بين الكاثوليك والبروتستانت (الهوغنوت)، كان الهوغنوت عماد الطبقة الرأسمالية الناشئة، فيما كان الكاثوليك وهم غالبية السكان من الفلاحين الذين يدينون بالولاء للملك والكنيسة المتحالفة معه. وكانت الأرستقراطية الحليفة للملك تشعر بالعداء للرأسمالية الناشئة. وكانت الحرب الأهلية الإنكليزية 1642-1649بين تجار لندن، الذين اغتنوا من سيطرة إنكلترا على البحار بعد معركة أرمادا عام 1588 التي هُزم فيها الاسبان أمام الإنكليز، وبين الملك تشارلز الأول الذي كان يحكم بسلطة مطلقة وكان رأس كنيسة إنكلترا (الكنيسة الأنغليكانية) فيما كان التجار وغالبية اللندنيين من طائفة البيوريتان. وفي هذا الصراع، الذي طالب فيه تجار لندن بسلطة البرلمان على حساب سلطة الملك المطلقة ووجد فيه الملك قاعدة اجتماعية في الريف عند الأرستقراطية الزراعية والمزارعين الأغنياء وسواد سكان الأرياف، نجد أن شكل النزاع بين ملك وبرلمان لم يحجب شكلاً آخر له بين مدينة أصبحت عاصمة للتجارة العالمية وبين أرياف. وكان هناك أيضاً شكل ثالث للصراع بين طائفتين، حيث اختلطت الأشكال الثلاثة للصراع في تلك الحرب الأهلية.
في سوريا، لا يمكن تفسير المسألة الطائفية من دون المسألة الزراعية. فولادة الطبقة الرأسمالية السورية فعلياً كانت في فترة 1941-1945 بعد دخول القوات البريطانية من العراق وفلسطين وهزيمتها قوات حكومة فيشي الفرنسية الموالية للألمان. وتحولت سوريا بقمحها وقطنها وألبانها وأجبانها إلى المورد الرئيسي للجيوش البريطانية المقيمة ما بين العراق ومصر. وكان التراكم النقدي البدئي الذي جناه الملاكون الزراعيون الكبار، والكثير منهم من سكان المدن، هو رأس المال الذي أنشأ الصناعات السورية الكبرى خلال فترة 1945-1958 وكذلك البنوك. وكان العديد من هؤلاء ضمن قيادات الحزبين الكبيرين في السياسة السورية آنذاك، أي حزب الشعب والحزب الوطني. ولم يفكر حكام الانقلابات العسكرية من حسني الزعيم وسامي الحناوي وأديب الشيشكلي في تغيير علاقات الملكية الاقتصادية واقتصروا على الإمساك بآلة السلطة السياسية عبر الانقلاب العسكري. وبالمجمل، فإن كل من أمسك بالسلطة السياسية حتى الوحدة المصرية- السورية لم يكن له مصلحة طبقية في حل المسألة الزراعية التي كانت تجلياتها في فلاحين فقراء بموازاة ملاكين زراعيين، وفي تفاوت النمو والحداثة بين الريف والمدينة، ثم ثالثاً في ما يقوله نيكولاس فان دام، بأن «البعد الطائفي للانقسام الثنائي الريفي- المديني في سوريا جدير بالملاحظة، فبينما تتركز الأقليات الدينية المتماسكة أساساً في المناطق الريفية الفقيرة المحرومة، نجد أن المناطق الأكثر ثراء والمدن الأكبر يهيمن عليها سنيون» ( الصراع على السلطة في سورية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1995، ص51).
استند حزب البعث في صعوده لقاعدة اجتماعية ريفية في أرياف الساحل وحماة وحمص وحلب وإدلب وديرالزور وفي حوران وجبل العرب، إضافة لقاعدة قوية في بلدات صغيرة (مثل السلمية)، فضلاً عن وجود قوي في أحياء شعبية بالمدن مثل حي الشيخ ضاهر باللاذقية. وكان له وجود قوي بين الطلبة في الثانويات والجامعات ليس فقط من أبناء الأرياف بل من فئات اجتماعية مدينية وسطى وفقيرة. ولم يكن صعود البعثيين فقط عبر المد العروبي الذي نشأ بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، بل أساساً من إمساكهم بالمسألة الزراعية، وهذه نقطة قوتهم، بينما كانت نقطة الضعف الكبرى للحزب الشيوعي السوري. وإذا كان حزب البعث حل نفسه من أجل الوحدة مع مصر، فإنه من المؤكد أنه كان يفكر آنذاك في حل المسألة الزراعية السورية، كما فعلها ضباط سلطة 23 يوليو في مصر وأغلبهم ريفيون. وعندما أراد حكم الانفصال الارتداد على الإصلاح الزراعي الذي قام به الرئيس جمال عبدالناصر في سبتمبر/أيلول 1958، فإن هذا كان دافعاً رئيسياً لدى الضباط في اللجنة العسكرية البعثية، وأعمدتها الثلاثة من الريف وهم محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد، للقيام بانقلاب 8 مارس/آذار 1963، وإن كان دافع شركائهم الناصريين إعادة الوحدة.
إن انقلاب 8 آذار حركة انقلابية للجنة العسكرية البعثية بالتعاون مع الضباط الناصريين، ولم تكن تعلم به قيادة حزب البعث، باستثناء ميشيل عفلق وصلاح البيطار. وفي الفترة الفاصلة عن 18 يوليو/تموز 1963 عندما قام الناصريون بحركتهم الانقلابية الفاشلة، كان العسكريون البعثيون أمسكوا بمفاتيح السلطة «والقوة الحقيقية الحاكمة هي حزب البعث العسكري» (منيف الرزاز: التجربة المُرة، دار غندور، بيروت 1967، ص95) و«كان عليهم أن يجعلوا حزب البعث حزبهم هم» (الرزاز، ص109). وفعل صلاح جديد هذا عبر انقلاب عسكري في 23 فبراير/شباط 1966 ضد القيادة القومية، ثم فعلها حافظ الأسد بقوة المؤسسة العسكرية في انقلاب 13-16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 عندما أطاح بسلطة صلاح جديد بعد أن أصدر مؤتمر حزب البعث قراراً بإقالة وزير الدفاع حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس من منصبيهما.
ولكن إذا كانت «القوة الحقيقية الحاكمة هي حزب البعث العسكري»، فإن أعمدة هذا الحزب الثلاثة كانوا ريفيين ومن الطائفة العلوية، وهم محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد. وتاريخ سوريا منذ 8 مارس/آذار 1963 وحتى الآن، رُسم عبر هؤلاء الثلاثة من خلال اجتماعهم واختلافهم وصراعهم أثناء هذا المسار وفي مفاعيل ونتائج هذا المسار. واستطاع هؤلاء الثلاثة، من خلال مراكز تسلموها، تركيز السلطة في أيدي اللجنة العسكرية البعثية (محمد عمران: اللواء سبعين، صلاح جديد: نائب رئيس شؤون الضباط ثم رئيس الأركان، وحافظ الأسد من قائد قاعدة الضمير العسكرية إلى قائد القوة الجوية). وبالترافق، فإن التسريحات من الجيش بعد 8 مارس/آذار كانت لضباط سنة من مدن دمشق وحلب وحمص، وكذلك بعد حركة 18 تموز كانت لضباط ناصريين أيضاً من السنة. ولقد «تم استبدال نحو نصف عدد الضباط المسرحين والبالغ عددهم حوالي 700 بعلويين» (فان دام: ص82). كان هذا في ما بعد 8 مارس/آذار، ثم كانت الوتيرة نفسها بعد 18 يوليو/تموز، وكذلك ما بعد حركة 23 شباط 1966 حيث كان كل الضباط المسرّحين من أنصار القيادة القومية (ماعدا علي مصطفى) من السنة.
إن هؤلاء الثلاثة، وفي اعتقاداتهم الأيديولوجية، لا يميلون للتفكير الديني. وفي سلوكهم الاجتماعي، لم يكونوا طائفيين. ولكنهم من أجل الحفاظ على سلطتهم الجديدة ذات القاعدة الاجتماعية الضعيفة، ولحمايتها من السقوط ومن تربص الخصوم، لجؤوا إلى شيء قريب لما تحدث عنه ابن خلدون في مفهومه حول العصبية وذلك من خلال شرحه لقيام سلطات دول جديدة حول عصبة محددة للإمساك بـ«الشوكة»، مثل دولة الموحدين 1121-1269 التي اعتمدت على البربر وليس على العرب في المغرب الأقصى. وحتى حافظ الأسد، في انقلابه على صلاح جديد، اعتمد على بقايا ضباط محمد عمران الذي أطيح به كوزير دفاع عام 1966 إضافة إلى «ضباطه الخاصين» بعد أن أحكم سيطرته على الجيش منذ عام 1968. وثلاثتهم، حينما كانوا معاً، أمسكوا بمفاصل القوة العسكرية في صيف 1963. وفي مرحلة 23 فبراير/شباط إلى سبتمبر/أيلول 1966، قام جديد والأسد بتصفية الضباط الدروز من المراكز الرئيسية والحوارنة ما بين فبراير/شباط 1968 وأغسطس/آب 1968 بعد إبعاد رئيس الأركان أحمد سويداني من منصبه وبعد محاولته الانقلابية الفاشلة. وأثر مؤتمر حزب البعث القومي في سبتمبر/أيلول 1968، وضحت سيطرة الأسد على الجيش بمواجهة التنظيم الحزبي. وفي فبراير/شباط 1969، قام ببروفة انقلاب سيطر من خلالها على الإذاعة وصحيفة الثورة. وكان من نتيجة ذلك انتحار رئيس مكتب الأمن القومي عبد الكريم الجندي. لم يلجأ الثلاثة لأكثر من وضع علويين في المفاصل الرئيسية للجيش. وعندما كان أحدهم يفقد السيطرة على هذه المفاصل، كان يخسر. وهذا ما حصل مع عمران بين ديسمبر/كانون الأول 1964 وفبراير/شباط 1966، ومع جديد بين سبتمبر/أيلول 1968 ونوفمبر/تشرين الثاني 1970. وعملياً، كانت السلطة لمن يسيطر على الجيش، وهو ما أدى إلى انتصار الأسد في نهاية المطاف.
ولكنهم لم يقيموا حكماً طائفياً أوحكماً لطائفة، بل استخدموا الطائفة العلوية للسيطرة على مفاصل الجيش. ومن خلال هذه العملية، حكم الثلاثة. ومن خلالها، أبعدا عمران، ثم أُبعد جديد من قبل الأسد. وعملياً، كان حكماً للجنة العسكرية بثالوثها ثم لاثنين منها ثم لواحد. ولم يكن حافظ الأسد الأول بين الحاكمين بل الحاكم الأوحد والوحيد، والبقية أدوات أو معاونين، حيث يكبر الواحد من هؤلاء ويصغر ضمن دائرة الأداة أو المعاون. ومن حاول أن يتجاوز هذه المعادلة، تم إبعاده. وذلك ما حصل لرفعت الأسد عام 1984 وعلي حيدر عام 1994. ولكن لم يتجاوز حافظ الأسد معادلة أن تكون «العصبة العلوية» مسيطرة على الجيش وأيضاً الأمن بعد 1970. ويمكن للوضع عام 1983 أن يعطي صورة عن ذلك: الفرقة الأولى: إبراهيم صافي، الفرقة الثالثة: شفيق فياض، الوحدات الخاصة: علي حيدر، سرايا الدفاع: رفعت الأسد، الدفاع الجوي: علي الصالح، الاستخبارات العسكرية: علي دوبا، الاستخبارات الجوية: محمد الخولي، الاستخبارات السورية في لبنان: غازي كنعان، وفرع الأمن الداخلي: محمد ناصيف، وهو مسؤول عن أمن دمشق وتقييم موظفي الدرجة الأولى والتنسيق الإداري بين إدارة المخابرات العامة وفروع أمن الدولة.
من جهة أخرى، أدرك حافظ الأسد بعد انفراده بالسلطة أن الحكم لا يقام بالضد من تجار دمشق والمؤسسة السنية الدينية ممثلة في دائرة الأوقاف المشرفة على الجوامع وممتلكات الوقف وفي دائرة الإفتاء التي كان شيخها منذ عام 1964 أحمد كفتارو، شيخ الطريقة الصوفية النقشبندية، في حين امتد كذلك إلى شيوخ أشعريين مثل محمد رمضان البوطي وسلفيين وقفوا معه أثناء وبعد المجابهة المسلحة مع جماعة الإخوان المسلمين. وعملياً في فترة حكمه وابنه حتى السقوط نهاية العام الماضي، حُكمت سوريا عبر ثالوث تحالفي من ضباط علويين يسيطرون على مفاصل الجيش، وتجار وصناعيين أغلبهم من السنة، وشيوخ السنة.
الفرق بين حافظ الأسد وابنه أن الأخير مارس علونة الوظائف المدنية عبر إمساك علويين بمفاصلها، كما في وزارة الإعلام والتلفزيون والبعثات الدبلوماسية ومؤسسة الخطوط الجوية والبعثات الدراسية في الخارج. وكذلك مارس علونة الوظائف بأكثرية عددية، كما في مدينتي اللاذقية وحمص. الفرق الآخر في عهد بشار أنه في محاولته لبرلة الاقتصاد منذ عام 2004 أطاح عملياً بالفئات الوسطى وأنزلها لخط الفقر. كما أنه دمر الزراعة. واجتمعت معه في عملية التدمير هذه موجة الجفاف التي أصابت سوريا ما بين عامي 1996و2011، فيما اصطفت الأرياف مع والده في أثناء مجابهته الإسلاميين بين عامي 1979و1982، والتي كانت مستفيدة من إجراءات الإصلاح الزراعي في زمني الوحدة والبعث، مقابل مساندة قاعدة اجتماعية كبيرة الإسلاميين في مدينتي حلب وحماة آنذاك. بينما يمكن القول عملياً إن ما جرى من انتفاضة- ثورة ضد حكم بشار الأسد منذ عام 2011، كان مستنداً أساساً في قاعدته الاجتماعية على الريف السني أو على الأحياء المهمشة في المدن التي قطنها ريفيون نزحوا بين 2008-2011 بعد خراب الزراعة، وهذا ما يفسر قوة التنظيمات السلفية- الجهادية التي هي ذات قاعدة ريفية وليست مدينية، بخلاف جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما نلاحظه في مصر أيضاً.
كانت مرحلة مارس/آذار 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 كاشفة للوحة السورية، حيث وقف أغنياء السنة ومشايخهم مع بشار الأسد، الذي ساندته أغلبية كاسحة من العلويين والمسيحيين، بينما انقسم الدروز والإسماعيليين، في حين وقف الكرد في إجماع لافت ضده. وفي المقابل، تمركزت القاعدة الاجتماعية الكبرى ضده في الريف السني والأحياء المهمشة من المدن التي يقطنها السنة. وفي تلك المرحلة، لم يكن الصراع طائفياً بحكم وقوف أغنياء السنة ومشايخهم مع السلطة. ولكن استعانة بشار بالجيش وأجهزة الأمن، حيث يسيطر العلويون على مفاصلها، والمليشيات المحلية، وأغلبيتها العددية من العلويين، إضافة لاستعانته بمليشيات شيعية لبنانية وعراقية وأفغانية، فضلاً عن مستشارين عسكريين إيرانيين، لوّن الصراع السوري والصراع على سوريا والصراع في سوريا بالكثير من الملامح الطائفية، خاصة أن الكثير من المجازر ارتكبت ضد مدنيين من السنة. كما أن الغالبية العظمى من القتلى المدنيين كانوا من السنة. وينطبق الأمر ذاته على المعتقلين والمغيبين والنازحين واللاجئين والبيوت والممتلكات التي دُمّرت بحكم القصف المدروس بالطيران والبراميل المتفجرة والصواريخ، إذ أن الأغلبية العظمى كانت هويتها سنية.
كتكثيف: يمكن القول إن المسألة الطائفية نتجت عن انتقال الحكم في 8 مارس/آذار 1963 من مدينتي دمشق وحلب إلى الريف. ونتجت تلك المسألة الطائفية عن عدم حل المسألة الزراعية. وفي مجابهة 1979-1982، حاول الإخوان المسلمون تطييف الصراع مع السلطة دون أن ينجحوا بحكم وقوف تجار دمشق ومشايخها مع حافظ الأسد وكذلك وقوف الريف السني معه، رغم الامتعاض الاجتماعي الواسع من سيطرة العلويين على المؤسسة العسكرية الذي بات ملموساً حينها. وحتى ما بعد مارس/آذار 2011، لم يأخذ الصراع شكلاً طائفياً بحكم انقسام السنة على أسس طبقية بين معارض وموال ومتردد. ولكن ممارسات السلطة وقمعها وميليشياتها وقواتها الحليفة، تركت مرتكسات طائفية كبيرة. وفوجئ كثيرون أن هذه المرتكسات لم تتحول إلى اعمال عنف انتقامية بعد سقوط بشار، بل انتهجت السلطة الجديدة سياسة غير انتقامية، وكذلك فعل المتضررون والناقمون على النظام السابق. وعلى الأرجح، أن حركة 6 مارس/آذار، وكذلك الشريط المفبرك لشيخ درزي، قصد منهما إشعال حريق طائفي ليس إلا، أولاً: عبر مجازر ضد قوات الأمن العام تقود لمجازر انتقامية من مدنيين علويين، إذ أن القوات التي قامت بتلك الحركة لم تكن بعديد وتسليح كاف للسيطرة على مساحة جغرافية من الساحل، وثانياً: عبر إشعال حمية سنية من خلال ذلك الشريط المفبرك من أجل ارتكاب مجزرة سنية ضد الدروز لقطع الطريق على مبادرة من السلطة الجديدة في دمشق تجاه إسرائيل أثناء زيارة أعضاء من الكونغرس الأميركي قبل أيام قليلة من ذلك الشريط المفبرك. ولكن من خلال هذين الحدثين ومن خلال المجازر التي حصلت ضد مدنيين علويين في الساحل من قبل مسلحين محسوبين على السلطة الجديدة، وبعضهم غير محسوب، يمكن القول إن هناك مسألة طائفية في سوريا. وحل هذه المسألة يكون عبر طريقين لا ثالث لهما، إما المواطنة المتساوية لجميع السوريين في الحقوق والواجبات، أو «دولة مكونات». والحل الأخير سيكون الإسلاميون أكثر المسرورين به، حيث سيقولون وقتها بتوزيع المناصب والوظائف حسب النسبة العددية بعد إجراء إحصاء عام للطوائف والأديان والقوميات. ولكن طريق «دولة المكونات» سيجعل السوري فرداً في جماعة وليس مواطناً في مجتمع.