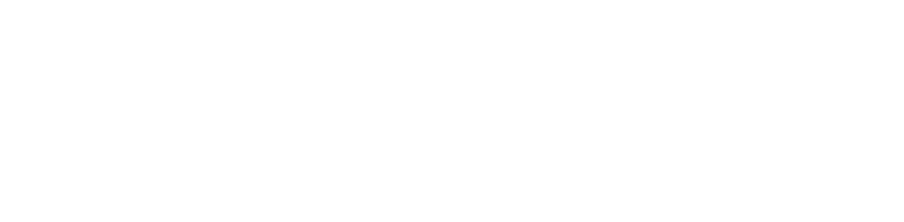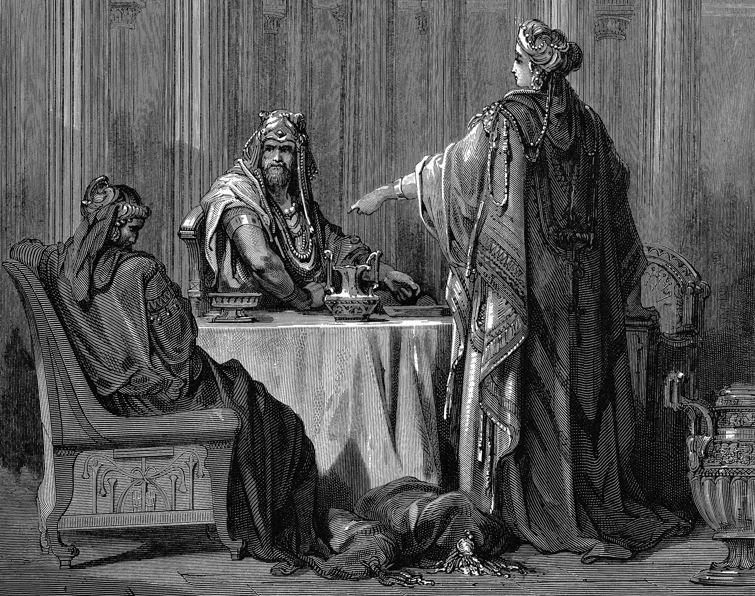سوار ملّا
ليس في حياة سرّي ثريا أوندر تلك البدايات البطولية التي تُنسج عادةً في سير الشخصيات العامة. لم يكن هناك ما يشير إلى مصير استثنائي ولا ما يوحي بأن الطفل القادم من أعماق الأناضول سيصبح ذات يوم رمزاً لمواجهة السلطة. في الواقع، لم يكن في تلك البداية ما يلفت الانتباه؛ مجرد حكاية فتى نشأ لعائلة كادحة في الريف المنسي على هوامش الجمهوريّة الحديثة. لكن الحياة أحياناً تزيح الستار عن أناس عاديين، لتتركهم في العراء وجهاً لوجه مع التاريخ.
في يوليو/تموز 1962، وُلد «الأخ سرّي»، كما يحلو لمحبّيه مناداته، في أديامان، جنوب شرق البلاد، في بيت صغير لا يملك من الحظ سوى كدّ الأب في صالون الحلاقة وجهد الأم في المنزل.
رحل والده حين كان في الثامنة، تاركاً خلفه أول ندبة في حياة سرّي، كأنها إشارة مبكرة لجراح ستتوالى. بدت الفجيعة آنذاك أكبر من أن تُفهَم، لكنّها واظبت على تعليمِ قلبِه كيف يغدو أقسى مما تطيقه الطفولةُ. انتقلت الأسرة إلى كنف الجد، وكان عليه أن يستوعب مبكّراً درس الفقد.
لم يترك الأب وراءه سوى اسم وذكرى وبيئة اجتماعية قريبة من حزب العمال التركي «TIP»، لكنه ترك أثراً عميقاً سرعان ما سيتجلّى في دأب سرّي على الإنجاز وانحيازه للضعفاء والمسحوقين. وكأي طفل فقير في الأناضول، انخرط سرّي مبكراً في العمل، متنقلاً بين ورش صغيرة أبرزها ورشة تصوير فوتوغرافي. يقضي نهاره بين العمل والمدرسة وأمسياته قارئاً ما تيسّر من أدبيات سياسية، ماركسية في الغالب.
انخرط في السياسة كمن ينخرط في قدر لا مفر منه. إذ كانت السياسةُ هناكَ أشبه بالنهرِ الذي يجرفك في طريقه، لأنّها السؤال الأوّل والإجابة الأولى عن أحوالِ الناس وحيواتهم. كان والدُ سرّي ناشطاً بارزاً في صفوف اليسار الأناضوليّ وأحد مؤسّسي فرع حزب العمال التركي في منطقته. لذا، كان محيطهم الاجتماعيّ مسيّساً إلى أقصى حدّ. ولم يكن غريباً أن يجد الفتى نفسه في الصفوف الأولى خلال الاحتجاجات على مجزرة مرعش ضدّ العلويين عام 1978. وبالكاد كان بلغ السادسة عشرة حين اعتُقل للمرة الأولى، لتصبح تلك الحادثة علامةً فاصلةً في ذاكرتِه ومسار حياته.
بعد إتمامه للمرحلة الثانوية، التحق عام 1980 بكلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة. بدا كأنه يحاول ترميم أفق جديد، لكن انقلاب 12 سبتمبر/أيلول من العام ذاته قلب المسار رأساً على عقب. في سنته الدراسيّة الثانية، وجد نفسه مجدداً في مرمى السلطة بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للانقلاب. وصدر بحقه حكم بالسجن اثني عشر عاماً، قضى منها سبع سنوات في سجون ماماك وأولوجانلار وهايمانَه.
كان الألم هناك روتيناً لا يرحم؛ التعذيب خبز يومي، والعزلة رفيقٌ دائم لا يغادرُ القلب والجسد. لكن شيئاً في داخله ظل صامتاً ومتيقظاً كأنه يراقب الألم عن بعد، رافضاً أن ينكسر تحت وطأته. كانت سنواته السبع خلف القضبان درساً قاسياً في الصمود أمام القدرِ وتحمُّل الألمِ.
فيما بعد، لخّص تلك التجربة بعبارة آسرة: «هناك، تعلّمت جغرافيا الألم».
بعد خروجه من السجن عام 1987، وجد نفسه في عالم بلا ملامح. وكان عليه أن يلتقط ايقاعها. تنقّل بين أعمال مؤقتة: عامل يومي، سائق شاحنة، عامل موسمي. بدا كمن يجرّب الحياة دون أن يجد موطئ قدم ثابت. لكن هاجس تحويل الألم إلى فعل حيّ مُقاومٌ ظل يرافقه كظلٍّ لا ينفكّ عنه.
في مطلع الألفية الجديدة، التقى في ورشةٍ سينمائية بالمخرج باريش بيرهاسان، فكان اللقاء الذي سيغيّر وجه حياته. في عام 2006، قدّم فيلمه السينمائي الأول «بين-المِلَل» بالتعاون مع محرّم غولمز. العمل تراجيديا سياسية ساخرة تروي قصة فرقة موسيقية في بلدة نائية تُجبر على عزف مقطوعة موسيقية خلال زيارة رسمية في ظل سلطة عسكرية قمعية. لكن بدلاً من المعزوفة الاحتفالية المنتظرة، عزفت الفرقة – دون قصد – «نشيد الأممية»، مما أدى إلى اتهامهم بالترويج للشيوعية واعتقالهم. كان الفيلم بوحاً شعرياً عن سنوات العسفِ، واحتجاجاً على النسيان الذي بدا يتسرّب للحياةِ العامّة بعد البحبوحة النسبيّة في سنوات حزب العدالة والتنميّة الأولى. نال الفيلم الجائزة الكبرى في مهرجان ألتن كوزا السينمائي. وبدا ذلك بمثابة تأكيد على أنّ هذا الرجل لم ينكسرِ رغم المرارات التي ذاقها. ومن حينها، بات حضوره في المجالِ العامّ واقعاً لا يمكن تخطّيه.
في عام 2012 ساهم في إخراج فيلم «F Tipi» الذي يكشف عن الحياة اليومية في زنازين العزل بالسجون التركيّة من نوع «F» المعروفة بظروفها القاسية. كان الفيلم من عدة مقاطع لعدّة مخرجين وثّقوا العزلةَ التي تلتهم السجناء هناك من الداخل والخارج.
أما فيلمه اللاحق «لديّ اعتراض» (2014)، فتتمحور حبكته حول الإمام سلمان بولوت، إمام أحد مساجد إسطنبول، الذي تنقلب حياته فجأة عندما يُقتل أحد المصلين داخل المسجد أثناء الصلاة. وفيما تتعامل الشرطة مع القضية ببرود، يقرّر الإمام سلمان، بطبعه الهادئ ونزعته نحو الحقيقة، أن يأخذ على عاتقه مهمة التحقيق. خلال بحثه، يجد نفسه محاصراً بتحديات معقدة تجرّه إلى مواجهة إرثه الشخصي وأسئلته الكبرى حول الإيمان والعدالة، مما يضعه أمام تساؤلات جديدة عن مكانة الدين في المجتمع. هذا الفيلم يجسّد المشروع السينمائي لدى سرّي ثريا أوندر: مزيج ذكي بين النقد الاجتماعي العميق والفكاهة السوداء، دون أن يتخلى عن بعده التحرري الذي يفرض نفسه ببساطة ودون ادّعاء. يستخدم أوندر الفكاهة السوداء كأداة لفتح الأسئلة الكبرى حول العدالة والإيمان والمجتمع.
إلى جانب نشاطه السينمائي، كان سرّي ثريا أوندر حاضراً بانتظام في الصحافة اليسارية التركية. منذ مطلع العقد الثاني من الألفية، بدأ ينشر مقالات أسبوعية في صحيفة «راديكال» قبل أن ينتقل إلى الكتابة في «بيرغون» و«بيانات». تميّزت كتابات سري ثريا أوندر بالجمع بين الحكاية الذاتية واللغة الأدبية والتحليل السياسي. انشغلت كتاباته بمفهوم «تدمير الذاكرة» بوصفه أداة للهيمنة، داعياً في المقابل إلى «تذكّر تضامني» يقاوم استحواذ السلطة على السرديات الجماعية.
مع دخوله البرلمان، فضّل أوندر الابتعاد عن الكتابة الصحافية، التزاماً منه باستقلالية الصحافة واحتراماً لمبادئها. لكن خطابه السياسي لم يخلُ من أثر أسلوبه الأدبي والفني. بقيت لغته، رغم رسميتها البرلمانية، تحمل نبرة شعبية مثقفة تجمع بين البساطة والتهكم، كأنها تجسّد مفارقة حية بين لغة الناس ولغة السلطة. لم يكن أوندر مجرد سياسي يتلو بيانات. كانت كلماته أشبه بمحاولة للقبض على الواقع دون الوقوع في فخ المباشرة. كثيراً ما كان يستحضر الشعراء والأفلام والأساطير في كلماته وحواراته، مما أضفى على لغته طابعاً تأملياً يحررها من ثقل الخطاب السياسي المباشر ويمنحها بُعداً يلامس وجدان الناس.
مع انحراف المناخ السياسي في البلاد نحو الاستبداد، أدرك سرّي أن الكلمات وحدها لم تعد تكفي. لا سيما حين بدأت تركيا، منذ عام 2009، تشهد توسعاً متسارعاً في نفوذ السلطة على الإعلام والقضاء والمؤسسات التعليمية. وتراجعت تدريجياً الآمال التي رافقت السنوات الأولى لحكم حزب العدالة والتنمية، حين كانت الديمقراطية حديث المرحلة، لتحل محلها نزعة تسلطية تقوم على استفراد الحزب بالمؤسسات وتحويلها إلى أدوات طيّعة في خدمته.
مع إحكام السلطة قبضتها على المجال العام، وجد المثقفون اليساريون أنفسهم في مواجهة سؤال ملح: هل الانسحاب من الحياة العامة هو الرد المناسب على تآكل المساحات الحرة؟ أم أن الانخراط والمواجهة المباشرة هما الخيار الوحيد؟ انحاز سرّي، كعادته، للخيار الأكثر شجاعة وضرورة: المواجهة المباشرة.
لم يكن دخول البرلمان بالنسبة لسرّي طموحاً شخصياً ولا مساراً مهنياً؛ إنما فعلاً من أفعال المقاومة المدنيّة الممكنة. فقرر خوض الانتخابات مرشحاً مستقلاً ضمن لائحة «كتلة العمل، الديمقراطية والحرية» – وهو تحالف يساري دعمه حزب السلام والديمقراطية (BDP).
كان لترشحه في إسطنبول دلالة مزدوجة: مخرج سينمائي غير كردي يساري اجتماعي، يضع نفسه في خدمة النضال الكردي. اختار أن يكون صوتاً في معركة لا تخصه إثنياً، لكنها تعنيه إنسانياً وسياسياً. خطوة غير يسيرة في السياسة التركية، لكنها كانت منسجمة مع قناعته بأن التضامن لا يتوقف عند حدود الهوية بل يصنع هويات تعددية أشد تماسكاً.
نجحت المحاولة. فاز سرّي بمقعده، ودخل «مجلس الأمة الكبير» نائباً لا يهادن في معارضته للأحادية المتجذرة في بنى الدولة ومؤسساتها.
لاحقاً، انضم أوندر إلى حزب السلام والديمقراطية، وسرعان ما أصبح صوتاً بارزاً يجسّد ضمير المثقفين في اليسار التركي والكردي على حد سواء. بحضوره الهادئ ولغته التي تجمع بين النقد الجذري والبساطة المؤثرة، صار يمثل تلك الفئة التي ترفض الانعزال وتبحث عن العدالة عبر توسيع دوائر الحوار.
فيما بعد، خاض تجربة جديدة عندما ترشّح لمنصب رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، الذي كان تأسس حديثاً ليعبّر عن تيار يساري متعدد الثقافات. لم يحالفه الحظ في الانتخابات، لكن ترشحه كان بمثابة زلزال في الوعي السياسي لسكان المراكز الحضرية. للمرة الأولى، تطرح بهذه الصورة فكرة تركيا يسارية تعددية تتجاوز الانقسامات التقليدية. كان ترشحه إعلاناً عن مشروع سياسي جديد يرى في التنوع قوّة، وفي الحوار وسيلة لمواجهة تكلّس السلطة.
شكّل مايو/أيار 2013 نقطة تحوّل حاسمة – لتركيا ولسِرّي ثريا أوندر على حد سواء. اندلعت احتجاجات «منتزه غيزي» إثر محاولة هدم رقعة خضراء صغيرة في ساحة تقسيم بإسطنبول. لكن هذه الشرارة سرعان ما تحولت إلى انتفاضة شعبية واسعة ضد القمع وعنف الشرطة وهيمنة النزعة القومية-الدينية على المجال العام. كان أوندر من أوائل من وصلوا إلى الميدان، مدفوعاً بحسّ التضامن والشعور بأنه من الناسِ وعليه أن يكون بينهم.
في مشهد أيقوني سيظل حاضراً في الذاكرة، حين زحفت الجرافات لهدم المنتزه، وقف سرّي في وجهها بجسده بلا خوذة أو درع. لم تكن تلك الوقفة موقفاً سياسياً بحتاً، بل حضوراً مكثفاً لإنسان أعزل يواجه آلة السلطة بجسارة لا تحتاج إلى شعارات. أصابته قنبلة غاز مسيل للدموع، جُرح، لكنه ظل واقفاً، مؤكداً حضوره كصوت لا يساوم ولا ينحني. تحولت هذه الوقفة إلى رمز لسياسة أخرى: جريئة، شفافة، متجذرة في الشارع. كثيرون ممن فقدوا الثقة بالمعارضة التقليدية وجدوا في سرّي صوتاً أخلاقياً لا يشبه إلا نفسه لكنه يعبر عنهم.
من داخل البرلمان، استثمر أوندر موقعه النيابي ليتحدث باسم المتظاهرين، مندداً بالقمع، مطالباً بالعفو، وداعياً إلى صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمواطن. لم يكن خطابه شعبوياً أو استعراضياً؛ كان يحكي ويقصّ سير الناس وأحوالهم ويوظف الأمثولات والاستعارات بأسلوب يكاد يكون روائياً؛ كان يعرف أن السياسة التي لا تروي حكايات الناس لا تلامس وجدانهم.
في العام ذاته، انخرط سِرّي ثريا أوندر في مبادرة استثنائية في المشهد السياسي التركي: «مسار دولمه باغجه»، حين بدأت حكومة رجب طيب أردوغان – الذي كان رئيساُ للوزراء آنذاك – حواراً غير مباشر مع حزب العمال الكردستاني (PKK) بقيادة عبد الله أوجلان، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع المسلح بين الدولة التركية والحركة الكردية المسلحة. كان أوندر، إلى جانب بروين بولدان وإدريس بالوكين، عضوا في «لجنة إمرالي» البرلمانية التي تولّت دور الوسيط بين الطرفين المتنازعين، حاملاً رسائل من أوجلان، مشرفاً على قنوات التواصل غير الرسمية، وساعياً لبناء الثقة المتبادلة بين جانبين لطالما فرقتهما المعارك والدماء.
خلال احتفالات نوروز 2013 في ديار بكر، صعد أوندر إلى المنصة أمام مئات الآلاف وتلا رسالة أوجلان التي أعلن فيها مبادرة السلام بين الكرد والجمهورية. بدت تلك اللحظة لكثيرين كأنها بداية عهد جديد. لم يظهر أوندر حينها كقائد حزبي أو ناطق باسم أيديولوجيا جامدة، إنما جسراً حياً يمتد بين ضفتين كانتا على وشك التباعد إلى نقطة اللاعودة، حاملاً في صوته نبضاً يعيد للذاكرة العامّة إمكان اللقاء.
لكن التطورات السياسية في السنوات التالية بددت كل تلك الآمال. فبعد انهيار محادثات السلام في 2015 وتصاعد العنف في مدن مثل جزير وسور، ثم محاولة الانقلاب في 2016 والتحول نحو النظام الرئاسي الأحادي، بات واضحاً أن الطريق الذي بدت ملامحه ممكنة انسد بالكامل، وأن مشروع السلام لم يعد سوى ذكرى باهتة وسط واقع يزداد رماداً.
لم تكتف السلطة بإغلاق آفاق المصالحة، بل عمدت إلى إحكام قبضتها على المجال السياسي. عشرات من قادة حزب الشعوب الديمقراطي زُجّوا في السجون. في عام 2018، صدر حكم بالسجن على سرّي ثريا أوندر بسبب خطاب ألقاه عام 2013 في ذروة عملية السلام. كان الحكم إعلاناً واضحاً بأن العدالة تحولت إلى أداة انتقام، وأن القانون الذي كان يُفترض أن يحمي مساحة الحوار صار سلاحاً يُصوّب نحو من حاولوا التفاوض. ورغم أن المحكمة الدستورية ألغت الحكم لاحقاً، إلا أن الرسالة وصلت: صار الحوار جريمة، وصار الذين حاولوا بناء الجسور متهمون بنسفها.
بالنسبة لأوندر، لم يكن ذلك مجرد إخفاق سياسي؛ كان مأساة تعيد الدولة إلى سردياتها القديمة. وعبّر عن ذلك لاحقاً بالقول: «كانت بين أيدينا لحظة تاريخية، لكن ذاكرة هذا البلد مُسِحت من جديد».
لكنه لم ينكفئ. في عام 2023، قرر الترشح مجددًا، هذه المرة باسم «حزب المساواة وديمقراطية الشعوب» (DEM) الذي ورث مشروع حزب الشعوب الديمقراطي (HDP). فاز مرة أخرى بمقعد برلماني، وانتُخب نائباً لرئيس البرلمان – منصب رمزي في مؤسسة تهيمن عليها عقلية الأغلبية. بقي سرّي كما كان: وسيطاً يجمع بين وضوح الموقف ورهافة الحضور وعنصراً يربك المعادلة السياسية التي تُديرها سلطة اعتادت على الامتثال.
مع مطلع عام 2025 ومع انطلاق جولة جديدة وسرية من المحادثات مع عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، عاد أوندر ليكون جزءاً من وفد الوساطة. كان حضوره في تلك اللحظة علامة على إصراره الذي لم ينكسر رغم الجراح، كأنه يراهن على أن هذه المحاولة قد تكسر دورة الانسداد وتمنح التاريخ فرصة للخروج من متاهته.
التقى بالرئيس أردوغان وشارك في مشاورات مغلقة، ساعياً لإعادة فتح لغة سياسية أغلقتها المراسيم والمحاكم. كان يراهن على إمكانية إحياء حوار تلاشى في ظل المناخ السياسي المأزوم.
لكن الجسد الذي أنهكته الندوب لم يعد يقوى على مواصلة الحمل. في 15 أبريل/نيسان 2025، تعرض لتمزق في الشريان الأبهر، ليسقط ذلك الجسد الذي واجه الجرافات بلا درع. دخل في غيبوبة، ظل فيها معلقاً بين الحياة والموت لأسابيع، بينما القلوب المفعمة بالدعاء تنتظر معجزة لم تأتِ.
في الثالث من مايو/أيار 2025، توقف قلب سرّي ثريا أوندر في إسطنبول. لم تكن المدينة غريبة عنه. كان يعرفها كما يعرف جسده المرهق؛ يعرف كيف تستعيد إيقاعها بعد كل مواجهة وكيف تلتقط أنفاسها حين يثقلها الحزن. كانت لحظة ثقيلة، كأن السياسة نفسها توقفت لوهلة. انتشر خبر رحيله في أنحاء البلاد، ولم يقتصر الحزن على الكرد أو اليسار؛ كان غيابه فادحاً، إذ بدا أن شيئاً كان يضبط إيقاع البلاد اختفى دون سابق إنذار.
مات سرّي. لكن سيرته بقيت حيّة تروي كيف أن مقاومة القمع لا تكون بمجاراة منطقه بل بالتمسك بالذاكرة كخط دفاع أخير أمام الطمس. لم يكن سرّي ثريا أوندر بطلاً أسطورياً، بل إنساناً عاديّاً واجه القمع كما يواجه الطفل غياب والده: بحزنٍ عنيد. كان يُدرك أن المعارك لا تُكسب دائماً، لكن التراجع عنها يعني انتصار النسيان.
لكن الناس لم ينسوه. ما زالت أفلامه تُعرض ونصوصه تُقرأ وخطاباته تُستعاد كلما حاول أحدهم استعادة ملامح السياسة حين تجمع بين الفكرة والكرامة. غاب الجسد، لكن الأثر ظل حاضراً يذكّر بأن السياسة ليست مجرد إدارة قوة، بل إبقاء الروح يقظة، رغم كل ما يثقلها. كان يقول دائماً: «أسوأ ما قد يصيب بلداً ليس الظلم، بل النسيان».