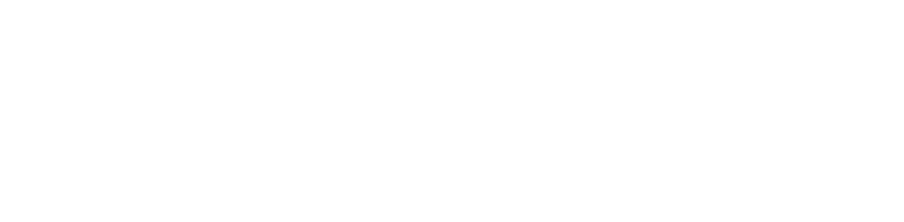خالد المطلق *
تتمتع سوريا بأهمية جيوسياسية وتاريخية عميقة في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما شكل التفاعل المعقد والمتداخل بين السياسة والعقيدة الدينية حجر الزاوية في تكوين الدولة السورية الحديثة ومسار تطورها المضطرب، فسوريا عبر التاريخ كانت أرضاً خصبة نمت فيها جذور عميقة لتفاعل السياسة والعقيدة. هذه الجذور مرت بأربع محطات رئيسية، أولها سوريا القديمة. في هذه الفترة المبكرة قبل الأديان السماوية الكبرى كانت المعتقدات الدينية أشبه بقواعد أساسية للمجتمع، ولم تكن مجرد عبادات شخصية، بل كانت تحدد كيف يعيش الناس، من يحكمهم، وكيف تُدار الأمور. غالباً ما كان يُنظر إلى الحاكم على أنه شخص مبارك أو مرتبط بالآلهة، ما يعطيه سلطة خاصة. أما في الحقبة الإسلامية ومع انتشار الإسلام، أصبح الدين الإسلامي قوة مركزية في سوريا، ولم يعد مجرد عقيدة، بل أصبح جزءاً من ثقافة وهوية الناس. فالأنظمة التي حكمت سوريا في هذه الفترة استمدت قوتها وشرعيتها من الإسلام، وكانت القوانين والأعراف متأثرة بالدين، وساهم الإسلام بشكل كبير في تشكيل الهوية السورية التي نعرفها اليوم. وفي فترة الحكم العثماني عندما حكم العثمانيون سوريا لقرون طويلة، اتبعوا طريقة ذكية للتعامل مع التنوع الديني والعرقي سموها «النظام المللي». ببساطة، سمحوا لكل مجموعة دينية (مثل المسلمين والمسيحيين واليهود) بإدارة شؤونها الخاصة المتعلقة بالأمور الشخصية (كالزواج والطلاق) من خلال قادتهم الدينيين. حافظ هذا النظام على نوع من السلام، لكنه أيضاً رسخ فكرة وجود هويات دينية منفصلة داخل المجتمع. أما في مرحلة الانتداب الفرنسي، بعد الحرب العالمية الأولى وسيطرة فرنسا على سوريا، أثرت سياساتها الاستعمارية بشكل كبير على التوازنات الدينية والسياسية. في هذه الفترة، ظهرت أيضاً حركات وطنية تسعى للاستقلال كانت تضم أشخاصاً من مختلف الخلفيات الدينية، ما أضاف بُعداً جديداً للعلاقة بين الدين والسياسة في إطار النضال من أجل الوطن. باختصار ومن خلال هذه المحطات الأربع، يتضح أن العلاقة بين الدين والسياسة في سوريا لها تاريخ طويل ومعقد تغيرت طبيعتها وتأثيرها عبر الزمن، ما ساهم في تشكيل الوضع الحالي.
الدولة السورية الحديثة
حاولت سوريا بعد الاستقلال البدء في رحلة بناء دولة حديثة، لكنها واجهت تحدياً كبيراً وهو كيف نوحد شعباً متنوعاً دينياً وعرقياً تحت راية واحدة؟. والحقيقة أنه بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، واجهت سوريا صعوبة في بناء هوية وطنية موحدة. كان التنوع الديني والعرقي موجوداً بقوة، وكان التحدي هو كيف نجعل جميع هذه المجموعات تشعر بالانتماء إلى سوريا كوطن واحد بدلاً من التركيز على هوياتها الخاصة؟ وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة «القومية العربية» كحل محتمل للوحدة. وكانت هذه الفكرة تحاول بناء هوية مشتركة على أساس اللغة والتاريخ والثقافة العربية بدلاً من الدين. وفي البداية، كان للقومية العربية تأثيرات كبيرة، إذ حاولت أن تقلل من أهمية الانتماءات الدينية والإثنية في السياسة. وعندما وصل حزب البعث إلى السلطة، كانت لديه أيديولوجية قومية اشتراكية علمانية (غير دينية). في البداية، حاول البعث أن يقلل من دور الدين في الحياة العامة والسياسة، لكن مع مرور الوقت بدأ الحزب في استخدام الدين بشكل انتقائي أو براغماتي لتحقيق أهداف سياسية، مثل تعزيز الوحدة الوطنية أو كسب تأييد بعض الفئات. كان لهذه السياسات تأثيرات على التوازنات بين المجموعات الدينية والمذهبية المختلفة في البلاد. وكرد فعل على سياسات الدولة التي قد يعتبرها البعض تهميشاً للدين أو تقييداً للحريات الدينية، بدأت تظهر وتتطور حركات إسلامية في المجتمع والسياسة. وسعت هذه الحركات إلى إعطاء الدين دوراً أكبر في الحياة العامة وفي صنع القرارات السياسية، وأصبحت قوة مؤثرة بشكل متزايد. وباختصار، نجد أن محاولة بناء دولة سورية حديثة وموحدة واجهت تحدي التنوع، مع صعود القومية العربية التي حاولت تقديم حل علماني، لكن في النهاية تصاعد دور الدين (العقيدة) في السياسة السورية، سواء من خلال استخدام الدولة له أو من خلال ظهور حركات إسلامية.
العقيدة كأداة للصراع والتعبئة
في كثير من الأحيان يتحول الدين إلى سلاح يُستخدم في المعارك السياسية. ومن خلال الطائفية السياسية، نجد أنه بدلاً من أن تكون الانتماءات الدينية والمذهبية مجرد جزء من هوية الناس، تم استغلالها في الصراعات
السياسية. بمعنى آخر، استخدمت بعض الأطراف انتماء الناس إلى طائفة معينة لكسب التأييد ضد طائفة أخرى أو لتبرير أعمال العنف والتمييز. يسمى هذا الاستغلال للانتماءات الدينية «الطائفية السياسية». كما أن دور الخطاب
الديني في تأجيج الأزمات له تأثير كبير في التعبئة وإثارة الصراعات من خلال بعض القادة أو الجماعات الذين يستخدمون اللغة الدينية بطريقة تثير الفتنة والكراهية بين الناس. وبدلاً من أن يكون الدين مصدراً للسلام والتسامح، تم استخدامه لتعبئة الأنصار ضد «الكفار» أو «الضالين» أو «الأعداء» الذين ينتمون إلى طائفة أخرى. ساهم هذا النوع من الخطاب الديني المتطرف في تأجيج الأزمات وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات دينية.
أيضاً، هناك العوامل الإقليمية والدولية التي لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات العقدية من خلال تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوري، ودعمت في كثير من الأحيان أطرافاً بناءً على انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية. وزاد هذا الدعم الخارجي من حدة الانقسامات الطائفية وعمقها، وحوّل الصراع إلى ساحة لتنافسات إقليمية ودولية ذات أبعاد طائفية. وتحول الصراع السياسي في الثورة السورية إلى حرب أهلية مدمرة لعبت الطائفية والعقيدة فيها دوراً واضحاً، ولم يعد الصراع مجرد مطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، بل اتخذ أبعاداً طائفية وعقائدية، حيث قاتلت مجموعات تنتمي إلى مذاهب أو تفسيرات دينية مختلفة ضد بعضها البعض، وأصبح الانتماء الديني في كثير من الأحيان سبباً للاستهداف والعنف. باختصار، بات واضحاً كيف تحولت العقيدة في سوريا من مجرد إيمان شخصي إلى أداة قوية تُستخدم في الصراعات السياسية لتعبئة الناس وتأجيج الكراهية وتعميق الانقسامات الطائفية، خاصة في ظل صراع مسلح تدخلت به قوى خارجية كثيرة.
محاولات تجاوز الانقسام وبناء دولة مدنية
بعد سنوات من الصراع وسقوط نظام الأسد، تحاول سوريا بناء مستقبل جديد يتجاوز الانقسامات. ولهذا، لابد من بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الخيار المصيري:
1- مبادرات الحوار والمصالحة: يجب بذل جهود حثيثة لمحاولة جمع السوريين من مختلف الخلفيات معاً للحوار والتفاهم، والهدف هو بناء جسور من الثقة والمصالحة بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري، سواء كانت دينية أو عرقية أو سياسية، والتوصل إلى حلول سلمية للمشاكل.
2- أهمية فصل الدين عن الدولة: فكرة أساسية تُطرح هي ضرورة بناء دولة مدنية أو علمانية. وهذا يعني أن تكون المؤسسات الحكومية والقوانين محايدة ولا تفضل ديناً أو مذهباً معيناً على آخر، والهدف هو ضمان حقوق جميع المواطنين بالتساوي، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو غير الدينية. بمعنى آخر، أن تتعامل الدولة مع جميع المواطنين كمواطنين أولاً وأخيراً.
3- تحديات بناء دولة مدنية شاملة: الطريق نحو بناء دولة مدنية في سوريا ليس سهلاً ومليء بالعقبات. وهناك تحديات داخلية، مثل عمق الانقسامات والثقافة الطائفية التي ترسخت خلال الصراع، بالإضافة إلى تحديات خارجية تتعلق
بتدخلات القوى الإقليمية والدولية وأجنداتها المختلفة. ويتطلب بناء الثقة وتحقيق المصالحة وتغيير العقليات وقتاً وجهداً كبيرين.
4- نماذج مقارنة: للنظر إلى المستقبل بتفاؤل يجب أن يتم استعراض تجارِب دول أخرى حول العالم نجحت في إدارة التنوع الديني وبناء دول مدنية مستقرة. يمكن لهذه التجارب أن تقدم دروساً وأفكاراً لسوريا حول كيفية التعامل مع التنوع وبناء نظام سياسي واجتماعي عادل ومستقر للجميع.
في الختام، توضح الرحلة عبر تاريخ سوريا شيئاً مهماً: العلاقة بين السياسة والدين (العقيدة) كانت دائماً معقدة ومتداخلة وتركت بصمات واضحة على كل مراحل تطور البلاد، إذ أثرت على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، وحتى حقوق الناس وحرياتهم. الدرس الذي يجب تعلمه من هذا التاريخ هو أن بناء مستقبل مستقر لسوريا يتطلب فهماً عميقاً لهذا التفاعل. ولتجاوز التحديات الحالية، من الضروري السعي نحو دولة تحترم تنوع شعبها وتضمن حقوق الجميع بغض النظر عن معتقداتهم. ولتحقيق ذلك، يتوجب التركيز على الحوار الوطني الشامل وبناء مؤسسات قوية وعادلة تفصل بوضوح بين الدين والدولة وتطوير مناهج تعليمية تعزز التسامح والمواطنة المشتركة. وبالنظر إلى المستقبل، لا شك أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، لكن هناك أيضاً فرصاً لبناء دولة جديدة تقوم على العدل والمساواة واحترام التنوع. وعلى الرغم من أن الطريق طويل وصعب، لكن الأمل يظل معقوداً على جيل جديد من السوريين قادر على بناء مستقبل أفضل. ويمكن القول إن فهم العلاقة بين السياسة والعقيدة أمر بالغ الأهمية لفهم حاضر سوريا ومستقبلها. وتبقى هناك العديد من الأسئلة التي تستحق المزيد من البحث والدراسة، من قبيل: كيف يمكن بناء دولة سوريّة تحترم التنوع الديني وتفصل بين الدين والدولة بشكل يضمن حقوق جميع المواطنين؟ وما هي العوامل الداخلية والخارجية التي ستشكل مستقبل هذه العلاقة في سوريا؟
*خالد المطلق: كاتب وباحث سوري في الشؤون العسكرية والأمنية والإرهاب.