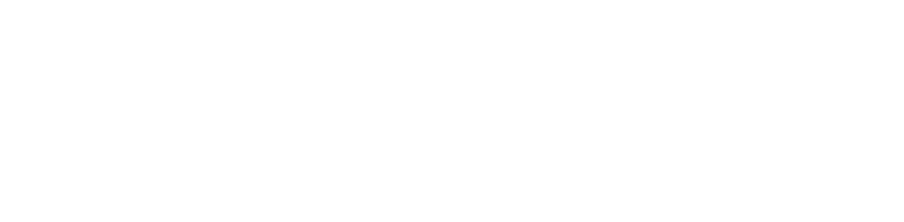عقيل سعيد محفوض
في مفارقة لافتة، لاحظ سياسي سويدي التقى لاجئين عراقيين فرّوا من حكم صدام حسين، أنهم، ورغم اختلافهم الجذري في كل شيء تقريباً، السياسة والدين وأنماط العيش وغيرها، إلا أنهم يتفقون على أمر واحد يكاد يكون ثابتاً: وجود البامية على موائدهم جميعاً! هذا التوافق اللافت دفع السياسي السويدي، كما ذكر عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار[1]، إلى اقتراح وضع صورة البامية على العلم العراقي! ويمكن أن ينسحب الاقتراح على “الملوخية” للمصريين، و”القات” لليمنيين، و”الكسكس” لشعوب المغرب. أما السوريون، فيبدو أن اختلافهم يطال حتى ألوان الطعام، كما يختلفون في كل شيء تقريباً! وهم ليسوا استثناءً، إذ ليس من السهل أن تتفق مجتمعات هذا المشرق الجميل على شيء، حتى لو كان طعاماً[2].
الطعام: هوية، ذاكرة، وسلام؟
إذا ما أقدم العراقيون أو غيرهم على مثل هذه الخطوة، كلٌ حسب وجبته المفضلة، فلن يكونوا السبّاقين في جعل النبات رمزاً وطنياً. فثمة مجتمعات ودول أخرى زيّنت أعلامها وعملتها برموز نباتية راسخة: شجرة الأرز تتربع على علم لبنان، وورقة القيقب الأحمر ترفرف في العلم الكندي، بينما يتجلى نبات الأقحوان في الشعار الوطني لليابان. ولن ننسى فروع وأوراق شجرة البلوط مع الجوز في الوسام الوطني لبلغاريا، أو نبات الغار الذي يعتلي شعارات دول كالأرجنتين واليونان والسلفادور وغيرها.
إن المقترح السويدي يفتح باباً واسعاً للتساؤل: هل يمكن للطعام أن يكون أداة للسلام الاجتماعي؟ فكما أن البيتزا تجسد الروح الإيطالية، والكيمتشي يعكس الهوية الكورية بعمق يتجاوز كونه مجرد طبق، فإن البامية بالنسبة للعراقيين تحمل في طياتها أكثر من مجرّد مذاق. إنها ترتبط بالذاكرة الجماعية، بذكريات الطفولة، بلمّة العائلة في المناسبات الاجتماعية، تلك الروابط الدافئة التي تبقى حيّة بمعزل عن الانقسامات السياسية الطاحنة. فهل يمكن لـ”مهرجان البامية” أو “يوم الملوخية” و”شيخ المحشي” أن يجمع الناس حول مائدة واحدة، رغم تباين توجهاتهم واختلاف ولاءاتهم؟ وماذا عن دور الطعام كجسر للوحدة في دول عانت من صراعات عميقة، كجنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، حيث ساهمت رموزٌ ثقافية مشتركة في رأب الصدع؟
الدولة المنهكة: فشل المشاريع الكبرى وبقاء الرموز البسيطة
لكن المسألة بالنسبة للعراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس ولبنان وسائر المجتمعات والبلدان في الإقليم المشرقي الجميل، تتجاوز مجرّد المشترك في أنماط الغذاء لتمتدّ إلى مشتركات أعمق بكثير في أنماط القيم، وطرق العيش، والفضاء الحضاري والتاريخي الواسع. غير أن هذه المشتركات كلها باتت تحت إجهاد هائل، وفي حالة مواجهة مستمرة منذ عقود، لدرجة أضحى من الصعب الحديث عن فكرة مجتمع متماسك أو أفق مجتمعي واضح، خاصة في لحظات النزاع والحرب الطاحنة. وتتخذ سوريا في ذلك مقاماً متقدماً بسبب حالة التطييف القاتلة فيها.
يبدو السوريون والعراقيون والليبيون والسودانيون وغيرهم اليوم مجرّد وقائع وتسميات وألوان وخرائط وأعلام لا تبرّر وجودها بذاتها، ولا بما هي شعوب متّحدة أو مجتمعات بالمعنى الذي تعرفه العلوم الاجتماعية والبلدان الديمقراطية، بل بما هي ساحات للصراع والموت الأسود باسم المقدس والملّة والغنيمة! إنها شعوب ومجتمعات مستباحة، من الداخل والخارج، تعيش تراجيديا دائمة تتوالى فصولها، ولا يلوح في أفقها سوى العنف والموت، وبالطبع الهجرة واللجوء لمن تسنى له ذلك.
لكن، هل يُعدّ اللجوء إلى رموز بسيطة كالبامية دليلاً على فشل النخب السياسية في بناء هوية وطنية جامعة؟ أم هو إقرار ضمني باليأس من المشاريع الكبرى، سواءً كانت قومية أو دينية، التي كانت تُفترض يوماً كركيزة للهوية؟ وهل يعكس هذا الوضع كيف ساهمت عوامل تاريخية كالاستعمار والكراهية والتعصب والاستبداد في تفكيك هويات كانت أكثر تماسكاً، ليصبح الطعام أحد الروابط القليلة المتبقية؟
يحيلنا هذا الواقع إلى إشكالية أعمق في سوسيولوجيا الرموز: فتحوّل البامية أو غيرها من ألوان الطعام إلى ملاذ هوياتي يعكس – بحسب تحليل يستند إلى أفكار إرنست غيلنر (Ernest Gellner) – أزمة النخب في إنتاج رموز حديثة جامعة[3]، وأزمة عميقة في نظم القيم في مجتمعات (أو ما يعد مجتمعات) يتلازم فيها الدين (الطائفة أو الملّة) مع الاجتماع (القبيلة، العشيرة) والسياسة (السلطة) والاقتصاد (الريع) بشكل “شبه جوهراني”، لا فكاك منه أو له. ولكنه يحيل -بالمقابل، وفي هذا نوع من الاستدراك على ما قلناه للتو- إلى ما يسمّيه ميشيل دو سارتو (Michel de Certeau) بـ”تكتيكات الحياة اليومية” التي يمكن أن تشكّل احتمالات نسبية لـ”هويات بديلة”، تتجاوز البُنى الفوقية التي تفرضها الخطابات الرسمية وشبه الرسمية[4]. هذا ما يعبّر عنه بيير بورديو أيضاً عبر مفهوم “الهابيتوس”، حيث تتشكّل الهوية لا كمعطى جوهري، بل كنتيجة تفاعلية بين البُنى والممارسة[5].
البامية: نقطة التقاء أم مجرّد مفارقة؟
عودة إلى البامية. إنها جديرةٌ حقاً بأن تكون رمزاً وطنياً، وربما قومياً ومشرقياً بامتياز. يتناولها (ويحبّها) العرب والترك والفرس والكرد، المسلمون والمسيحيون واللادينيون، ومختلف المذاهب والطوائف والقبائل والجماعات والأفراد. تجدها على موائد شتى الشرائح الاجتماعية والطبقية، في المدن والأرياف، داخل أسواق المدن وخارجها، في القصور الفاخرة وفي أحزمة البؤس وأحياء السكن العشوائي.
يقول ثربانتس: “لم أجد حبّاً أصدق من حبّ الطعام”[6]، فهل يؤدي التقاء الناس على حبّ شيء – حتى لو كان بامية! – إلى توافق ضمني بأنهم يحبّون أو يفضّلون أمراً ما، أو أنهم لا يختلفون في كل شيء، وبالتالي، هل يمكن النظر إلى ما يحبّون، من طعام أو شراب أو غيره، بوصفه “نقطة التقاء” حقيقية على مستوى الوطن؟
الواقع أن التفكير في البامية أو أي أمر مشابه كرمز وطني ينطوي على نوع من المفارقة البلاغية والرمزية العميقة، خاصة بالنسبة لأصحاب المقولات والسرديات الكبرى، الذين يفكرون في أوضاع المنطقة انطلاقاً من مرجعيات فكرية وتاريخية ذات طابع إمبراطوري، دينياً أو قومياً. وشعوب تمجّد العنف والحرب والقتل والموت تحت عناوين كبرى. لكنها تعيش في الواقع أحوالاً من الانقسام والتشتت والفساد والتأخر التنموي واستبداد واستباحة الإنسان، والاندفاع للقتل الطائفي أو السكوت عنه أو تبريره..إلخ. فهل يُعقل – من هذا المنظور – أن تفكر في نبات أو شراب كرمز لأوطان ومجتمعات ودول، تاركة خلفها البطولات والمعارك والملاحم التاريخية العظيمة؟! أم أننا نُجمّل الانهيار وهستيريا القتل والموت والاستباحة بطبخ جماعي؟
مقارنات ومرارة الرموز
لنقم بـمقارنة – قد لا تكون موفقة بنظر كثيرين- بين البامية ورموز أخرى: لماذا نجحت شجرة الأرز اللبنانية كرمز للبنان رغم انقساماته العميقة؟ هل لأنها مرتبطة بالطبيعة والجغرافيا والتراث الأسطوري العتيق (كالأساطير الفينيقية)، لا باليومي المتغير والقابل للهضم حرفياً كوجبة الطعام؟ وهل أن شجرة الأرز رمزٌ يوحّد لبنان أم أن لكل شجرته وأرزته؟!
هذا يكشف الفارق – وأرجو ألا يذهب ذهن القارئ بعيداً- بين الرموز “الطبيعية” التي تعلو على الزمن، وبين الرموز “الطبخية” العابرة. وهل يصحّ أن تُختزل شعوب عريقة في أطباق طعام، مثل البامية أو الملوخية أو شيخ المحشي، بينما تُختزل شعوب أخرى في رموز ذات مهابة كالدب الروسي والنسر الأمريكي والنمر الهندي والتنين الصيني؟ ومن يقرّر “جدية” الرمز؟ ولماذا يُستهان بالطعام بينما يُبجّل الحيوان أو الشجرة كرموز وطنية؟ في هذا الاختزال ما يبعث على السخرية اللاذعة والتساؤل: هل من السذاجة الاعتقاد بأن الطعام قد يوحد ما لم توحده قرون من التاريخ والثقافة؟ فشجرة الأرز اللبنانية، على جلالها، لم تمنع حرباً أهلية دموية، وقد لا تمنع اللبنانيين من حروب أخرى، كما أن “البامية” و”شيخ المحشي” لم يمنعا السوريين من أهوال الحروب والقتل والتهجير التي هم فيها اليوم.
الطعام والهجرة: حنين وجسر
إننا أمام ظواهر ووقائع تحرّكها دوافع مخيالية وعاطفية وقيمية مختلفة، تتمركز حول القبيلة أو الطائفة أو المنطقة أو العرق أو العصبة أو الجماعة، وليس المجتمع أو الوطن والدولة بالمعنى الحداثي للكلمة. هذه الدوافع هي ما يدفع الأطراف للتنازع والصراع، تنازع ومصارعة عشاق ومحبّين لأنفسهم وأنواتهم وما يخصهم، وكارهين لكل ما يمثل تهديداً أو مجرّد اختلاف، لتكون السلطة هي الغنيمة والوطن هو الضحية!
يكتسب الطعام، في سياق الهجرة واللجوء، بعداً إضافياً. لماذا يصبح طبق طعام جزءاً لا يتجزأ من هوية المغتربين؟ إنه ليس مجرد وجبة، بل حنين للأرض التي فرّوا منها، والناس الذين هربوا منهم أو انقطعوا عنهم، والذكريات التي تتطلب الكثير من النسيان حتى يتهذب ما فيها من صور سوداوية وأوجاع؛ وقد يكون الطعام أو “ذاكرة الطعام” أو “المشترك الطبخي”، إن أمكن التعبير، هو الجسر الأخير الذي يربط بين الأجيال المهاجرة ووطنهم الأصلي، ناقلاً لتراث شفوي وحسي عبر المحيطات.
وفي الختام،
هل الطعام كافٍ لبناء وطن؟ وهل يستطيع “قرن البامية” أو “شجرة الأرز” أو “القات” أو “الملوخية” أو “شيخ المحشي” أو “التوت الشامي”، في حال توافق السوريون على اعتباره رمزاً مشتركاً، أن يفعل – ويبدو أننا نكرّر هنا- ما لم تستطعه قرون عديدة من التاريخ المشترك، وكل المشتركات الأخرى في الثقافة والجغرافيا والحضارة، بين شعوب المنطقة، وداخل كل منها؟
صحيح أن طعم البامية جيد، ومثلها “التوت الشامي” وغيره، وهذه أمور نسبية على أية حال ولا إكراه فيها، إلا أن المهمة الملقاة على عاتقها تبدو ثقيلة بعض الشيء! وربما كانت البامية، ليس طعمها أو مذاقها، بل هشاشتها، هي ما يجعلها ملائمة لتمثيل أوطاننا: طرية، تتفكك سريعاً إن زاد الغليان، لكنها تبقى على موائد الجميع. وقد يكون درس البامية الأهم أن المشتركات لا تُصنع بالأطباق وحدها، بل بالاعتراف بأن المائدة الواحدة تتسع لأكثر من طبق، وأن الوطن الحقيقي هو الذي يترك لمواطنيه حرية اختيار الكيفية التي يُعدّون بها باميتهم.
هوامش:
[1] فالح عبد الجبار، “بناء أو تفكك العراق في إطار نظريات سوسيولوجيا القوميّات والأمم”، محاضرة في نادي الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، (17 آذار/مارس 2017). وانظر كلام رفعت الجادرجي عن البامية في: رفعت الجادرجي، حوار في بنيوية الفن والعمارة، (بيروت: دار الريس للكتب والنشر، 1995).
[2] نشر الكتاب صيغة أولى من النص قبل عدة سنوات، وبدا له أن من المناسب إعادة النظر فيما كان وتعميقه وإعادة تقديمه للقارئ بـ”نكهة” و”مذاق” جديدين!
[3] Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Cornell University Press, 1983.
[4] de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. University of California Press, 1984.
الترجمة العربي: ميشيل دو سارتو، ابتكار الحياة اليومية، ترجمة وتعليق وتقديم: محمد شوقي الزين، (الجزائر: منشورات الاختلاف، 2011).
[5] بيير بورديو وجان-كلود باسرون، إعادة الإنتاج: في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة: ماهر تريمش، مراجعة: سعود المولى، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007).
[6] يتكرّر ذكر أو نسبة هذه العبارة لـ ثربانتس، لكنها ليست موجودة حرفياً أو بشكل مباشر في مؤلفاته. ومن المحتمل أنها اقتباس حرٌ أو إعادة صياغة لمعنى مستخلص أو مُؤوّل ضمن “دون كيخوته”، حيث توجد إشارات عديدة لحب الشخصيات للطعام، خاصة شخصية “سانشو بانثا”، مرافق “دون كيخوته”، المعروف بشراهته وحبه للطعام.