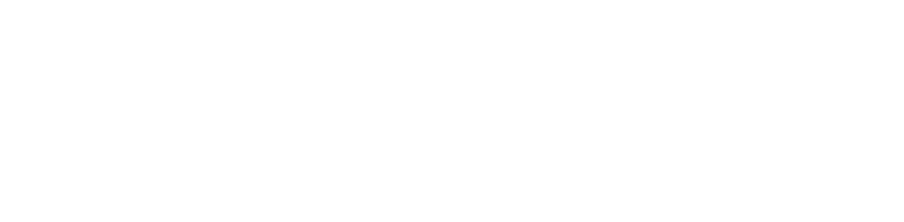محمد سيد رصاص
لم يكن هناك من جار صديق لجمهورية مصطفى كمال عند ولادتها عام 1923. ويبدو أن رئيس الوفد البريطاني في مؤتمر لوزان ووزير الخارجية اللورد كرزون تقصد ذلك عندما سمح، وهو القابلة القانونية للدولة الجديدة، بأن يكون المولود الجديد غير مماثل لمولود معاهدة سيفر قبل ثلاث سنوات. وعلى الأرجح، أن الأمر تجاوز إبعاد الأتراك عن الفرنسيين في سوريا والبلاشفة في روسيا بعد أن قلقت لندن من معاهدتي مصطفى كمال مع الفرنسيين والروس قبل سنتين، ليصل لدى البريطانيين إلى زرع جسم تفجيري آخر في المنطقة على طراز ما جرى وخطط له في لندن قبل ست سنوات عبر وعد بلفور.
فمصطفى كمال كان يحمل إرثاً تركياً من الدم مع الأرمن واليونانيين. أما بلغاريا، فولدت من خلال ثورة على العثمانيين، في حين كانت ولادة دولة الفرس الصفوية بمثابة المدخل إلى صدام مع الدولة العثمانية في معركة جالديران عام 1514 استغرق قرنين من الزمن. أما الكرد، فشعروا بخيانة مؤسس الدولة التركية عندما جعلها ذات طابع قومي تركي ولم يقبل بثنائية الشراكة التركية- الكردية التي أوحاها أثناء ثورته ضد قوات الاحتلال متعددة الجنسيات بين عامي 1919 و1922، فيما توجس العرب منه وهو الوريث للمقولة التركية بأن «العرب طعنوا الترك بالظهر» عبر ثورة الشريف حسين بن علي عام 1916 وهو من طرح «الميثاق الملي» في 1920 الذي يقول بادعاءات جغرافية تمتد من البحر المتوسط إلى حدود بلاد ما بين النهرين مع بلاد إيران. وفي معاهدة لوزان، بقيت مسألة الموصل قائمة. وفي المعاهدة، طالب الأتراك بوضع إداري وثقافي خاص للواء إسكندرونة في مقدمة لسلخه عن سوريا لاحقاً في 1939 بعدما اشترت باريس ولندن حياد أنقرة في الحرب مع الألمان. ثم حاول الأتراك مقايضة سلخ منطقتي حلب والجزيرة في مايو/أيار 1941 عندما احتاج أنصار جمهورية فيشي الفرنسية الموالية للألمان، وكانوا يسيطرون على سوريا ولبنان، إلى السماح لقطارات دعم فرنسية وألمانية للفيشيين بالمرور عبر الأراضي التركية وسط الحصار البحري البريطاني، وهو ما رفضه الماريشال بيتان (ميشيل كريستيان دافيه: «المسألة السورية المزدوجة: سورية في ظل الحرب العالمية الثانية»، دار طلاس، دمشق 1984، ص247).
بالتزامن مع دخول تركيا إلى حلف الناتو، تم طرح مشروع أميركي- بريطاني- فرنسي- تركي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1951 أُسمي بـ«قيادة الشرق الأوسط»، وهو مشروع لربط المنطقة بالحلف من الناحية العسكرية – الأمنية، الأمر الذي رفضته مصر الملك فاروق ورئيس الوزراء الوفديّ مصطفى النحاس باشا. وكان تشكيل الوزارة السورية برئاسة شخص معادي للمشروع، هو معروف الدواليبي، دافعاً لانقلاب أديب الشيشكلي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، حيث أبدى لواشنطن قبل انقلابه بأيام تأييده للمشروع (دوغلاس ليتل: «الحرب الباردة والعمل السري: الولايات المتحدة وسوريا 1945-1958»، ميدل إيست جورنال، المجلد 44، العدد 1، شتاء 1990، ص51-75، ص60). ثم طرح مشروع مماثل عام 1955، ولكن بصيغة جديدة، هو «حلف بغداد» اعتُبرت تركيا فيه جسر حلف الناتو الواصل بين أوروبا والشرق الأوسط لكي تواجه المنطقتان الاتحاد السوفياتي في ذروة الحرب الباردة، وهو ما رفضته مصر جمال عبدالناصر وشاركتها سوريا في ذلك. والأرجح، أن سقوط الحكم الملكي في العراق جاء بسبب ميل ميزان القوى في المنطقة لغير صالح الغرب الأميركي- الأوروبي بعد تحالف عبدالناصر مع موسكو خريف 1955. وسقط من بادر إلى إنشاء «حلف بغداد»، أي رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد ورئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، بانقلابي 1958 و1960 على التوالي.
كان الصدام تركياً – مصرياً، وعاضدت القاهرة كل من دمشق ورياض الملك سعود، الذي ورث من أبيه الملك عبد العزيز العداء للهاشميين في العراق ومن أجداده إرث تدمير والي مصر العثماني محمد علي باشا للدرعية عاصمة الدولة السعودية عام 1818 واقتياد الأمير– الإمام عبد الله بن سعود للأستانة حيث شنق أمام مسجد آيا صوفيا، ولكن كان هذا الصدام الإقليمي انعكاساً للحرب الباردة بين حلفي الناتو ووارسو. وما يلفت النظر، أن تركيا مثّلت قلب الهجوم الغربي للسيطرة على المنطقة، وأن اصطدامها الأكبر مع العرب كان في معركة «حلف بغداد» والتي قسمت الحياة السياسية السورية والعراقية والأردنية واللبنانية لمعسكرين، وما استتبعها من حشود عسكرية تركية على الحدود السورية في خريف 1957. ويبدو أن دور أنقرة الرئيسي في الحرب الباردة هو ما دفع الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف في خريف 1962 لأن يربط سحب الصواريخ السوفياتية من كوبا بسحب واشنطن قواعد التنصت وصواريخها من الحدود التركية – السوفياتية، الأمر الذي سحب فتيل المواجهة المباشرة بين عملاقي الحرب الباردة، فيما كانت هذه الحرب حرب وكلاء واشنطن وموسكو. وهنا، نجد أن الدور الإقليمي التركي تراجع مع إعدام مندريس، صاحب الميول الإسلامية مع ولاء للغرب، وهو ما استمر حتى تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991. ولم يبرز دور تركي في أحداث الإقليم سوى عام 1974 مع الغزو العسكري التركي لجزيرة قبرص واحتلال شمالها. وترافق هذا الانكفاء التركي مع اضطراب في الداخل بين اليمين القومي واليسار ومع بداية صعود الإسلاميين، وهو ما دفع المؤسسة العسكرية للتدخل عبر انقلابين في 1971 و1980. ثم جاءت ثورة 15 أغسطس/آب 1984 التي فجرها حزب العمال الكردستاني لتضع تركيا، ومازالت، على صفيح ساخن.
خلال فترة 1923-1960، كان الدور الإقليمي التركي المتمثل بالحياد في الحرب العالمية الثانية وعدم التحالف مع الألمان كما في الحرب الأولى والوقوف ضد السوفيات في الحرب الباردة، سبباً في تغطية الغرب الأوروبي- الأميركي لهشاشة البناء الداخلي الذي أقامه مصطفى كمال وتقديم الأوكسجين الاقتصادي له. ولكن اضطراب الداخل في فترة 1960-1991، جعل تركيا في وضعية اللافعالية الإقليمية. ثم جاء الانهيار السوفياتي ليفقدها الأهمية الوظيفية لدى الغرب. ومنذ 1991، تبحث أنقرة بشكل محموم عن هذا الدور. وكان ذلك إما لحسابها الخاص كما فعل زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان إبان رئاسته الحكومة بين عامي 1996 و1997، حينما أراد تشكيل حلف رباعي بين أنقرة وطهران وبغداد ودمشق قبل أن يسقط بانقلاب العسكر الكماليين بدعم أميركي في فبراير/شباط 1997، أو كما فعل رجب طيب أردوغان الذي انتهج الرقص على حبلي الكرملين والبيت الأبيض منذ قمته في الكرملين في أغسطس/آب 2016 وحتى سقوط بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي. وأحياناً، يكون هذا البحث المحموم عن دور ما لحساب واشنطن، كما فعل حزب العدالة والتنمية منذ تسلمه السلطة في 2002 وحتى بداية التنسيق الأميركي- الروسي بشأن الملف السوري من خلال اتفاق مايو/أيار 2013 الذي أدى إلى تخلي واشنطن عن استخدام تلاميذ حسن البنا ضد تنظيم القاعدة واتجاهها لمكافحة الإسلاميين بالتعاون مع الروس وأنظمة جاءت على أنقاضهم مثل حكم العسكر المصريين بعد يوليو/تموز 2013.
كان حلم أردوغان في فترة حلفه مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بين صيفي 2011 و2013 في سوريا أن ينصّب حكماً إسلامياً موالياً في دمشق مثلما فعل خامنئي في بغداد برضا واشنطن. ولكن تخلي أوباما عن زواجه قصير الأمد مع الإسلاميين، الذي أثمر عن حكمين في تونس والقاهرة، أدى إلى أن يخرج أردوغان خالي الوفاض من سوريا، قبل أن يعوض ذلك عبر الكرملين في خط جرابلس- الباب- إعزاز في فترة أغسطس/آب 2016 وفبراير/شباط 2017، ثم مدينة عفرين ومنطقتها في العام التالي، وبعدها شريط تل أبيض- رأس العين (سري كانيه) في 2019، بموافقة مشتركة من موسكو وواشنطن التي منعته لاحقاً من الامتداد نحو منبج.
أوحى الأتراك من خلال وصول الإسلاميين للسلطة في سوريا بعد سقوط الأسد بأنهم في وضع يشبه السيطرة الإيرانية على السلطة العراقية. وربما ساهم كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض في أبريل/نيسان الجاري في تعزيز هذا الانطباع حينما أبدى سروره لأن أردوغان «تولى أمر سوريا» لحساب واشنطن. والأغلب أنه قصد عملية «ردع العدوان» التي سقط فيها الأسد عبر فصائل إسلامية مقرّبة أو موالية لأنقرة، ولا يقصد دمشق ما بعد سقوط الأسد، في عمليية شبيهة بما كان مطلوباً من عدنان مندريس القيام به في سوريا، من قبل لندن وواشنطن، بأن يتولى أمرها خلال حقبة «حلف بغداد» من أجل إقامة حلف الناتو شرق الأوسطي ضد موسكو. ويبدو أن أردوغان والسوريين الإسلاميين يمهدون الطريق من أجل هذا الحلف، ولكن ضد الصين حالياً، بعد تحجيم قوتي إيران وروسيا إثر سقوط حليفهما السوري قبيل المفاوضات الأميركية معهما. ولكن على الأرجح، ليس الدافع حكم دمشق، كما كان مندريس غير قادر على حكمها حتى لو انضمت حكومة فارس الخوري إلى «حلف بغداد» عام 1955. وكما قال الكاتب البريطاني باتريك سيل: «من يقود الشرق الأوسط لابد له من السيطرة على سوريا» («الصراع على سورية»، دار الأنوار، بيروت 1968،ص14)، وهذا غير مسموح للأتراك به سواء من واشنطن أو من الرياض والقاهرة وتل أبيب في الإقليم.