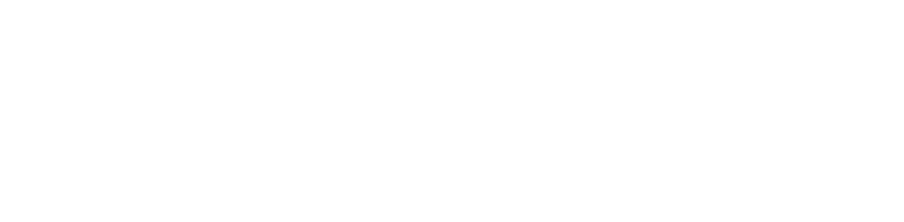فرهاد حمي
مما لا شك فيه أنّ اللون الأخضر تسلل إلى المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، ليفرض نفسه كرمزٍ طاغٍ. اجتاحت تريندات وسائل التواصل الاجتماعي بشعارات مثل «الأخضر يتمدد»، في إشارة إلى وجوب تحكم فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بالجغرافيا السورية. تحوّل اللون الأخضر إلى هوية بصرية جديدة، يختزل التغيير والانتصار، حتى بات يُقال: «ستصبح سوريا أجمل عندما تلبس الأخضر بالكامل»، و «يجب تعظيم سلام للون الأخضر».
في خضم هذا المدّ الأخضر، ظهر أحمد الشرع لأول مرة بالسترة الرسمية إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مرتدياً ربطة عنق خضراء ومودعاً العمامة السوداء التي كانت رمزاً للعهد السابق في زمن الحرب الأهلية. ومع تسارع الأحداث، بدأت هذه التحولات تنعكس على ملامح الدولة الناشئة: تغيّرت ألوان قمصان المنتخب الوطني، وظهرت دعوات لإصدار جوازات سفر خضراء، في حين امتد اللون الأخضر ليشمل ملابس ورتب الجيش، وشارات قوى الأمن، وخلفيات الاحتفالات. وكأنها كانت بمثابة إعلان غير مباشر عن انتصار اللون الأخضر على السواد الذي كان يرمز إلى حقبة الأسد. ويخيل إلي أنه لو كان إريك هوبازباوم شاهداً على هذه المشاهد الرمزية، لقال: هكذا تماماً تتشكل هوية الدولة القومية الجديدة.
هذه الهالة الساحرة المحيطة بـ «الأخضر» يستعصي تأويلها ضمن سياق الألوان بطريقة رومانسية أو تبسيطية، فاللون هنا ليس مجرد تدرج بصري، بل هو تعبير سياسي وإيديولوجي بامتياز. ولا يقتصر الأمر على كونه جزءاً من العلم السوري بألوانه الثلاثة (الأخضر، الأبيض، الأسود)، الذي تعتبره القوى المناهضة للأسد رمزاً لعلم الاستقلال، ولا تتوقف دلالته أيضاً عند الترميز التاريخي، وخاصة عند إحالة ربط الأخضر بمرحلة الخلافة الراشدة، بينما يحمل الأبيض رمزية الخلافة الأموية، في حين يشير الأسود بالخلافة العباسية. فالتناقض يكمن في التفضيل الحصري للّون الأخضر بين مناصريّ الحكم الجديد، مع تعظيم شأن بني أمية، دون اكتراث بالأبعاد الأخرى لهذه الألوان، فالأخضر في التاريخ كانت راية الدولة الفاطمية الإسماعيلية.
بالمثل، لا يمكن تفسير حضور الأخضر من زاوية التصوف، رغم ارتباطه العريق بالجنة والخلود في الأدبيات الصوفية، حيث اعتمده المتصوفة لوناً رئيسياً في ملابسهم وكسوة أضرحة أوليائهم. فهذه المقاربة تصطدم مباشرة بالنزعة السلفية الجهادية لهيئة تحرير الشام وفصائلها، إذ إن الصراع بين التصوف والإسلاموية السلطوية، سواء في نسختها السلفية الجهادية أو الإخوانية، أمر معروف ومتجذر. وعليه، من المستحيل أن تستحضر التيارات الإسلامية الأصولية اللون الأخضر من تراث التصوف أو أن تتبنى رمزيته الطقسية.
الأخضر والدولة القومية
يبدو من الأكثر منطقية قراءة اللون من منظور أدبيات الدولة القومية، حيث لم تعد الألوان مجرد عناصر جمالية أو رموز ثقافية ذات بعد تاريخي، بل أصبحت أدوات سياسية بامتياز، تعكس السلطة، وترسّخ الانتماء، وتمنح الشرعية للنظام الحاكم. فمنذ نشوء الدولة القومية، جرى توظيف الألوان بوعي عميق لصياغة السرديات الوطنية، سواء من خلال الأعلام الرسمية، أو الأزياء العسكرية والمدنية، أو حتى عبر الهندسة المعمارية والبصرية لمؤسسات الدولة. بناءً على ذلك، فإن اللون الأخضر، الذي يطغى اليوم على المشهد السوري ذي الطابع السوريالي، لا يمكن عزله عن هذا الإطار، بل ينبغي تأويله ضمن سياق تطعيم هوية الدولة القومية أولاً، وفهم دوره في إعادة إنتاج هياكل السلطة وهويتها الإسلامية ثانياً. أي أن المصفوفة الهوياتية الإسلامية تُضاف إلى المصفوفة القومية.
يبدي السوريون اليوم مخاوفهم من نزعة أحمد الشرع التسلطية وفرضه لـ” اللون الواحد“، كما عبّر عن ذلك الشيخ حكمت الهجري في رده الأخير على الإعلان الدستوري. يعكس هذا الرد موقف غالبية الأطراف التي استُبعدت من المرحلة الانتقالية بقرار من الحكومة المؤقتة في دمشق، لا سيما بعد اتخاذ خطوات أحادية الجانب، مثل الإعلان الدستوري، تشكيل الجيش والأمن، وتنصيب الشرع نفسه رئيساً للجمهورية في مؤتمر النصر. إضافة إلى ذلك، تم حل مؤسسات النظام السابق وتشكيل حكومة ذات طابع أحادي، مع الإصرار على احتكار العنف بيد واحدة، والعشوائية في محاكمة « فلول النظام»، وما تبع ذلك من جرائم التطهير الطائفي ضد العلويين في الساحل. في النهاية، يعكس هذا التوجه فكرة استفراد بالسلطة، وإذا أضفنا البعد الأيديولوجي الإسلاموي مع رمزيته اللونية الطاغية، يمكن وصفه بـ«السلطوية الخضراء». هو بلا شك مصطلح يتناقض مع الواقع الاجتماعي السوري، بما في ذلك تركيبة الإسلام التقليدي في البلاد بجميع تياراته، سواء الصوفية أو الطرائقية أو المذهبية.
تركيا نموذجاً
في سياق السلطة بشكل خاص، يصبح ربط اللون بالإيديولوجيا أكثر دقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأبعاد هوية أحادية. فالغالبية العظمى من هياكل السلطة في المنطقة لا تزال تدور في فلك «الفاشية»، نتيجة تأثرها بالعقائد النازية العرقية والجمهوريات الفرنسية الثلاث الأولى، التي تتسم بالصبغة المركزية المتشددة، والثقافة الأحادية المصطنعة سواء دينياً أو قوميّاً، بالإضافة إلى التوجه الاستعماري سواء داخلياً أو خارجياً. وبالتالي، لم تتحول معظم دول الشرق الأوسط إلى دول تقوم على مبدأ المواطنة الدستورية. ومن هنا، تبقى النزعة الفاشية هي السائدة من حيث المبدأ.
حسب الخطاب السياسي والاجتماعي السائد، تقدم الحالة السياسية التركية مفاهيم مفتاحية، لفهم فكرة اللون الإيديولوجي في سياق «الاحادية الدولتية». حيث يُوصف حزب الشعب الجمهوري مثالاً على «التركياتية البيضاء»، التي تعكس تفوقاً عنصرياً تركياً، يعارض التنوع القومي والثقافي والمذهبي من خلال سياسة التذويب، متبنياً مفاهيم الرجل الأبيض ضد هذا التنوع. من جهة أخرى، يُمثل حزب الحركة القومية التركية تاريخياً نموذجاً لـ «الفاشية السوداء»، التي تستند إلى التفوق العرقي، تغذيها العقيدة النازية من خلال تقديس أساطير التراث التركماني وعظمة الإمبراطورية العثمانية، مع تسخير فكرة الإبادة والتطهير العرقي ضد التنوع الاجتماعي. أما حزب العدالة والتنمية، فيُصنف في «التركياتية الخضراء»، حيث تركز سياسته على القومية التركية المتداخلة مع الإسلاموية السنيّة بما يتناسب مع بنية الدولة القومية الأحادية، ويستخدم الصهر الناعم والقبضة الحديدية في التعاطي مع التنوع الديني والقومي.
على الرغم من أن هذه المصطلحات ليست شائعة في سوريا والعالم العربي عموماً، فإنها تشكل إطاراً ملائماً نسبياً لفهم التاريخ السياسي الحديث في سوريا، الذي شهد فترات من العنف والمذابح والانقلابات. في هذا السياق، كان تأثير ما يُسمى بـ«العروبة البيضاء» طاغياً بعد مرحلة الاستقلال، إذ عملت على فرض هوية وطنية أحادية وإقصاء التنوع السوري، مثلما تجلى في مشروع الحزام العربي وسياسة التعريب التي كانت نتاجاً لتلك الذهنية. في المقابل، جسدت «العروبة السوداء» التي تبناها حزب البعث ترسيخ فكرة التفوق القومي العروبي، مع تسخير العنف الشامل ضد أي تمرد سياسي أو اجتماعي.
تسببت هذه السياسات في اندلاع حرب أهلية مدمرة استمرت لعقد ونصف، لتظهر بعدها ظاهرة ” العروبة الخضراء” التي بدأت تسيطر على البلاد، من خلال تبني قومية متطرفة ذات نزعة سنيّة إسلامية. هذا الاتجاه تجلى بوضوح في مواد الإعلان الدستوري الذي صدر قبل أسابيع، مما يزيد من احتمالية تفجير الصراع ضد التنوع السوري. كما ظهر هذا التوجه من خلال مجازر الساحل، وإقصاء الدروز والكرد وباقي القوى الوطنية من حقهم في تحديد مصير البلاد، على الرغم من التفاهم الجانبي مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال الوثيقة الموقعة بين الطرفين مؤخراً.
لا شك أن هذا الاتجاه الأخضر، بطابعه المتشدد، يسعى إلى تحقيق السلطة من خلال تبني نزعة أصولية وتأسيسها على أسس الدولة القومية. يستلهم هذا الاتجاه تجاربه التاريخية في بناء الدولة من دول مثل باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان. في جوهره، يسعى هذا الاتجاه للاندماج في النظام الدولي من خلال التحكم في جهاز الدولة القومية، مع التركيز على الهوية الأحادية الخضراء، بهدف استثمار النزعات الدينية الجماهيرية لتجاوز القومية العلمانية، التي لم تتمكن من تقليص التناقضات الاجتماعية والاقتصادية. إلى هذه اللحظة، يظل هدف هذا التوجه هو احتكار السلطة، مع محاولات لفرض العقيدة الأحادية المفروضة على المجتمع من خلال الدستور وأجهزة العنف.
وبالتوالي، بدأت تظهر مؤشرات واضحة على تمكين السلطة الأحادية من خلال السياسات الاقتصادية لحكومة الشرع المؤقتة. وقد تجسدت المفارقة في التفاعل والتداخل بين النيوليبرالية والرؤية الإسلاموية، التي تسعى إلى التمسك بالاعتدال في الحكم، مستفيدةً من مجموعة من الخبرات التقنية والإدارية التي تعمل تحت ستار من السرية السياسية.
استفادت هذه السياسات من التفكك الاجتماعي الذي خلفته الحرب الأهلية السورية، في تجسيد عملي لمفهوم «عقيدة الصدمة» الذي تناولته نعومي كلاين. فالمجتمع السوري، الذي يعاني من انقسامات عميقة، يبدو عاجزًا عن مقاومة مخططات «الإسلاموية الخضراء»، بل وربما يكون جزء كبير منه مستعدًا للتكيف مع أي نموذج يُفرض عليه، لا سيما بعد الانهيار المفاجئ لنظام الأسد، وما تبعه من تفكيك تدريجي للقطاع العام وخروجه من معادلة الدولة، تمهيدًا لخصخصة القطاعات الحيوية في البلاد. وهنا تحديداً، تتقاطع «الإسلاموية الخضراء» مع المصالح الدولية، خاصة إذا فضّلت تبني معادلة الدولة القومية كإطار للحكم.
الأخضر في ميزان التصادم الدولي
وظيفياً ومصلحياً، اعتمدت القوى الغربية على الاستشراقية الإسلامية، سواء المعتدلة أو الراديكالية، كخيار احتياطي لمواجهة الأزمات والصراعات الدولية. فكانت تُستخدم أحياناً كأداة لمناهضة التمدد السوفياتي، وأحياناً أخرى لمواجهة الأنظمة القومية المناهضة للغرب. ومع ذلك، استهدفت هذه السياسة في الغالب التوجهات الديمقراطية التحررية والحركات اليسارية المحلية، ما جعلها وسيلة للحفاظ على مصالح القوى الاستعمارية الخارجية، وفي الوقت نفسه عائقاً أمام التحول الديمقراطي.
في عام 1979، طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، زبغينو بريجنسكي، مفهوم «الحزام الأخضر» لمحاصرة التمدد السوفياتي الجديد. فقد اعتبر بريجنسكي أن ظهور أنظمة إسلامية في الشرق الأوسط، بدعم أمريكي، يمكن أن يوفر بدائل حقيقية للأنظمة الاستبدادية القائمة من جهة، وأن يحدّ من نفوذ الحركات اليسارية والشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفياتي، إضافةً إلى احتواء إيران.
يبدو أن الحدث السوري أعاد إلى الأذهان ضرورة تجديد مفهوم «الحزام الأخضر» في سوريا، بهدف مواجهة الأسد وإيران أولاً، ثم روسيا لاحقاً. وفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي العالمي جيفري ساكس، لم يتردد فريق أوباما وهيلاري كلينتون في إعادة تفعيل هذه الاستراتيجية، حيث ساهمت الولايات المتحدة في إنشاء مشروع «تيمبر سيكامور»، وهو برنامج سري أطلقته وكالة المخابرات المركزية عام 2012 لدعم وتسليح فصائل معارضة، بما في ذلك جماعات إسلامية. استمر المشروع حتى عام 2017، عندما أوقفه الرئيس ترامب.
رغم تراجع الدور الأمريكي نسبياً، واصلت بريطانيا وتركيا وبعض حلفاء واشنطن دعم تلك الحركات الإسلامية، التي خرجت من عباءة داعش. وفي هذا السياق، نشأت هيئة تحرير الشام بعد انشقاقها عن داعش والقاعدة، لتصبح ورقة ضغط ضد نظام الأسد. ومع تغيّر الظروف، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، شهدت المنطقة تحولات عميقة في أولويات القوى الفاعلة، مما دفع بعض الجهات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في استخدام الجماعات الإسلامية كورقة ضغط إقليمية. وتحديداً المراكز الثلاثة: لندن، أنقرة، والدوحة، التي تبادلت الأدوار في إعادة تأهيل «الأخضر الإسلامي» في سوريا.
الشرع كرمز للإسلاموية الخضراء
وفي ظل هذه المتغيرات، استغلت هيئة تحرير الشام، بدعم من القوى الراعية لها، سيطرتها على مناطق نفوذها، ليبدأ «الإسلاموية الخضراء» في تجاوز الفاشية السوداء الأسدية، مرسخاً وجوده على أنقاض الماضي. كل ذلك جرى تحت قيادة تتبنى نموذجاً قائماً على السلطة الكاريزمية، حيث يُمنح القائد قوة شبه مطلقة، ويُتوقع من الشعب الولاء التام. وقد تجلى هذا النموذج في شخصية أحمد الشرع، الذي برز كزعيم يسوّق له على أساس كاريزمي، ما سمح للإيديولوجيا الخضراء بالاستمرار والتوسع في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.
المفارقة تكمن في أن دونالد ترامب ونتنياهو وبوتين دخلوا في صدام مع ما يُعرف بـ «التيار العولمي»، الذي كان يدعم فكرة الإسلاموية الخضراء. ومع ذلك، لا تزال بعض القوى الأوروبية تقاوم هذا الاتجاه على عدة جبهات. فعلى سبيل المثال، في المشهد السوري، تسعى هذه القوى إلى توفير الدعم الدبلوماسي والمالي والسياسي لسلطة دمشق المؤقتة، لكنها تعاني من ارتباك في تنفيذ رؤيتها، التي كانت تدعم الراديكالية الإسلامية سابقاً، وتسعى حالياً إلى إعادة تأهيلها تحت شعار « قوة إسلامية معتدلة»، أو وفقاً لما أصبح شائعاً بين منتقدي هذا المشروع، ضمن إطار «الحوكمة الجهادية»، بحيث تكون قادرة على استيعاب التنوع السوري، والمساهمة في بناء دولة دستورية شاملة. ومع ذلك، لم تجرِ هذه القوى الإسلاموية مراجعة إيديولوجية حقيقية، بل اكتفت بتقديم تحولها في إطار تسويق شكلي لا أكثر، مما يجعل التناقض بين الخطاب والممارسة واضحاً في تفاصيل المشهد السوري اليومي.
ورغم ذلك، لا تزال بعض الجهات الأوروبية والإقليمية تراهن على الإسلاموية السنيّة الخضراء كقوة محورية في معادلة السلطة. ويجسد حضور الشيباني مؤتمر بروكسل مؤخراً بعد مجازر الساحل، إصرار هذه القوى على النهج ذاته، الذي يعيد إنتاج الإسلاموية كأداة سياسية في المشهد السوري.
في ظل هذا الاضطراب، ودولة لم تستقر بعد، يعزز «اللون الأخضر» من وجوده بقوة في البلاد، مستفيداً من رحيل «الفاشية السوداء». بالمقابل، يسعى التنوع السوري إلى مقاومة هذا الاتجاه، واستعادة حقه في دولة تعددية وطنية. والسؤال المطروح هو: هل سيطغى اللون الأخضر الأحادي على البلاد ويتلاشى التنوع السوري، أم سيكون هناك صيغة سياسية قادرة على توفير حلول وسط تنقذ البلاد من عواقب مدمرة؟