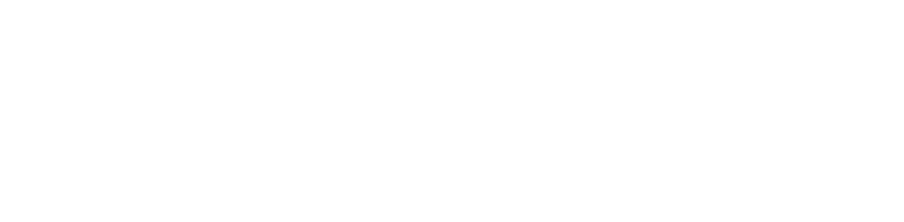د.عقيل سعيد محفوض
غالباً ما تُحيل اللامركزية والهوية في بلد مثل سوريا إلى مدارك تهديد أكثر منها مدارك فرصة، وفواعل انقسام أو اختلال أو ضعف او اختراق أكثر منها فواعل تماسك وانتظام وقوة ومنعة. وهذه أمور ملازمة لنشوء الدولة الحديثة في سوريا والمنطقة في أعقاب الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وفترة السيطرة الكولونيالية التي تمثلت بالانتداب الفرنسي على سوريا (1920-1946). وتم إعادة إنتاج مدارك التهديد- الفرصة حيال اللامركزية والهوية خلال الأزمة السورية منذ العام 2011، خاصة بعد إسقاط النظام نهاية 2024.
عندما تختل موازين المعنى والقوة في بلد ما ويندلع صراع عميق وممتد يهدد وجود المجتمع والدولة، تصحب الأولوية للملمة التكوينات والمناطق والتطلعات والرهانات في إطار فكرة واحدة وروح مجتمع واحد ودولة واحدة. وبالنسبة للكاتب، فقد كان تركيزه الرئيس وهاجسه الأساس، خلال عدة سنوات، فيما يفكر ويبحث ويكتب هو: كيف يمكن للسوريين أن يكونوا مجتمعاً ودولة قابلين للاستقرار والاستمرار؟ وكيف يمكن الموازنة بين أولويات المجتمع وأولويات السلطة أو الدولة بين المركزية واللامركزية؟
والآن، حان الوقت لإعادة التفكير في الموضوعتين: اللامركزية والهوية الوطنية بأكبر قد ممكن من العمق والجدية وأقل قدر ممكن من الأدلجة. وإذا كانت الفكرة الشائعة بين السوريين هي أن اللامركزية تهدد الهوية الوطنية، فقد حان الوقت أيضاً لاختبار أو تجريب العكس، أي كون اللامركزية مدخل أساس لقيام هوية وطنية أكثر تماسكاً واستقراراً. ولو أن هذا النص لن يذهب بعيداً في هذا الباب.
وخلال عدة عقود، لم يمكن بالإمكان الدخول في نقاش جاد أو معمق حول اللامركزية والهوية. وثمة خلاف حاد حول كل ما يتعلق بالظاهرة السورية اليوم، ومنها طبيعة النظام السياسي والهوية الوطنية: أي نظام سياسي؟ وأي هوية؟ وليس من المتوقع أن يتوافق السوريون في وقت قريب عليها. والواقع، أن ثمة طبقات من الهواجس والمخاوف، وأيضاً من سوء التقدير والفهم حيالها. ويزيد في ذلك تحولات القيم لدى السوريين عن معنى «مجتمع» و«دولة»، وبعيداً عنهما، إن أمكن التعبير.
الميزان أو المنظور
يتعلق الأمر بالسؤال حول العلاقة الممكنة أو المحتملة بين اللامركزية والهوية، بين تكوينات الهوية «ما دون الدولة» وتكوين «هوية وطنية». وهل اللامركزية تمثل تهديداً لمركزية المعنى والهوية في «مجتمع» و«دولة» في سوريا؟ أم أنها –على العكس- حاجة وضرورة من أجل معنى وهوية جامعة في «مجتمع ودولة سوريين»؟
يتعلق الأمر أيضاً بالكيفية التي يُنظر وفقها للمركزية واللامركزية. فإذا كان النظرة للبلد بوصفه جماعات وهويات مناطقية أو لغوية أو قومية أو دينية يجب أن تكون معاً، فهذا يعني أن الميزان أو المنظور هو أولوية (أو ربما قوامة) المناطق أو الأقاليم على المركز، أولوية اللامركزية على المركزية، وأولوية الجماعة أو الملة أو المنطقة على المجتمع. أما إذا كان النظر للبلد بوصفه شعباً ومجتمعاً سورياً يتضمن تشكلات أو تكوينات إثنية ودينية وجهوية، فإن الأولوية أو القوامة –من هذا المنظور- هي لـ«المجتمع» و«الدولة».
هذه مسألة مهمة، بقدر ما إنها خلافية، وهي خطيرة بالنسبة للبعض. مهمة لوحدة المجتمع وعدم نمو الاتجاهات الانقسامية والصراعية فيه وضمان تشكل هوية وطنية جامعة لكل أنماط التشكل والتكوين الاجتماعي. لكنها خلافية، إذ مَنْ يقرر ذلك؟ ووفق ميزان وتطلُع مَنْ؟ وكيف يتم تدبير الاختلافات والفروق بين التكوينات والتشكلات والجماعات والأقليات والأكثريات؟ وهي خطيرة بالنسبة لمن لديهم مخاوف من استبداد جماعات أو سرديات وإيديولوجيات بعينها، أو مخاوف من انقسام البلد على أسس جهوية أو مناطقية أو حتى عرفية أو دينية/طائفية.
حديث اللامركزية والهوية
وكان الحديث عن اللامركزية في سوريا، خلال عدة سنوات وخاصة بعد العام 2011، أقرب للتلاعب اللفظي والبلاغي منه إلى التفكير الجدي بها أو محاولة تطبيقها، وأشبه بحيلة وتكتيك خطابي- سياسي لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على النظام السياسي، ارتباطاً بالصراع الدائر والممتد والعميق في البلاد منذ العام 2011 وحتى إسقاطه في نهاية العام 2024. وقد يتواصل ذلك في سوريا ما بعد الأسد، إذ ثمة مؤشرات على وجود مقاربات مشابهة إلى حد ما بالنسبة لطبيعة النظام السياسي (مركزي، لامركزي). وينسحب جانب من ذلك على حديث الهوية أيضاً. وأما معناها، فمن المرجح أن يتم تحديده (أو بالأحرى إعادة تحديده) مركزياً أيضاً. وهذا ما كان خلال عدة عقود، وقد يتواصل بكيفية أو أخرى، كما سبقت الإشارة.
وكان البحث في الهوية أحد الأسباب التي دفعت بشار الأسد شخصياً لإغلاق مركز الأبحاث الوحيد تقريباً في سوريا بكيفية مؤسفة وغير مبررة، عندما عقد مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» مؤتمراً عن الهوية السورية في ضوء الصراع (في يناير/كانون الثاني 2018)، مدشناً نقاشاً فكرياً سياسياً عن أزمة الهوية في الداخل. ونقل كتاب ومثقفون عن الأسد قوله إن «سوريا ليست بحاجة إلى مراكز أبحاث».
وعندما أعلن «مداد» عن مؤتمر الهوية الوطنية، قالت مستشارة الرئيس: «لا توجد في سوريا مشكلة هوية، وكان من الأفضل للمركز أن يبحث في الحرف والمهن اليدوية»! والواقع أن أكثر حديث النظام عن اللامركزية والهوية كان استكشافياً وفلكلورياً وعاماً لدرجة يمكن معها القول إنه بالكاد يحيل إلى شيء. والصحيح أنه كان أقرب للتحايل منه للبحث والتفكير الجاد في كيف يمكن تدبر جانب من أزمات البلاد.
فكرة اللامركزية
المهم في فكرة اللامركزية أن تكون الرؤية لإدارة الحياة والعمل والإنتاج والعيش في المنطقة أو الإقليم (اللامركزي) من منظور الفواعل المحلية، باعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وباعتبار أن الإقليم/المنطقة في البلد هو جزء من كل. وهذا لا يعني أن تقوم هوية كيانية للمحليات/ الجهويات/ المناطق/ الأقاليم. إذ على العموم، لا توجد في سوريا مناطق ذات خصوصية محض دينية أو محض قومية، خلا بعض التركيز النسبي في بعض المناطق. وثمة نظم حكم لامركزية في بلدان تُعَدّ متجانسة أو شبه متجانسة إثنياً ودينياً والعكس صحيح، أي أن ثمة نظم حكم مركزية في بلدان متعددة اثنياً ودينياً.
وهكذا، فإن اللامركزية هي جزء من دينامية السياسات العامة وتدبير الحياة الاجتماعية. وبقدر ما أن الخصوصيات الإثنية والدينية الخ مهمة، فإن التفاعل والاندماج الاجتماعي الوطني مهم هو الآخر. ولا يفترض أن يكون المجتمع متعدداً إثنياً وعرقياً ودينياً أو فيه نداءات وتيارات هووية حتى تقوم اللامركزية. وهنا، تبدو اللامركزية «تقنية سياسية» أو «تقنية سياساتية» و«تنموية» وليست مجرد تعبير عن نداءات جهوية أو مناطقية أو دينية.
ومن الممكن أن يكون هناك «لا مركزية موسعة». بمعنى، هندسة المشهد في بعض المناطق أو الأقاليم بكيفية تتيح إبراز وجود وتمكين هويات وديناميات خاصة حسب التكوين الاجتماعي: لغوياً ودينياً وثقافياً. أي إفساح المجال أمام الجماعات والتكوينات والمحليات لأن تعبر عن نفسها وتعيش خصوصيتها، إنما بقدر محدد ومحكوم من قبل المركز أو ضوابط ومعايير مركزية تساهم هي نفسها (الجماعات والتكوينات) في تحديدها.
ما يشبه الفدرالية
لا توجد أنماط معيارية من اللامركزية أو الفدرالية. بل ثمة أنماط وتشكلات وأطياف منها تختلف بين بلد وآخر. وقد تذهب اللامركزية إلى تمكين المناطق والأقاليم والمحليات والجهويات من تبني سياسات أبعد من مجرد الاستجابة للخصوصيات، وأبعد من إدارة وتدبير المصالح والتطلعات الإثنية والدينية إلى ما يشبه الفدرالية أو نمط من أنماطها. لكن المهم في ذلك هو ألا يكون لنزعات اللامركزية أبعاداً حركية أو كيانية تصدع المجتمع والدولة، وألا تخلق استقطاباً هوياتياً وسياساتياً/صراعياً، وألا تثير مخيالاً انقسامياً.
والمهم بالقدر نفسه، هو ألا يتحدد ذلك مركزياً أو ألا يكون محض مركزي، سواء أكان من قبل بيروقراطية حكومية ونظام سياسي مستبد، أو من قبل إيديولوجية أو عصبة مهيمنة بالإكراه والغلبة على السياسة والمجتمع والدولة. ثمة حاجة لأن يكون شكل النظام السياسي وطبيعة الحكم محل توافق عام وليس نتيجة إكراه أو حكم الغلبة.
في الختام، إن اللامركزية لا تمثل بذاتها مصدر تهديد للهوية في سوريا. وبالمقابل، ليست الترياق لأزمات البلاد ولا الحافظ الجامع المانع للمجتمع من التسلط والاستبداد. الصحيح هو عدها «تقنية سياساتية» أكثر منها إيديولوجيا. وهي حاجة بالنسبة المجتمعات متعددة الإثنيات والتكوينات، بل هي حاجة بالنسبة للمجتمعات عموماً. وعندما تكون اللامركزية، على اختلاف صيغها ونداءاتها وتمثلاتها وخبراتها، حصيلة دينامية اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ومحل توافق وطني، فإنها تمثل عندئذ عامل تماسك لـ«المجتمع» و«الدولة» وعامل قوة وأمان، وليس عامل ضعف أو اختلال أو هشاشة أو تفكيك لهما. وهذا باب فيه كلام كثير.