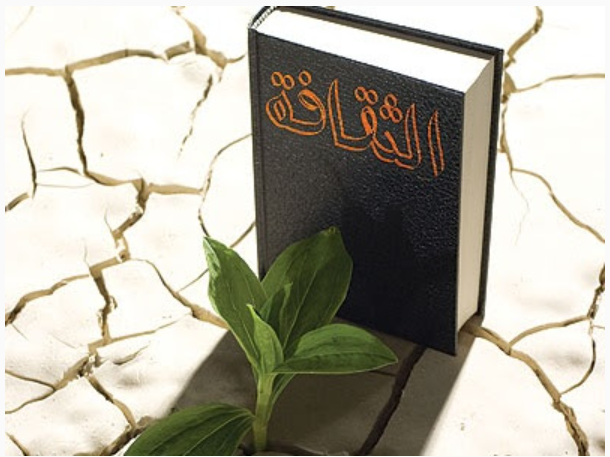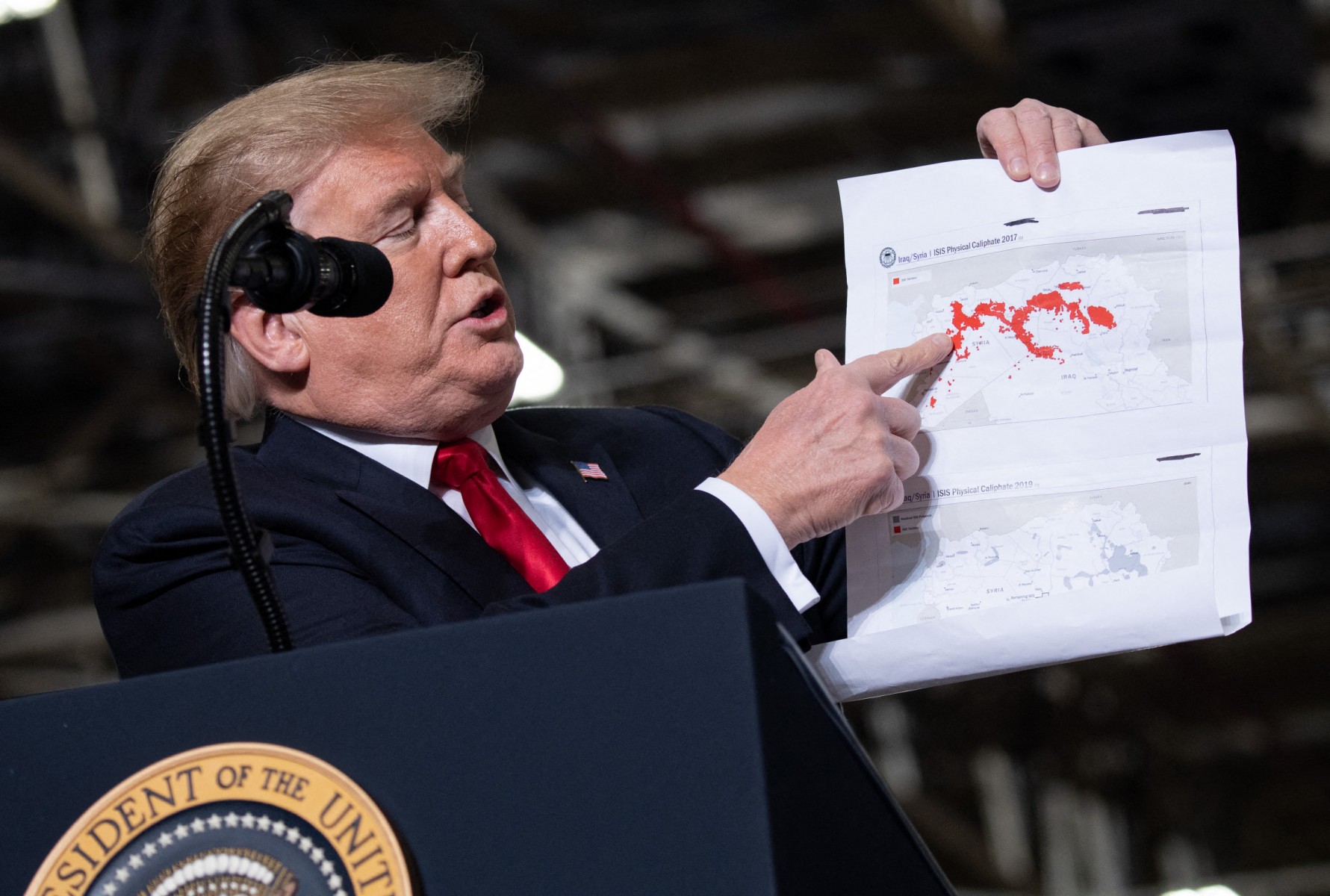بشار عبود
إذا جاز لنا تعريف الثقافة بأنها مصدر كل تغييرٍ في المجتمع، فلا نجادل حين نشير إلى أن أسس مشاكلنا التي نعيشها في سوريا تنبع من وجود أزمة ثقافية عميقة تتغلغل ليس فقط ضمن أوساط مثقفي النظام، وإنما بين من ناصرَ الثورة ووقف معها أيضاً. فمظاهر الخواء تتجلى تقريباً في عموم مستويات المشهد السوري الحالي سواء من ناحية الرؤية أو من جهة التأثير في الوعي الجمعي. تعكس هذه الأزمة من ناحية، نوعية الطرح الفكري الذي يتم تقديمه، كما تشير إلى ضعف تأثير المثقف الوطني في مجرى الأحداث وإخلاء الساحة أمام من اشتغل على تعميق المشكلات وتقسيم المجتمع، وهو ما عزز قلة ثقة الناس بمجموع النُّخب المتواجدة على الساحة الفكرية.
يصف عالم الاجتماع الأميركي لويس كوزر المثقف بأنه كائن منتج يستطيع رؤية التناقضات في المجتمع وبنفس الوقت هو قادر على أن يدعو لتفكيكها وتهميشها مستنداً في ذلك إلى سلطته النقدية الرمزية. ووفقاً لهذا، نكون أمام قسمين أساسيين يبلوران عمل المثقف: إنتاج الإبداع بما يمتلكه من رؤية معرفية صلبة عامة وشاملة، ثم التأسيس لخطابٍ عام يدعو فيه إلى معالجة مشاكل اللاعدالة واللامساوة ويكشف عن عيوب المجتمع والسلطة الحاكمة فيه ويعمل لتصحيحها.
أهم ما شكلته الثورة السورية في عقدها الأخير هو اختبارها المطلق لشريحتها المثقفة وكشفها تخلفها عن دورها الأساسي في استيعاب متغيرات مراحل الثورة، وهو ما تجلى في لجوء الكثير من المثقفين إما إلى العزلة الرفاقية والاستعلاء على الجماهير، وإما إلى الغياب التام وعدم تبني القضايا الأخلاقية والدفاع عنها كما حدث مؤخراً مع مجزرة جنديرس عندما قتلت الفصائل الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي أربعة مدنيين كرد سوريين فقط لأنهم أرادوا الاحتفال بشعلة عيد النوروز، من دون أن يتحرك المثقفون لتشكيل رأيٍ عام وطني واضح يدين هذا العمل ويدعو إلى محاسبة الفاعلين ومن وراءهم. المثقف السوري غائب عموماً. فهو إما مشغول بمشروعه الثقافي الشخصي، وإما مُستقطب سياسياً بشكلٍ ضيّق للأيديولوجيا أو للطائفة أو القومية.
لو سألنا عن شكل الإبداع الذي رسم خارطة الثقافة في سوريا بعد 2011، أو كم عدد الذين تأثروا بأطروحات «المثقفين الوطنيين»، لأصبنا بحالة من الإحباط. فهناك غيابٌ لخطابٍ موحّد جامع لكل السوريين، وتخبطٌ في الرؤية والتحليل، مع اللجوء إلى خيار الشّللية والجدل الثقافي عبر منصاتٍ إعلامية مموّلة من جهاتٍ خارجية لم تترك أي تأثيرٍ على الواقع السوري لا من حيث الأثر المرتجى ولا من حيث التفاعل الجماهيري حولها، لتخلو الساحة أمام خطابات الكراهية والشعبوية واسعة الانتشار، التي لم تساهم سوى في تراكم عدّاد الجهل المعرفي بين الناس.
ما زاد الطين بلّة هو دخول المثقف السوري لعبة المعارضة السياسية، فأصبح، نتيجة ضعف خبرته بالأخيرة، كطائرٍ أعرج مكسور الجناح لا هو قادر على الطيران ولا بإمكانه المشي كما يجب. كما تاه بين الواقعية السياسية ورضوخه لأهوائها، وبين مهنته الرمزية القائمة على النقد والمواجهة ورؤيته للنهوض والإصلاح والتنوير.
لنعترف إذاً بأن الثورة لم تفرز مثقفين لهم قدرة على تشكيل وعيٍ جمعي وطني شامل. فسوريا، كما تبيّن خلال مسيرة الأعوام الأخيرة بلدٌ لعدّة مجتمعاتٍ لا مجتمعٌ واحد، وفكرة الاندماج الوطني فيها أضعف بكثيرٍ من اندماجها الطائفي أو الإثني أو الحزبي. أما عن القيم المشتركة التي توهّمناها في 2011، أثبتت الوقائع أنها ليست واحدة لدى جميع السوريين. قد يكون ذلك من الأسباب التي لم تبلور حضوراً مهماً للمثقف العضوي على مستوى الوطن، كون البيئات السورية غير متشابهة والمثقف بصفته صانع رأيٍ عام لم يتمكّن من التعمّق في تفكيك هذا الاختلاف لكي يقدّم على أساسه خطاباً وطنياً يكون له تأثيره على أكبر شريحةٍ ممكنة من السوريين.
لا يبذل المتتبع لحركة الثقافة السورية جهداً كبيراً ليلاحظ عدم وجود موقف واحد يجمع بين المثقفين السوريين، وأن جلّ المشاريع «التنويرية»، إن صحّت التسمية، لا تشمل كل المكونات. يكشف هذا عن أن المثقف لا يزال «مربوطاً» بحبل طائفته أو حزبه. وفي ذلك، نكون أمام خللٍ كبير في واحدٍ من أهم محددات الثقافة لجهة أنها رؤية عميقة وتتجاوز في شموليتها ضيق الانتماءات ما دون الوطنية.
أهم ما شكلته الثورة السورية في عقدها الأخير هو اختبارها المطلق لشريحتها المثقفة وكشفها تخلفها عن دورها الأساسي في استيعاب متغيرات مراحل الثورة، وهو ما تجلى في لجوء الكثير من المثقفين إما إلى العزلة الرفاقية والاستعلاء على الجماهير، وإما إلى الغياب التام وعدم تبني القضايا الأخلاقية والدفاع عنها كما حدث مؤخراً مع مجزرة جنديرس عندما قتلت الفصائل الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي أربعة مدنيين كرد سوريين فقط لأنهم أرادوا الاحتفال بشعلة عيد النوروز، من دون أن يتحرك المثقفون لتشكيل رأيٍ عام وطني واضح يدين هذا العمل ويدعو إلى محاسبة الفاعلين ومن وراءهم. المثقف السوري غائب عموماً.
وعليه، يمكن القول بأن الثورة أفرزت نوعان من المثقفين السوريين أحدهما عاد إلى مربعه الأول وحاضنته الاجتماعية الضيقة، فأصبح كما قال الشاعر «ومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ، غَوَيْتُ وإِنْ تَرشُد غَزِيّةُ أرْشُدِ» ليتحدر وخطابه إلى مستوى الشعبوية. فيما تقوقع المثقف الثاني، الذي يحمل همّاً وطنياً جامعاً، ضمن شلّته النخبوية لا يتعدى من يصلهم خطابه عدد أصابع اليدين. التقط الشارع السوري هذا الأمر بنباهة، فراح ينظر إلى المثقفين على أنهم يشتغلون بهذه المهنة انطلاقاً من مصالح جماعاتهم الضيقة وليس باعتبارهم فئة مميزة شاملة تعمل بالثقافة انطلاقاً من انشغالهم بالهمّ العام.
وبدوري أسأل: لماذا لا يوجد لدينا جبهةٌ ثقافية وطنية تنتج مثقفيها الوطنيين بحيث يكونوا نبراساً لكل البيئات السورية أسوة بمونتسكيو، فولتير وروسو وغيرهم ممّن أشعلوا الشارع الفرنسي للثورة ضد الملكية المطلقة؟ لماذا لم تفرز الثورة السورية شخصية مثل إيميل زولا الذي دافع مع مجموعة من المثقفين الفرنسيين الطليعيين نهاية القرن الـ19 عن الجندي الفرنسي ذي الأصول اليهودية ألفريد دريفوس، وكيف استطاع زولا بمقالته الشهيرة «أنا أتهم» تعرية فساد السلطة إبان الجمهورية الثالثة، ثم الحصول على تبرئة الجندي دريفوس؟ أليست حاجة السوريين الآن على درجةٍ من الأهمية لصناعة إيميل زولا سوري وجبهته التقدمية؟
لماذا لا يستطيع المثقف السوري التأثير في الشارع عكس الداعية الديني؟ أليس المثقف أكثر انفتاحاً على معارف العصر ولغاته وثقافاته من رجل الدين الذي يقدم خطابه بالاستناد إلى أحداثٍ تاريخية فقط؟ كيف إذاً يمر المثقف من دون تأثيرٍ على واقع الناس بينما تتحلّق الجماهير حول الدعاة والمشايخ؟ لماذا لا نملك مثقفاً شعبياً له جمهورٌ واسع أسوة بأئمة المساجد أو المطربين أو حتى مثل المنجمين وقُرّاء الطالع؟ ما هو الحل لمواجهة أزماتنا المتشظّية وتحدّياتنا الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا السوري؟
تقودنا كل هذه الأسئلة للقول إنه من البدهي أولاً أن يكون لدى المثقفين السوريين رؤيةٌ مشتركة ومُتعمّقة للمشاكل التي أفرزتها أعوام العقد الأخير. بمعنى، أنه لا يمكن التفكير بوضع حلٍ في 2023 وهم يتعاملون على أساس 2011 وما قبل. فالمتغيرات التي أصابت مجتمعنا في العمق غيّرت مجرى حياة مواطنينا في كل الاتجاهات ولا بد من استيعابها وهضمها قبل البدء بتحديد الإجابات الضرورية لها.
إنّ أسوأ ما في الواقع السوري الحالي أنّه من دون أفق. فالتّداعيات الجارية على مستوى الوعي الجمعي تحمل مخاطر القلق أكثر ممّا تَعِدُ ببداية لمستقبل جديد. فالناس، فضلاً عن أنها غير راضية عن معيشتها، قلقةٌ أكثر بشأن المستقبل. يرافق هذا الخوف تشتتٌ في رؤى قادة الرأي، في وقتٍ نحن أحوج أن يلعبوا دوراً في مواجهة ألاعيب السلطة السياسية من جهة وللتقاليد السلبية في المجتمع من جهةٍ ثانية.
قد يكون لعامل الانقسام الحاصل على الأرض السورية دوراً في تفتّت المثقفين كلٌ في اتجاه. لكن إذا ما قرأنا ذلك من زاويةٍ أخرى، يمكن لهذا التباعد أن يشكل ضرورةً أكبر لهم للقيام بدورٍ أكثر مسؤولية مما هم عليه الآن، بحيث يعملوا على إعادة بناء الواقع والوعي الجمعي والرأي العام والهوية الوطنية على أسسٍ جديدة.
عانى الشعب السوري، ولا يزال، من السلطة السياسية الحاكمة. كما يعاني أيضاً من المعارضة السياسية لهذه السلطة، فضلاً عن أن العادات البالية تفرض حضورها بقوةٍ على واقع الناس. كل هذا يجب أن يُشكّل دافعاً للمثقفين بأهمية دورهم في الكشف عن هذه الأخطاء والعمل على تصحيحها وبناء أملٍ للناس بعيداً عن التمزّق الفكري والسياسي والجغرافي.
إن شرط نهضة السوريين وتجاوز هذا العبث المدمّر نحو مستقبلٍ أفضل يكمن في وجود جبهةٍ ثقافية نقدية تمتلك سلطة فاعلة ومؤثرة في مواجهة ثقافة الانقسامات التي تصدّرها السلطة السياسية القائمة. جبهةٌ تؤسس لكادرٍ ثقافي مؤسساتي صلب يجمع بينهم على أساس الغيرة الوطنية والرغبة في التقدم والتطور والمشاركة في الحضارة البشرية جمعاء. وهذا واحدٌ من أهم أسس ومعايير العمل الثقافي الوطني الذي غاب خلال الأعوام الماضية.