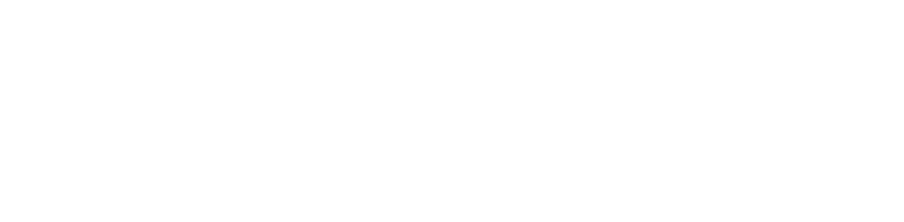حسين جمو
قبل أشهر من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية، تجاوزت القيمة السوقية لشركة «آبل» الأمريكية ثلاثة تريليون دولار، ثم التحقت بها شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق التكنولوجية بقيمة سوقية تجاوزت ثلاثة تريليونات. إن هذه الثروات الجديدة في قيمة شركات تجاوزت بكثير امبراطوريات النفط والسلاح، كانت مناسبة لطرح فرضية في الاقتصاد السياسي الحديث وهو عما إذا بقيت هناك أي مصداقية وحاجة للاستمرار في الأسلوب الإمبراطوري في بناء الثروة والسلطة الذي ساد قرابة خمسة آلاف سنة الماضية، أي التوسع أفقياً والاستيلاء على الأراضي وغزو الشعوب واستعبادها ونهب المجتمعات بشكل منظم والاتجار بالبشر.
إن شركة مثل «إنفيديا» – وهي تسمى شركة بدون مصنع – قيمتها السوقية تبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي في حال تسييل قيمتها السوقية فإنها تكفي لإعادة إعمار سوريا (المقدرة بـ300 مليار دولار) عشر مرات.
إن هذا الاتجاه في تحول القيمة في الرأسمالية من الآلات الثقيلة ومناجم الفحم وآبار النفط، إلى شركات ذات حجم إسمنتي صغير، يعد ذروة جديدة في التنافس الرأسمالي حيث أصبحت فيها التكنولوجيا للمرة الأولى في التاريخ ذات مراحل إنتاج مستقلة وليست رديفاً للصناعات التقليدية في جزء كبير من عملياتها.
الإقطاع في العلاقات الدولية
في كل الأحوال، المناقشة هنا هو في افتراض أن نمط الإنتاج التكنولوجي نموذج أحدث في الرأسمالية من الصيغ الكلاسيكية؛ الزراعية والتجارية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تغيير في طبيعة العلاقات الدولية، رغم مظاهر المقاومة التي تبديها بشكل خاص «الدولة القومية» والتي لديها نمط عدواني في السيطرة على العلوم واستخدامها كقوى شر ضد الخصوم.
في كل الأحوال، ما زالت الدولة القومية تعيد بناء نفسها لكنها لا تجدد نفسها، وهذا فارق مهم في افتراض أن إعادة البناء لا تتضمن التجديد. ما زال النمط القومي في بناء الدولة مهجوساً بفكرة الإقطاع الزراعي في العلاقات الدولية، وهذا ما يتجلى أكثر في روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، طرح في الجغرافيا السياسية للرأسمالية سؤال عن المضمون المتخلف للإمبريالية الروسية المتطلعة إلى السيطرة على الأراضي في أوكرانيا، بكل حمولة هذه الامبريالية من خطابات عن السيادة و«إنقاذ الأشقاء في دونيتسك». كانت حرب روسيا في أوكرانيا عملية من زمن الإقطاع في القرن الواحد والعشرين وتحكمها شهية الفتوحات الإمبراطورية لمساحات جديدة من الأراضي، ونموذجاً لعقلية إقطاعية، حيث ما تزال القوة تُقاس بعدد الكيلومترات التي تُضاف إلى خريطة الدولة، لا بعدد الابتكارات أو براءات الاختراع أو حصة السوق العالمية في صناعة التكنولوجيا.
كذلك في الشرق الأوسط، لم تهدأ أساساً روح الحمى والمضارب عن بنية الدولة القومية ذات الطبعة الاستئصالية – الإجرامية (بالضرورة). فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، كانت خريطة «الميثاق الملي» أكثر شكل جغرافي تم تداوله في تركيا عبر وسائل التواصل الجماهيري. والجمهورية نفسها اندفعت نحو خيالات سلطنة الإقطاع والتيمار واحتلت أراضٍ كردية في سوريا والعراق ضمن ملاحقاتها القبلية لـ«القبيلة الكردية» خارج حدودها حيث الأرض – في الذهنية التركية الحاكمة – ليست فقط رمزاً للسيطرة، بل هي روح الدولة القومية المهددة.
في الحالة الإسرائيلية – الفلسطينية، يتواصل صراع إبادوي على الأراضي يرجح حتى الآن كفة إسرائيل. من روسيا إلى إسرائيل مروراً بتركيا، كان هذا الجزء من العالم يعيد تدوير النظام الساساني التاريخي. وفجأة، انضم لهم زعيم قادم من أحدث وأوقى امبراطورية عبر التاريخ، إمبراطورية بنيت على النقيض من امبراطوريات القرن التاسع عشر البريطانية والفرنسية الغازية، إذ بنيت على الهيمنة وإدارة الصراعات بأدوات حديثة: دونالد ترامب، الساعي إلى الاستيلاء على غرينلاند وقناة بنما وكندا وأراضٍ أخرى ربما لم يعلن عنها بعد. إن النظرية السياسية لترامب بسيطة للغاية، وهي: «إدارة الأعمال- الأراضي» وليس «تنظيم العالم».
لكن، هذه الشهية نحو الفتوحات الإمبراطورية ليست فقط ذات قيمة معنوية لمطابقة الشكل التاريخي للإمبراطورية مع الواقع الحالي، ففي الحالة الروسية فإن كييف هي روح الإمبراطورية الروسية الأولى، وفي حالة تركيا فإن الميثاق الملي هو الشكل الأكثر تواضعاً للدولة الإمبراطورية التركية.
هنا يمكن التمييز بين الموارد والثروة. يمكن بناء الثروة من خلال شركة بدون مصنع قيمتها ثلاثة تريليونات دولار. لكن الدولة ما زالت قائمة على الموارد وليس على الثروة فقط. بمعنى أن الثروة لا تحل مشكلة الطاقة إلى الأبد في تركيا. هذا البلد يدفع سنوياً ما بين 70 إلى 80 مليار دولار على ورادات الطاقة من غاز ونفط. لذلك ما زال من المبكر افتراض قرب تغير العلاقات الدولية تحت تأثير الرأسمالية التكنولوجيا الصادمة (حقبة الذكاء الاصطناعي)، وبدلاً من ذلك من المتوقع أن تصبح الدولة القومية، المعادية للعولمة في الجانب الحقوقي والإنساني، أكثر حصانة عبر استخدام منتجات التقانة الأحدث لمقاومة التغيير في المضمون حتى لو تنازلت عن أو تساهلت في بعض الخواص المتعلقة بالشكل (توسيع التمثيل البرلماني – التوقيع على مواثيق دولية – تغيير أحكام الخيانة والإعدام..إلخ).
منطق «الفتوحات»
في كل الأحوال، لا يبدو أن فكرة «الفتوحات الكلاسيكية» لدى ترامب تحمل نفس المعاني لدى بوتين وأردوغان وأمثالهما. ينطلق ترامب من الإرث البريطاني في تعريف الأراضي، وهو مصدر لتجميع الثروة وبناء القوة أمام الأعداء. في الحالة الروسية، وكذلك التركية، تبدو فكرة استعادة الأراضي أكثر عاطفية وذات قيمة إقطاعية تراثية حتى لو كانت بدون عائدات مالية، بل تكلف خزينة الجمهورية – كما في الحالة التركية – أضعاف ما يمكن أن تجنيه من بساتين عفرين التي تتناهبها فصائل تعمل بالارتزاق لدى أنقرة. في هذا السياق، يبدو أن تنشيط منطق «الفتوحات» بوصفها وسيلة لإنتاج السلطة والثروة، وكأنه نسخة أحدث من الإقطاع، وهذه المرة «الإقطاع القومي» المتحدر من «الإقطاع الإمبراطوري». ويبدو كل هذا لوهلة وكأنه نوع من الإنكار الجماعي لتحوّلات العصر، غير أنه أساسي في تشكيل العصر نفسه، عصر التريليونات القادمة من مكاتب لا تتجاوز مساحتها مقرات قادة ألوية جيوش الفتوحات التركية والروسية والصينية.
تعيد الدول الكبرى إنتاج نموذج إمبراطوري بوسائل حديثة، لكنه لا يزال ينهل من عقلية الفتح والضم والاستتباع. وهكذا، نصل إلى مفارقة عميقة: في عالم تجاوزت فيه القيمة الاقتصادية حدود الجغرافيا ولم تعد الثروات الكبرى تُستخرج فقط من باطن الأرض أو زراعة المحاصيل بل أيضاً من تراكم الذكاء الصناعي، ما تزال العلاقات الدولية تحكمها نماذج ذهنية من عصر الامبراطوريات.
إن هذا التناقض بين التحوّل العميق في بنية الإنتاج وبين الجمود في منطق السيطرة هو ما يُبقي النظام العالمي في حالة صدام دائم بين نموذجين: نموذج إمبراطوري يحتضر لكنه لم يَمُت، ونموذج جديد يتشكّل من دون أن يمتلك بعد سلطة سياسية موازية لقوّته الاقتصادية. في هذا السياق، قد لا يكون السؤال فقط عن مصداقية النمط الإمبراطوري التقليدي، بل عن قدرة النظام العالمي – السياسي والقانوني والفكري – على التكيّف مع لحظةٍ لم تعد فيها الثروة قابلة للقياس بالمتر المربع بل بالبايت، ولم تعد تُبنى بالدبابات، بل بالكود البرمجي.
قد تكون العلاقات المتولدة من الدولة التوسعية دموية لا شك وتستعيد ماضياً ملفقاً حول ملكيات الأراضي. ويتم تلبيس هذه المزاعم التي تطلقها نخب متشنجة للشعوب وأجهزة الدعاية الرسمية لتصبح الشعوب مأخوذة بهاجس الملكية الجماعية لدولة ينهبها عدو ما في الأرجاء قد يكون داخلياً!
رغم ذلك، هناك حاجة ملحة في الأفق قد تعيد إلى المشهد الدولة القومية التوسعية كنموذج مهيمن في العلاقات الدولية لحقب أخرى. خلال الشهر الماضي، تناولت مجلة «فورين أفيرز» عودة الدولة التوسعية إلى خريطة الجغرافيا السياسية كظاهرة غير استثنائية، في مقالين، الأول لمايكل ألبرتوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو ومؤلف كتاب «قوة الأرض: من يملكها ومن لا يملكها، وكيف تُحدد مصير المجتمعات».
يبدأ ألبرتوس
أطروحته بالعودة إلى منتصف القرن العشرين، حين شكّلت ديناميكيات القوة ونظام التحالفات التي شكّلت النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية كبحاً قوياً لحملات الاستيلاء على الأراضي والاستحواذ عليها – وهي سمة راسخة في التاريخ البشري. ولكن بدلا من أن تُمثّل هذه الحقبة من ضبط النفس النسبي قطيعة نهائية مع عدوان الماضي، يبدو الآن أنها مجرد انحراف مؤقت عن النمط التاريخي. من غزو روسيا لأوكرانيا إلى اهتمام ترامب المُعلن بالاستحواذ على غرينلاند، عادت عمليات الاستيلاء الدولية على الأراضي إلى الواجهة. أصبحت تهديدات الاستيلاء على الأراضي مجدداً جزءاً أساسياً من الجغرافيا السياسية، مدفوعةً بمرحلة جديدة من التنافس بين القوى العظمى وتزايد الضغوط السكانية والتحولات التكنولوجية، وربما الأهم من ذلك: تغير المناخ.
تجسد قضية غرينلاند حقيقة كيف يمكن أن يحفز تغيّر المناخ صراعاً عالمياً على الأرض. ينبع اهتمام ترامب بالإقليم ظاهرياً من موقعه الاستراتيجي كمنطقة عازلة بين الولايات المتحدة وخصومها من القوى العظمى. لكن مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فإنّ انحسار القمم الجليدية وذوبان الجليد البحري سيجعل غرينلاند مهمة لأسباب أخرى، حيث أصبحت مساحاتها الشاسعة من الأراضي، التي كانت في السابق غير مضيافة، جذابة للطامعين.
على الرغم من أن الغطاء الجليدي حدّ حتى الآن من استكشاف الرواسب المعدنية في غرينلاند، إلا أن العلماء يعتقدون أنه قد يحتوي على كميات كبيرة من خام الحديد والرصاص والذهب واليورانيوم والنفط وغيرها من الموارد القيمة، بما في ذلك المعادن اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة. شهدت السنوات الأخيرة متوسط درجات حرارة هو الأعلى في غرينلاند على الإطلاق منذ ألف عام، وهو أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية من متوسط القرن العشرين. ستعزز ارتفاعات درجات الحرارة الإضافية نمو النباتات الجديدة، بل وحتى الزراعة. وفق ألبرتوس، فإن سعي واشنطن للحصول على غرينلاند ليس سوى بداية لتنافس عالمي جديد على الأراضي. هناك العديد من الصفات التي تجعل الأرض قيّمة، مثل الوصول إلى الموارد وصلاحية السكن البشري والإنتاجية الزراعية والقرب من طرق التجارة.
سيخلق تغير المناخ مشاكل مستعصية لبعض البلدان ويفتح فرصاً جديدة لأخرى، ما يشجع على التنافس على الأراضي. ستستفيد البلدان ذات المساحات الشاسعة من الأراضي التي ستصبح مرغوبة قريباً إذا أحسنت التصرف. تتمتع كندا وروسيا، أكبر دولتين شماليتين في العالم، بموقع مثالي. ويمكن أن تشهد الزراعة فيهما نمواً هائلاً نتيجةً لطول مواسم النمو وارتفاع درجات الحرارة وذوبان التربة الصقيعية. وقد أظهر نموذج مناخي حديث أن كندا ستكتسب 1.6 مليون ميل مربع من الأراضي الصالحة للزراعة، والملائمة لزراعة محاصيل مثل القمح والذرة والبطاطس، بحلول عام 2080، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف المساحة المتاحة حالياً للزراعة. وستكتسب روسيا مساحة مماثلة من الأراضي الصالحة للزراعة حديثاً في العقود القادمة.
من المرجح أن تشهد أقاليم شمالية أخرى تغييرات مماثلة لتلك التي شهدتها كندا وروسيا: ستشهد فنلندا والنرويج والسويد وولاية ألاسكا الأميركية نمواً في الأراضي الصالحة للزراعة في العقود المقبلة. على النقيض من ذلك، ستواجه الولايات المتحدة والصين انخفاضاً في غلة المحاصيل وتزايداً في الهجرة من أكثر مناطقهما حرارةً وتعرضا للكوارث وانخفاضاً في الإنتاجية. قد يشهد كلاهما تراجعاً في قوتهما ونفوذهما ما لم يتمكنا من موازنة هذه الثغرات باستثمارات في الطاقة المتجددة الرخيصة وخطط لنقل السكان المعرضين للخطر في نهاية المطاف إلى أماكن أكثر ملاءمة للعيش.
في مواجهة تحديات اقتصادية وديموغرافية قاسية مرتبطة بالمناخ، ستسعى الدول جاهدة للاستحواذ على أي ميزة ممكنة. فهناك عشرات الأقاليم حول العالم التي تُشابه غرينلاند قليلة السكان. ومن المرجح أن تصبح أكثر ملاءمة للسكن في العقود القادمة أو موطناً لموارد قيّمة وذات سيادة ضعيفة أو غامضة أو انتقالية. وستصبح الدول التي تمتلك موارد حيوية للانتقال إلى الطاقة المتجددة أيضاً بؤرا للمنافسة. ويمكن تفسير الغزو الأخير لجمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن من قِبل جماعة «M23» المدعومة من رواندا بأنه وسيلة للجماعة، وبالتالي رواندا، للوصول إلى المعادن الثمينة في شرق الكونغو، والتي تُستخدم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة.
ويعلق الباحث مايكل ألبرتوس: «سترسم التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري في الإنتاجية وقابلية السكن، مسارات جديدة للناتج الاقتصادي والهجرة. على سبيل المثال، ستزداد الهجرة من شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق».
ثقافة الغزو الويستفالي
في المقال الثاني في «فورين أفيرز»، كتبت تانيشا فضل، أستاذة العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا ومؤلفة كتاب «موت الدولة: سياسات وجغرافيا الغزو والاحتلال»، مستذكرة عدداً من الأمثلة حول الخط الأحمر الدولي بشأن غزو دولة لأراضي دولة أخرى، استناداً إلى النظام العالمي بعد عام 1945 لمنع تكرار ابتلاع ألمانيا النازية لدول أخرى بالكامل، لكنها غفلت عن نموذج فشل فيه المجتمع الدولي بشكل صارخ وهو الغزو التركي لجزيرة قبرص واحتلالها ثلث الجزيرة حتى الآن.
تعتقد تانيشا أنه إذا توقفت الدول عن استخدام الثابتة المعارضة للغزو الإقليمي أو تبرير أفعالها بطرقٍ تشير على الأقل إلى التزام سطحي، فإن هذه الثابتة ستندثر. وقد يتبع ذلك عدوان إقليمي أكثر جرأة وتكراراً. ومع ذلك، فإن أي تحرك نحو نسخة مخففة أو مشوهة من المعيار الحالي ضد الغزو الإقليمي من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد الصراع على الأرض. منذ الحرب العالمية الثانية، اعتادت العديد من الدول على الاستقرار النسبي للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، واستفادت منه بشكل كبير، وعلى احترام السيادة الإقليمية التي يفرضها. من الصعب تحديد مدى تفكك النظام إذا استمرت القيود الحالية على الغزو الإقليمي في التآكل. وقد يعجل تآكل المبدأ ضد الغزو بتحول أوسع في النظام الدولي القائم على العلاقات بين الدول ذات السيادة. وإذا أصبحت سيادة الدولة مُهددة على نطاق واسع، فليس من الواضح كيف ستعمل الأسواق المفتوحة التي تُشكل أساس النظام المُعولم. علاوة على ذلك، يتعارض الغزو جوهرياً مع الديمقراطية.
الخلاصة، لا يُمكن للعديد من مبادئ النظام الدولي الليبرالي البقاء في غياب قاعدة مُناهضة للغزو. ولعل هذا هو المُقصود والغاية، أي هدم النظام الدولي الليبرالي والعودة إلى انتهاكات «ويستفاليا»؛ المعاهدة التي أضفت قداسة على سيادة الدول الأوروبية وفتحت الطريق لتوجيه الغزوات إلى خارج القارة.
خياران في الشرق الأوسط
تدل المؤشرات في الشرق الأوسط إلى مثل هذا المسار في الاختلال الديمغرافي والزراعي والسيادي، وهو كفيل بإعادة تشكيل المراكز الحضرية ليفاقم اضطراباتها الأهلية، ما يعني أن المنطقة مرشحة لدخول حقبة أخرى من الصراعات لن تكون أقل هولاً من الإبادات السابقة لمجتمعات تاريخية، سواء إبادة مباشرة عبر القتل الجماعي (ولا تنقص الأدوات لترجيح هذا النموذج) أو غير مباشرة بفتح الطريق لتهجيرها للنجاة بنفسها، وهذا يجعل الدولة الشرق أوسطية على مفترق طرق وهي تشارف حقبة جديدة؛ فالدولة القومية (الإجرامية بالضرورة في الشرق الأوسط) ستقود إلى مرحلة جديدة من الإبادات والحروب الأهلية، وبالتالي تفكك الكيانات القومية الهشة أساساً والمحملة بفائض إجرامي. والأزمة الزراعية تقوم بتحضير موجات هجرة جديدة من ريف خاسر اقتصادياً إلى مدن منهكة بإنتاج الثقافة الزراعية وبالتالي انخفاض مناعتها ضد أي دكتاتورية أو احتيالات سياسية قومية ودينية!
أما الخيار البديل، فهو إعادة بناء الدولة نحو توافق اجتماعي صريح وصادق مع الذات ومتصالح مع المساواة. إن رفض المساواة – على ما ذهب
موريس عايق في مقال له – أيديولوجيا تمييز وتفوق ضد المساواة، وليس تعبيراً عن قمع واضطهاد. ولعل ما يجري في سوريا دخول المجتمع مجدداً في هذا الصندوق المغلق.
والشرق الأوسط عمومًا مكانٌ لا آفاق زراعية واعدة فيه، ولا تكنولوجية متقدمة، باستثناء محاولات خليجية. فحتى الأراضي الداخلة في مخططات الغزو أو ذات الغزو المنجَز، مثل الجزء الذي احتلّته تركيا بمحاذاة الطريق الدولي من سري كانيه (رأس العين) إلى تل أبيض، هي أراضٍ متدهورة زراعيًا، وقد فقدت حقبتها المزدهرة التي انتهت قبل نحو نصف قرن، وهي أراضٍ مختلفة في آفاقها المستقبلية عن تلك التي تتطلع إليها الولايات المتحدة في كندا وغرينلاند.
في كل الأحوال، تبحث الدول عمّا ينقصها. وفي حالة تركيا، فإن ما ينقصها هو النفط والغاز، حيث يكلف ميزانيتها سنويًا قرابة 70 مليار دولار، والرقم في ازدياد مع توسّع المصانع وزيادة عدد السكان. وربما تصبح هذه الحاجة هي الدافع الأول لاحتمالين: سلام كردي – تركي مديد قائم على المصالح المشتركة في الاعتراف السياسي والموارد الاقتصادية، أو مرحلة أكثر وحشية من الحرب، ستؤدي إلى دخول أطراف أخرى، إقليمية هذه المرة، فقد انتهى زمن «الصندوق المغلق» لحالة كردستان في السياسات التركية، وأصبحت، على الأقل، صندوقاً مفتوحاً. وفي كل الأحوال، حالة كردستان وتركيا أصبحت مترابطة في وعي قادة من الطرفين، عبدالله أوجلان ودولت بهجلي، مثالاً؛ فإما النجاة معاً أو الدمار معاً.
أما سوريا، فيبدو أنها تستعيد حقبة «الاحتجاج ضد المساواة» في منتصف القرن التاسع عشر، وتفضّل تدمير نفسها على الإقرار بالتشاركية السياسية.