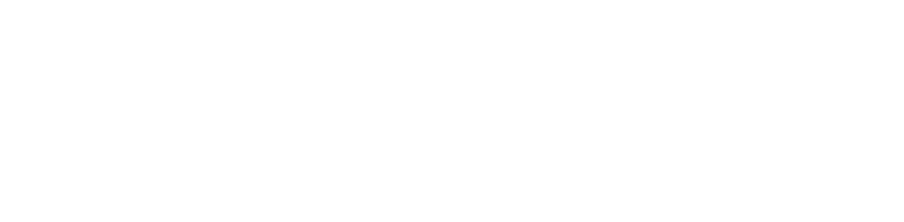محمد سامي الكيال
تعاني سوريا اليوم من ويلات كثيرة، على رأسها الفقر المدقع لأغلبية السوريين وانهيار الخدمات الأساسية والانفلات الميليشياوي، وممارساته التي ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية، وانتهاكات دول الجوار، وفي مقدمتها إسرائيل، للأراضي السورية، فضلاً عن صراعات مرحلة ما بعد نظام الأسد وتهديد تصاعد الحرب الأهلية مجدداً. وكل هذا قد يبدو كافياً لأي مقاربة عن الوضع في البلد. إذ لا هموم أكبر من تلك يمكن أن تشغل المعنيين بالشأن السوري، وما أكثرهم.
ربما يوجد المزيد، إذا نظرنا إلى التحريض الطائفي والعرقي الصريح الذي بات اعتيادياً في البلد وليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحفل عادةً بخطابات الكراهية، وإنما أيضاً في تجمعات الشوارع ومسيرات التأييد، بل حتى في المساجد. لا يمكن تصوّر مستقبل للحياة في بلد متعدد دينياً وإثنياً بشدة عندما يصبح من الاعتيادي الحديث عن الذبح على الهوية باعتباره طريقاً للعدالة أو الدفاع عن الوطن والدولة، أو حتى جانباً من العقيدة الدينية. إضافة لهذا، هناك مأساة تسرّب مئات آلاف الأطفال من التعليم أو تلقيهم تعليماً رديئاً ومتطرفاً في الآن ذاته، فضلاً عن نشأتهم في بيئة تطبّع مع كل أشكال العنف والدمويّة. وإذا أضفنا إلى ذلك تواجد آلاف الجهاديين الأجانب على الأراضي السورية، سنجد أنفسنا أمام صورة قاتمة لأبعد حد. لا يوجد ما هو أهم من حياة البشر ومستواهم المعيشي. إلا أن هذا قد يُحل بسلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مادامت بنى التحضّر ومؤسساته ما تزال موجودة بالحد الأدنى. ولكن ماذا عن انهيار أي رادع اجتماعي أو أخلاقي أو ديني عن الممارسات الهمجيّة؟ هذه قضية ثقافية أساساً بالمعنى الأنثروبولوجي الواسع لمفردة «ثقافة»، إلا أنها تورث مزيداً من القتل والفقر والانحطاط وعلى مدى بعيد ومستدام.
سوريا بلد مركزي في إقليمه ومؤثّر ثقافياً على جيرانه ويقع على ضفاف المتوسّط، أي في نقطة التقاء بين ثلاث قارات ذات تاريخ وإرث شديد التنوّع والتداخل المعقّد في الوقت نفسه. ما يحدث في سوريا له أصداؤه القوية في منطقة شاسعة الامتداد، من مصر واليونان إلى المغرب وإسبانيا، بل حتى في بلدان بعيدة عن المياه الدافئة، مثل ألمانيا وهولندا. نزع بقايا تحضّر هذا البلد، ليس فقط بسبب الحرب وإنما نتيجة ممارسات سلطوية تميل إلى استيعاب أو تمكين الكراهية الطائفية والعقائد الجهادية والممارسات الهمجية، سيؤسس «مدرسة» في القلب من المنطقة قد يصبح لها تلاميذها ومريدوها والمهاجرون إليها.
بهذا المعنى، قد تكون سوريا اليوم «كارثة حضارية» لا تقتصر آثارها على البلد نفسه، ما يدفع إلى سؤال مُلِح: كيف لا ينتبه الجيران، الأقربون والأبعدون، إلى أبعاد هذه الكارثة؟ ولماذا تغلب على تعاملهم مع الشأن السوري الممارسات والتصريحات السياسية بأكثر معاني السياسة سطحيةً وكأنهم يديرون نزاعاً يمكن التخلّص من آثاره بسهولة، أو بالأصح، وكأنهم يكنسون فضيحة تحت السجادة؟
في عالم مثالي، فإن نظام الحكم والمؤسسات الاجتماعية في سوريا هي شأن السوريين أولاً. ولكن هذا ليس واقع الحال منذ سنوات طويلة. أمسى البلد حقل تجارب دول وأشباه دول في إدارة الصراعات وشؤون التطرّف. ولذلك، فإن أسئلة كثيرة يجب طرحها حول التجربة التي يعيشها السوريون حالياً، برضاهم أو رغماً عنهم وبفعلهم أو بفعل غيرهم، وعلى رأسها: هل يفهم أنصار «السياسية» و«الواقعية» المبتذلة أبعاد الكارثة السورية؟
ترويض الراديكالية
يبدو أن هنالك ميلاً عاماً، محليّاً في سوريا وعالمياً، للتعويل على تغيّر هيكلي في الراديكالية الإسلامية نحو المحلية والبراغماتية والحوكمة، بحيث تصبح شريكاً يمكن التعاطي معه في كل الملفات، من محاربة الإرهاب الداعشي وحتى قضايا الانتقال السياسي والحريات الفردية. وهذا، للمفارقة، يبدو أقرب لاقتناع بتنظيرات أبي مصعب السوري، أحد الآباء «الفكريين» للحكم الحالي في سوريا، وهو الجهادي العتيد الذي تنقّل بين تنظيمات، منها «الطليعة المقاتلة» و«الجماعة الإسلامية المسلّحة» في الجزائر و«القاعدة». ولكنه اقتناع لا يحوي فهماً عميقاً لمنظوره الراديكالي، إذ لم يكن تنظيره عن المحلّية والمأسسة تخلّياً عن الجهادية لحساب رؤيا تصالحية تجاه التعددية والمساواة أو أي قيمة أخرى قد تكون ضرورية في سوريا، وإنما ترسيخاً لما يراه قضية كونية لإقامة شرع الله في مجتمعات معقدة وصعبة غارقة في الضلال ومحاصرة بالأعداء. على الهامش، علينا ألا ننسى أن أبا مصعب أنشأ، بعد تجربة عمليّة طويلة في الجهاد، «مكتب دراسات» مرخّصاً في العاصمة البريطانية لندن.
كُتبت دراسات ومقالات بحثيّة كثيرة، بالإنكليزية والعربية وغيرها من اللغات، عن «تجربة إدلب» وميل القائمين عليها إلى «التعاطي مع المجتمعات المحليّة» و«البراغماتية في نزع فتيل التوجّهات الأكثر راديكالية»، بأقلام باحثين غربيين وناقلين سوريين عنهم أظهروا حماساً كبيراً في «تفهّم» تحولات الجماعة الحاكمة في دمشق حالياً. وبغض النظر عن دقّة مثل هذه الدراسات ومدى دعائيتها، فإنها تبدو أقرب لتنظير يكرر المقامرة التي اعتادت دول غربية عليها في العلاقة مع الجهاديين مذ كانوا «مقاتلي حرية» في أفغانستان، بحسب تعبير رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت ثاتشر. قد يكون الجهاديون أدوات فعّالة لتحقيق مهام ما. إلا أنهم سرعان ما يصبحون تهديداً جسيماً في القلب من المجتمعات الغربية نفسها وليس مجرّد مقاتلين وقتلة محليين أو إقليميين.
في كل الأحوال، ليس الخطر الأساسي هو تخلّي الجهاديين يوماً عن محلّيتهم أو تقصيرهم في ضبط وتوطين رفاقهم من الجهاديين الأجانب على الأراضي السورية للحد من انتشارهم في المنطقة والعالم، وإنما الخطر في سوريا نفسها وعلى مجتمعاتها. إذ أن مأسسة و«حوكمة» الجهادية محليّاً، أي وضع ضوابط وأطر لها تحاول جعلها أكثر «ألفة» وأشد ترسّخاً في الوقت نفسه، سيؤدي إلى نتيجة عكسية: انفجارات وانهيارات سريعة في بلد شديد التعقيد ومليء بالصراعات والأحقاد. إنه نزع لكل ما تبقّى من هياكل التحضّر السابقة، ومنها البيروقراطية الحكومية، نظام التعليم، المؤسسات الدينية الرسمية، القضاء، والإعلام، مقابل إحلال هيكل جهادي محلها ذي سمة طائفية واضحة ومبني على عجل. قد يمرّ هذا بصعوبة في محافظة عانت كثيراً من جرائم نظام الأسد ذات أغلبية دينية وإثنية واضحة، مثل إدلب. ولكنه سيؤدي إلى أهوال إن تعمم على كافة الأراضي السورية. وفي مقدمة تلك الأهوال: انفلات كل النزعات التدميرية في المجتمعات السورية وجموعٌ من الأطفال والمراهقين يعتبرون أن التلذذ بإذلال الآخر وقتله وأذيته والانتقام الجماعي وكل مظاهر الفوضى والرثاثة الاجتماعية هي من طبائع الأمور. إنها صورة مرعبة للعالم تترسّخ يوماً بعد يوم لدى جيل سوري جديد.
تطلب كثير من دول العالم اليوم من حكّام دمشق الجدد إشراك فئات أوسع من السوريين في العملية الانتقالية وتجعل ذلك شرطاً لدعمهم ورفع العقوبات. إلا أن كل هذا قد يكون بلا معنى لأنه لا يبدو معنيّاً بالهياكل الأعمق للاجتماع السوري وأقرب للاقتناع ببعض الإجراءات الشكليّة التي لن تقي سوريا بالتأكيد من الاستمرار في الانهيار الحضاري الشامل. لن يكنس المسألة مزيج «المنظمات غير الحكومية» المعنيّة بـ«الاستجابة الإنسانية» و«تمكين» بعض الفئات؛ والضغط السياسي على حكم الجهاديين. سوريا اليوم، وسط كل هذه الانهيارات، قد تكون خطراً على نفسها وعلى الآخرين وفضيحةً، على كل المستويات، في قلب هذا العالم.
الجبهة السورية
قد يكون التعويل على العالم مرضاً سورياً، الشفاء منه ضرورة. فحتى لو شكّلت سوريا المعاصرة خطراً عالمياً و«مدرسة» للممارسات الهمجية، رغم ما في العبارة من تناقض، فإن الحكومات الفاعلة، إقليمياً وعالمياً، ليست الطرف الأصلح للانتباه لذلك الخطر ومقاومته، هذا إن لم تكن الطرف الأكثر فعالية في تشكيله.
الأجدى التفكير بسوريا بين شعوب المنطقة بوصفها مسألة أكبر من حدودها. وهي كانت وستبقى كذلك على ما يبدو. ولذلك، فإن مواجهة نزع التحضّر الشامل الذي يمارسه الجهاديون وحلفاؤهم الكثر، ومنهم نخب «مدنيّة» سورية، ليس همّاً سورياً فحسب بل يعني كل من يريدون منع انزلاق المنطقة، بحدودها الأوسع، نحو مزيد من الانهيار. وينبغي لهؤلاء أن تكون حساباتهم أعمق من النزعة «السياسية» و«الواقعية» المبتذلة في التعامل مع سوريا.
بهذا المعنى، فإن ما يمكن تسميته «جبهة سورية» ضد نزع التحضّر، أي إقامة ائتلاف من القوى والفاعلين من مختلف الجنسيات والتوجهات يسعى إلى الحد من الكارثة، أمرٌ أكثر من ضروري. إذ أن تمتع سوريا بالحد الأدنى من الديمقراطية السياسية والاجتماعية أمر يصب في مصلحة الجميع، بينما العكس سيعني سوريا تجرّ كثيرين معها إلى هاوية لا يمكن اليوم تخيّل أبعادها.
جبهة كهذه يجب أن تستعيد المعنى الفعلي للسياسة وكذلك العمل الثقافي، فما تحتاجه سوريا ليس «الحوكمة» التي تُطلب من سلطاتها، أي المأسسة الشكليّة ذات الطابع الأمني بالعمق لبعض المسائل الإدارية والاقتصادية والإنسانية، بل الديمقراطية بما تحمله من أساسيات المساواة والمشاركة والاعتراف بالتعددية. وهذا ليس ترفاً. فبدون هذه المقوّمات، لن تصل البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار.
كانت سوريا قبلةً للجهاديين في السنوات الماضية. وربما آن الأوان لكي تصبح مسألة أساسية للديمقراطيين على ضفتي المتوسّط. «العمل الثقافي» ضرورة شديدة هنا، إذ أن البلاد باتت موطناً لكثير من الخرافات والهلوسات الدموية والاحتيال الإيديولوجي وعلاقات الخضوع والتبعيّة. ولكل هذا بناه المادية والرمزية التي لا بد من تفكيكها.
يبقى السؤال: مَنْ هم الديمقراطيون؟ أحياناً لا يمكن تعريف الأمور إلا بنقائضها. إذا كانت «الحوكمة»، بوصفها بديلاً عن الديمقراطية الاجتماعية والسياسة الفعليّة، من المقولات الرائجة بين الجهاديين والناشطين المحترفين في «المنظمات غير الحكومية» بل وأيضاً أنصار الديكتاتوريات (بشار الأسد كان من أوائل من تحدثوا عن الحوكمة باللغة العربية واستبعد الديمقراطية التي ليست أولوية بحسبه)، فإن أنصار الديمقراطية الفعليين هم كل المتضررين من الفئات سالفة الذكر والواعين بتأثير ذلك الضرر على استمرار مجتمعاتهم وحياتهم نفسها.
بالطبع، قد يكون إنشاء جبهة كهذه متعذّراً وشديد الصعوبة، ولكنه الهدف الأكثر واقعية من كل واقعيات اللاتحضّر وأنصاره الذي يجعل الحياة في المنطقة أقرب لكابوس سريالي.