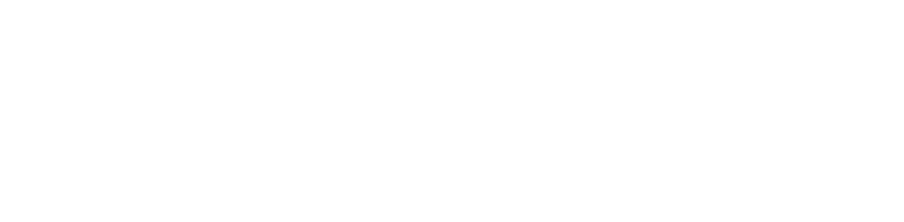فرهاد حمي- نورهات حفتارو
في لقاء تلفزيوني، كشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، عن تعليق صادم صادر عن سلطة الأمر الواقع في دمشق: “دعهم يفشون خلقهم“، في تبرير مروع لمجازر “التطهير الطائفي“، باعتبارها وسيلة لتفريغ الأحقاد المتراكمة. كان المشهد الدموي المتصاعد، بلا حدود أو قيد، أقرب إلى كابوس سينمائي، الجلاد لا يرتوي إلا بالمزيد من الدماء. وقائع المجازر هذه، تشكلت على هيئة عرض مسرحي، يحمل طابعاً تسلطياً رمزياً، بحضور جمهور كبير يثير الدهشة، ليُصبح جزءاً من مسار تدميري عميق في تاريخ الصراع السوري.
وفق آخر الاحصائيات عن عدد المجازر الموثقة، فقد وصلت إلى 56 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية. بينما تتزايد حصيلة الضحايا المدنيين منذ 6 آذار/مارس الجاري، إثر هجمات هجوم شنتها قوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع التابعة للسلطة الانتقالية المؤقتة ضد ما يسمى “فلول النظام“، ما أدى حتى هذه اللحظة إلى مقتل 1500 مدني. وبسبب هول المجازر، هناك من اختلط عليه الأمر، وتساءل: ” هل نحن أمام واقع حقيقي، أم أننا نعايش مشاهد من عالم افتراضي بفعل حدة العنف والتباهي بالقتل الممنهج؟”.
الاعتراف عبر الدم
فعلياً، نحن نعيش في عالم افتراضي، أصبح هو الواقع نفسه، حيث لم تعد الجرائم تُرتكب في الخفاء، بل باتت تُوثَّق وتُبث على نطاق واسع. حتى تلك الأصوات التي دعت إلى ارتكاب المجازر بعيداً عن عدسات الكاميرات، كانت تُنقل عبر منصات “السوشيال ميديا”. وبالتالي، أصبح ما يُسمى بالعالم الافتراضي هو الواقع بحد ذاته، حيث اجتاحت مشاهد القتل المروعة وسائل التواصل الاجتماعي في استعراض دموي يسعى فيه القتلة إلى نيل اعتراف الجمهور بقدرتهم على إتقان فن المجازر.
تجسدت رغبة هذه الفئات القاتلة، التي تعاني من البؤس الاجتماعي، في السعي لنيل “الاعتراف من الآخر“، وبرزت رمزيتها في حملها السلاح بيد، واستعراض ساديتها عبر عدسات الهاتف المحمول باليد الأخرى. إنها مجازر تنتمي إلى عصر المجتمع الاستعراضي بامتياز، حيث تُرتكب الأعمال الوحشية ليس فقط كوسيلة للإيذاء، بل كعرض يبحث عن الاعتراف والتقدير من جمهور مرئي.
حوّل التكفيريون والجهاديون العنف إلى عرض بصريٍّ مدروس ممنهج، لم يعد القتل لديهم مجرد وسيلةٍ للتخلص من الضحايا، بل أصبح أداةً لترهيب المدنيين وإظهار القوة، تماماً كما أشار ميشيل فوكو عند حديثه عن أدبيات العنف في العصور الكلاسيكية. لم تكن مشاهد الإعدامات الوحشية عشوائية، بل إنتاجاً إعلامياً مخططاً يهدف إلى ترسيخ الهيمنة في الوعي الجمعي، وإيصال رسالة واضحة: “العبرة لمن يعتبر“، في تهديدٍ لكل صوت سوري يرفض هيمنتهم.
فائض اللذة والتباهي بالقتل
هذا العنف المروّع يرتبط إرتباطاً وثيقاً بأبعاده النفسية العميقة، والتي تتجلى بوضوح في مفهوم ” فائض اللذة” كما طرحه عالم النفس جاك لاكان؛ فكلما كان الفعل محظوراً—كالقتل الذي يجرّمه الشرع والقانون—ازدادت الرغبة في ممارسته. وعند وقوعه، يصبح مشحوناً بطاقة مفرطة تتحوّل إلى متعة قاتلة. وكما يوضح سلافوي جيجك، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب النفسي فحسب، بل تمتد إلى الإيديولوجيا والثقافة، حيث يتحوّل الهدم والتدمير إلى مصدر للذة والإشباع، ويُعاد تأطيره تحت مسمى “لذة الثأر الثوري“، خصوصاً في سياق ملاحقة من يُطلق عليهم ” فلول النظام“، باعتبار ذلك امتداداً لمعركة القضاء على النظام القديم.
راقب معظم السوريون هذه المجازر عبر شاشات هواتفهم الذكية والناعمة، أو من خلال أجهزة الحاسوب الشفافة، وشاشات بلازما التلفزيونية، سواء كانوا على مقربة من الحدث أو على مسافة بعيدة. وأثناء مشاهدتهم لهذا العنف المروع، تردد في أذهانهم سؤال صادم: كيف يمكن لهؤلاء أن يرتكبوا مثل هذه الفظائع مجدداً، بحق الأطفال والنساء والمسنين؟
نحن في عصر يُوصَف بـ” ما بعد الأيديولوجيا“، حيث لم يعد من السهل تعبئة الجماهير للقتال حول قضايا كبرى كما كان في الماضي. فالأيديولوجيا السائدة اليوم تعزز قيم المتعة الفردية وتحقيق الذات، مما يجعل معظم البشر أكثر نفوراً فطرياً من القتل، نظراً لما يخلّفه من صدمات نفسية عميقة. ولكن من أين يستمد العنف الفاحش في عصرنا تبريراته؟
من منظور التحليل النفسي لأفعال العنف الفاحش، يسعى الأفراد إلى إيجاد مبرر مقدس يخفف من وطأة مخاوفهم الأخلاقية، حيث يعمل المقدس على تحويل القلق الفردي حيال القتل إلى أمر مقبول. وهنا تبرز أهمية الدين أو الهوية العرقية كحوافز قوية تساعدهم على تجاوز حواجزهم النفسية تجاه القتل والتعذيب. وعلى الرغم من أن المقدس، في وضعه الطبيعي، يحرّم القتل، إلا أنه في عصرنا يتحول إلى مبرر للاستباحة وإراقة الدماء، ويؤدي دوره، بالنسبة لهؤلاء القتلى، كنوع من التخدير النفسي الذي يخفف من الحساسية الفطرية تجاه معاناة الآخرين.
المقدس “ما بعد الايديولوجيا”
في هذا الإطار، يتحول اللجوء إلى المقدس واستدعاء ظلاله، كاستحضار حقبة الدولة الأموية، إلى وسيلة مشروعة لتبرير القتل الجماعي. وبدون هذا الغطاء، يجد الأفراد أنفسهم في مواجهة مباشرة مع ثقل أفعالهم، دون مهرب يخفف عنهم عبء المسؤولية المطلقة. لم يعد الإيمان بالمقدس يشكل حاجزاً أخلاقياً، بل أصبح أداة لتبرير الفظائع.
وبالتالي، أُلحق طابع القداسة هذا بالنزعة الثأرية الغريزية، وأُعيد تشكيلها في إطار خطاب شعبوي منفصل عن المنطق والمحاججة العقلانية، بحيث أمست تُسخر كأداة لتحفيز شهية النخبة الباطشة وحشد الفئات الاجتماعية الهامشية. من هنا، يستلزم ذلك تجريم الآخر، وتصويرهم باعتبارهم التجسيد الحي للفساد والقهر وكل أشكال البؤس الاجتماعي. وعليه، تحوّلت عبارة ” فلول النظام” إلى غطاء ومصطلح إقصائي يستهدف الطائفة العلوية بأسرها، مما يجسد نزعة تعميمية في الحكم والوصف والممارسة.
بلا ريب، أخفقت ” النخبة الثورية” في استيعاب البنية المعقدة لنظام الأسد، لا سيما في تحديد مراكز القوة وآليات توظيفه للورقة الطائفية كغطاء لممارسة الاستغلال والاضطهاد. عوضاً عن تفكيك هذه الديناميات بعمق، لجأت إلى التبسيط المخلّ عبر اختزال النظام في الطائفة العلوية، وربط العلويين به بشكل مطلق، ما أسهم في إنتاج خطاب كراهية تراكم بمرور الزمن.
تسخير” المظلومية السنيّة”
لم يتشكل هذا الخطاب بين ليلة وضحاها، بل له امتداد طويل في أرث من الاحتقان الطائفي المتجذر في سردية ” المظلومية التاريخية السنيّة“، التي بدأت تتبلور منذ مجزرة حماة، وبلغت ذروتها مع جرائم النظام السوري على مدار العقد ونصف العقد الماضي. مؤكداً، أنّ بعض النخب التي تدور في فلك أيدولوجيا الاسلام السياسي، بشقيها السلفي والإخواني، قد ساهمت في ترسيخ هذه السردية الطائفية المشوّهة، عبر تصوير إقصاء الكتلة السنيّة عن السلطة على يد حافظ الأسد، وكأنه استهداف لحقها التاريخي في الهيمنة على سوريا. وبالتالي، تم تجاهل أن نظامه لم يكن طائفياً بحتاً، بل كياناً هجيناً يجمع بين الأوليغارشية الأمنية والاقتصادية المحتكرة، مما جعله أكثر تعقيداً من مجرد صراع طائفي مبسّط. وعلى ضوء ذلك، تم استغلال هذه المظلومية—دون أي ترابط منطقي—كأداة لشرعنة القرارات السياسية الأخيرة، ومن ثم تبرير المجازر، من خلال ردود انفعالية تبريرية، مثل: “ألم يكن العلويون وراء مجازر حماة وسقوط البراميل على رؤوس المدنيين السنّة؟“.
منذ لحظة سقوط نظام الأسد، تداخلت احتفالات النصر بنزعات الانتقام والتوعد، وانفلتت الغرائز من عقالها. وحين رفضت مناطق الساحل تسلل جموع التكفيريين إلى بيئة اجتماعية وثقافية تتناقض تماماً مع نهجهم، كان السلام غائباً، والمصالحة مستبعدة. في ظل هذا الفراغ، رفعت سلطة الأمر الواقع المؤقت في دمشق شعاراً واضحاً: ” مطاردة فلول النظام“. حينها، جاءت اللحظة التاريخية التي طغى فيها الانتقام على أي اعتبار إنساني، وتحولت الجموع المستهدفة إلى مجرد أهداف في معادلة الثأر.
وبمجرد أن تداخلت معادلة الثأر في سياق المجازر، تجلّت عمليات نزع “الصفة الإنسانية” عبر عبارات مهينة مثل “عوي ولاك“، التي وُجّهت للأسرى المدنيين المعتقلين، حيث امتزجت الإهانة بسخرية قاسية تُمارَس على عدوٍّ مهزوم أو عبدٍ مذلول، يُستهزَأ بخوفه وألمه من موقع القوة والسلاح والسلطة. هذا النهج وجد امتداده في شخصيات استبدادية مثل ستالين، الذي لم يتردد في السخرية من معارضيه ” الخونة” المذعورين أثناء محاكمتهم، مستمتعاً بإذلالهم العلني. بل إن جذور هذه الظاهرة تعود إلى إسبارطة في اليونان، حيث تحوّلت السخرية من الخصم إلى أيديولوجيا عسكرية خالصة، تهدف إلى ترسيخ فكرة مجد الدولة وتعزيز هيبتها عبر تحقير الأعداء وتصويرهم ككائنات أدنى منزلة.
هذه التجليات الحسية المخزية والمروعة وغير المألوفة، كشفت عن بعد جديد آخر في تجريد الإنسانية من الإنسان. هنا، يظهر البشر كما لو أنهم مجرد منتجات تُصنَع بواسطة الآلات، حيث يحدث انفصال كامل بين الفاعل” القتلة” والمفعول به “الضحايا”. مثلًا، الجهاديون الأوزبك من فرق الموت الذين لا يمتّون بأي صلة إنسانية لعائلات في بانياس أو قرى ريف اللاذقية، يتعاملون مع البشر كأنهم مجرد كتل أو أشياء، لا يمتلكون هوية أو كرامة، كأنهم قطعان حيوانات بلا روح.
هكذا يُجرَّد البشر من قيمتهم الإنسانية، كما ظهر في احتفالاتهم على جثث الضحايا. في حين، كانت حشود غفيرة من مؤيدي أحمد الشرع المتطرفين يطلقون عبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد وصل بهم الأمر إلى وجوب ” تقطيع أشلاء الضحايا ورميها في البحر لتكون طعاماً لأسماك البحر”.
مجازر الساحل والدولة القومية
منذ اندلاع الأزمة السورية، لم تتوقف المجازر التي ارتكبها كل من النظام والتشكيلات المسلحة المحسوبة على المعارضة. ومع ذلك، كانت هذه المجزرة تحديداً بمثابة جرح غائر، في لحظة كان يُفترض أن يشهد فيها البلد تحرره من قبضة الديكتاتورية العسكرية. وبدلًا من تخفيف وطأة المعاناة وفتح نافذة أمل للخلاص، جاءت مجازر الساحل لتؤكد أن الانسداد والكآبة ليسا مجرد عارضين طارئين، بل قدرٌ ملازمٌ لهذا البلد.
ففي السياق العام، أسهم عاملان رئيسيان بشكل مباشر في وقوع مجازر الساحل الأخيرة.
أولاً، غياب القانون الدولي وتلاشي المرجعية الحقوقية العالمية عن المشهد السوري والشرق الأوسط عموماً، وهي عملية بدأت منذ حرب غزة، حيث بات استباحة الأفراد والمجتمعات ممارسة مألوفة دون أي محاسبة، مما جردهم من أي حماية قانونية أو أخلاقية. وبهذا، تحولت المنطقة في غالبيتها إلى كيان “هومو ساكر” المخلوق المستباح، الذي يمكن التعدي عليه دون تبعات.
ثانياً، سعي القوى الإقليمية والدولية إلى فرض “الاستقرار بأي ثمن” في ظل صراع المصالح المتشابك على رقعة الشطرنج الجيوسياسية السورية. غير أنّ هذا “الاستقرار” لم يكن سوى إعادة إنتاج للنظام بقبضة عشوائية تفتقر إلى أي شرعية شعبية أو قانونية، مما أتاح لأول مرة فرصة اندماج الجهادية التكفيرية داخل بنية الدولة القومية، في تحول يعيد رسم خرائط السلطة والعنف في البلاد.
من أساس هذين العاملين، اشتعلت حميّة “الجهادية القومية” في سعيها لتحرير نفسها من أي رقابة اجتماعية وتعزيز احتكارها للعنف، مستفيدة من الفراغ الناجم في السلطة. ومع ذلك، تبقى شرعية الدولة في فرض النظام مشروطة بتوفير السلم الاجتماعي، مما يجعل هذا التوازن الظاهري يحمل في طياته إمكانيات تدميرية للمجتمع. علماً أنه، ومنذ مجازر الأرمن، أصبحت اللعبة على الأغلب تسير على النحو التالي: تسارع كيانات الدولة في الشرق الأوسط إلى تفكيك تدريجي لمصادر القوة المدنية ومؤسسات الإدارة الذاتية المجتمعية. وإذا فشلت في تحقيق هذا الاحتكار الكامل بسبب المقاومة الأهلية، فإنها تلجأ إلى تعزيز فرق الموت، إما عبر دعم الجهاديين والتكفيريين أو من خلال تأجيج الصراعات الطائفية والعرقية تحت شعار “المقدس ضد المدنس“.
تأكيداً لذلك، أطلقت العديد من المساجد في مناطق النفير إلى الجهاد “راية الجهاد” ضد العزّل في الساحل، بينما تحركت غريزة عقيدة الثأر لتبرير عمليات انتقامية وحشية ضد أبناء الطائفة العلوية. من جهتها، كانت فرق الموت الجهادية، منذ نشأتها، أداة رئيسية لتنفيذ مثل هذه المهام.
مع ذلك، لا يمكن الاكتفاء بالتوقف عند هذه النقطة فحسب، فالأمر يتطلب تأويلاً أكثر تعمقاً؛ إذ لا يمكن لأي دولة، أو حتى “سلطة مؤقتة”، كما في الحالة السورية، أن تمارس القتل الجماعي إلا إذا استندت إلى أسطورة إيديولوجية تُستغل لتحقيق طموحاتها الاستراتيجية المتطرفة. فعلى سبيل المثال، تجسد ذلك في محاولات القتلة اجتثاث الطائفة العلوية وإطلاق صفات غير آدمية عليها “خنازير وكلاب”، وهو مشهد تحوّل إلى ” فضيحة إيديولوجية” احتفى بها أنصار إيديولوجيا ” الكيان القومي الإسلاموي” بنسخته الأموية العروبية، ونظرتها الذمية تجاه المجتعمات السورية المختلفة. وعندما تعتقد الدولة القومية أنها محصنة ضد المساءلة، وتبدأ في صياغة هويتها الإيديولوجية عبر تشويه صورة الآخر، يبدأ مشروع الإبادة الدخول في حيز التنفيذ، كما يشير عالم الاجتماع زيغمونت باومان.
الرياح الخارجية
موضوعياً، لا يمكن حصر سياق مجازر الساحل في إطار محلي بحت، ففي شرق أوسط قائم منذ انهيار الدولة العثمانية على سياسة “فرق تسد“، والمبني على انقسامات عرقية وطائفية ومذهبية، سواء داخل الدول نفسها أو بين الكيانات المصطنعة المتجاورة، يبقى اندلاع العنف مجرد مسألة وقت، لا يحتاج سوى هبة ريح عابرة من الخارج.
لم تكن مجازر الساحل، في الواقع، معزولة عن السياسات العلنية والخفية التي تتبناها قوى إقليمية ودولية، والتي تستمر دون توقف. إذ تتسم هذه السياسات بالانتقائية والتقسيم، حيث يسعى كل طرف منها إلى تأجيج الصراع بين الأطراف المتنازعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في مسعى لفرض هيمنته. هذه السياسات لا تُسهم في خلق استقرار، بل تُسهم في زيادة الانقسام والعنف، مما يخلق بيئة خصبة لاندلاع المجازر.
لا تحدث المجازر في فراغ؛ بل هي نتيجة لتنافس القوى الدولية على الساحة السورية. وعندما يُطلق خامنئي تصريحاً، ينفجر الخصم منادياً بمؤامرة يجب التصدي لها. بينما، عندما يعلن نتنياهو دعمه للدروز السوريين، يثير ذلك الارتباك داخل السلطة المؤقتة الحاكمة. كذلك، عندما يطلق أردوغان تصريحاً أو تبدأ السلطة القائمة في نيل حضور ما، تبدأ الأطراف الأخرى بالقلق على حقوقها، خشية من استفراد الحكومة المؤقتة بالسلطة، وتعزيز هيمنتها الشمولية الإسلامية على حساب المجتمع والدولة.
معطوفاً على ذلك، تبرز على الدوام الحسابات الاقتصادية الدولية كعامل مؤثر في إندلاع المجازر بحق العزل، فقد كانت البرجوازية التركية في الماضي مهووسة بفكرة إبادة الأرمن، مدفوعة بجشعها لنهب ثرواتهم. ويذهب البعض إلى أن الثروة التي تراكمت على أنقاض تلك الإبادة هي التي شكلت البرجوازية التركية بالصورة التي نعرفها اليوم. المفارقة تكمن في أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن في كل مرة بصيغة أكثر رجعية، ويبدو أن مجازر الساحل ربما في جزء منها، ضحية لعبة دولية تتنافس فيها القوى على الغاز السوري في البحر المتوسط. فالبيئة الحاضنة لهذا المشروع قد تتصادم مع مصالح القوى الدولية والإقليمية التي تدعم طرفاً ضد آخر. وبالتالي، تظل الضحية دائماً في موقع الضعف، تدفع الثمن في مجازر دموية تتخذ شكلًا جديداً في عالمنا، عنوانه: “مجازر الربح الأقصى“.
أماطت مجازر الساحل اللثام عن خلل بنيوي عميق في المجتمع السوري، وكشفت عن فشل المجتمع في الاستفادة من دروس تاريخ الدكتاتورية الأسدية والحرب الأهلية المدمرة. فبدلاً من تحويل هذه التجارب القاسية إلى مؤسسة تعليمية تروج للقيم الأساسية مثل التعايش والتسامح والاختلاف، لم يتمكن المجتمع في استثمارها في بناء أسس أكثر إنسانية.
بالنظر إلى هذه الوقائع، يبدو أنه حان الوقت للتخلي عن الفكرة السائدة التي ترى في التجارب القاسية بعداً تحررياً، أو أنها تتيح لنا اكتشاف ” الحقيقة المطلقة” للوضع الإنساني. ربما كان هذا هو أكثر الدروس مرارة التي يمكن استخلاصها من تجارب فرق الموت في الساحل السوري، حيث يتبين أن المعاناة لم تؤدِ إلى أي تقدم حقيقي، بل أضافت المزيد من الفوضى والخراب.
إن كان الحال كذلك، ربما لا تشفع لنا حتى صيغ التماهي العاطفي أو التضامن العفوي مثل “كلنا العلويين” أو “فشرتو”، إذ إن هذه الشعارات تنهار عند حدود معينة وتصبح عديمة المعنى. ففي النهاية، الضحايا وحدهم من يتحملون وزر العطب البنيوي الذي أصاب سوريا.