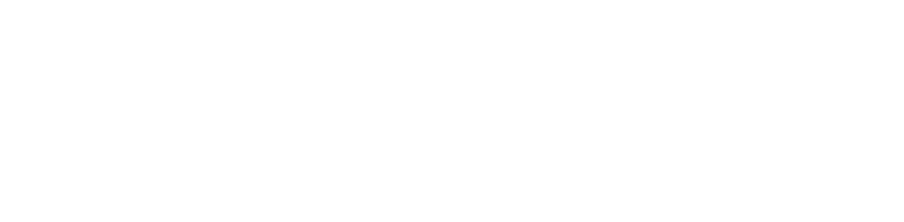د.عقيل سعيد محفوض
قد يكون الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم انشغالاً بالهوية في أبعادها وتمثُّلاتها المختلفة، خاصة الدينية أو الطائفية، والتي كثيراً ما تكون متداخلة فيما بينها. ويختلف حضور الهوية وتأثيرها لدى الجماعات باختلاف الظروف والتأثيرات والوجود والعيش والشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والصحيح هو الحديث عن سياسات هوية ومدارك ورهانات وفواعل هوية، وليس عن هوية بالمعنى المفرد أو هوية تامة أو قارة ونهائية التشكل.
يبرز سؤال الهوية في الإقليم مدفوعاً بعوامل وتأثيرات كثيرة داخل المجتمعات والبلدان وخارجها. لكن الوزن النسبي لعوامل الداخل أكبر جرّاء حالة الصراع والتمزق الهوياتي والاجتماعي والإخفاق في كل أو معظم المقولات والشعارات في الإقليم من تنمية وحرية وديمقراطية ومشاركة.
والصحيح أن ما يحدث في الواقع هو عكس ما سبق، أي أن الإقليم يغرق في الفساد والتسلط والدكتاتورية والفقر والعنف والتطرف والطائفية. وبالطبع كان هناك إخفاق في المشروعات العابرة للدولة، مثل «الوحدة القومية» و«الوحدة الإسلامية» و«الإقليم القاعدة» و«الدولة المركز». وحدثت صراعات وحروب كثيرة بين بلدان الإقليم نفسها تحت عناوين ومقولات أو شعارات القومية والدين والعلاقة مع الغرب، فيما تعد الحروب الداخلية أو الأهلية حالة شبه دائمة في بعض البلدان، وحالة وشيكة أو ماثلة في بلدان أخرى.
وحدثت في هذا السياق أمور طريفة، بمعايير اليوم، إذ كان أصحاب السرديات الإيديولوجية في بلدان مثل سوريا والعراق يتصارعون حول شعارات «وحدة، حرية، اشتراكية»، ليس على مضامينها فحسب، بل على ترتيبها أو تسلسلها أيضاً. هل يجب ان تكون: «وحدة، حرية، اشتراكية»، كما يقول البعض، أم «حرية، وحدة، اشتراكية»، كما يقول البعض الآخر؟ قد لا يتذكر أحد ذلك الآن، إلا أنه كان حاضراً وبارزاً قبل عدة عقود.
وثمة جانب من الصراع أو السجال تمثل في الآتي: هل ثمة هوية عربية واحدة لها تجليات وتشكلات واختلافات وفروق نسبية في البلدان العربية؟ أم أن ثمة هويات في المجتمعات-البلدان تتسم، على العموم، بأنها عربية؟ ومثل ذلك بالنسبة للإيديولوجيات أو السرديات الكبرى في الإقليم. وثمة كلام من قبيل: هل ثمة هوية إسلامية واحدة أم هويات وطنية أو عرقية ذات طابع إسلامي، أم هويات في خط الدين نفسه بين مذاهب وجماعات دينية وطرق صوفية وغيرها؟
ومر الإقليم لبعض الوقت بقدر من الأدلجة التي لا تُفَضِّل (الواقع أن بعضها كان يُؤَثِّم) مجرد الحديث عن تعدد حتى في البيئات الجغرافية واختلاف في البنى والتشكلات الاجتماعية وأنماط القيم، ومن ذلك أيضاً رفض تعبير «العالم العربي» والتأكيد على مصطلح «الوطن العربي» ورفض «الدولة الوطنية» مقابل «الدولة القطْرية» و«دولة التجزئة» ورفض مصطلحات مثل: «الشرق الأوسط» و«النظام الإقليمي للشرق الأوسط»، حتى لو ان جانباً من الحديث يتعلق بدول أو فواعل غير عربية مثل: تركيا وإيران وكردستان وإثيوبيا.
وقد يكون حدث شيء من تجاذبات الهوية في تركيا وإيران، حتى لا نقول «الترك» و«الإيرانيين». وربما أمكن سحب ذلك أو جانب منه على أوضاع وأحوال الكرد والأرمن وغيرهم أيضاً. إذ ان سؤال الهوية والتشكل الاجتماعي-الوطني أو القومي لم يمر من دون صدوع وتمزقات وتجاذبات، تجلى بعضها في عوالم السياسات والصراعات الإيديولوجية والحزبية. ومنها ما تجلى في انقسام حول طبيعة المجتمع والدولة، وبالطبع حول الخرائط القومية والمخيالية الكبرى، وليس مجرد اختلاف في البرامج الثقافية والسياسية. وحدثت انقلابات عسكرية وتوترات وأزمات اجتماعية-سياسية حادة في بلدان مثل إيران وتركيا. (انظر مثلاً: عقيل محفوض، جدليات المجتمع والدولة في تركيا، 2018. وداريوش شايغان، النفس المبتورة، 1992). وحدث شيء من ذلك لدى الكرد، إنما من دون دولة للكرد وفي مواجهة دول للترك والفرس والعرب، الأمر الذي أعطى مسألة الهوية لدى الكرد أبعاداً أكثر تعقيداً. (محفوض، كورد نامه، 2018).
تجد الهوية في كل أو أكثر التفاعلات والتجاذبات في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، علني أو مضمر. الأمر الذي يضعها في مرتبة متقدمة نسبياً في ديناميات الاجتماع والسياسة في الإقليم والعالم. ويمكن الحديث عن خطوط للتفكير أو التعبير عن الهوية أو سياسات وتجاذبات الهوية بوصفها:
أحد المداخل أو المحددات لحدود وخرائط الحضارات وأحد خطوط الصدع والصراع في النظام العالمي. (صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات 1999). وثمة من يسحب ذلك على ما داخل الحضارات نفسها، بل وداخل المجتمعات والبلدان نفسها أيضاً، وأحد فواعل الاصطفاف والتخندق القاتل في العالم. (أمين معلوف، الهويات القاتلة، 1999).
وهي كذلك أحد حصون التخندق على الذات والمعنى والقوة في مواجهة الليبرالية وتدفقات العولمة وعالم ما بعد الحداثة. (انظر مثلاً: ألكسندر دوغين، الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة، 2022). وهنا يتداخل الهوياتي والإيديولوجي ويحاول أن يخلق توافقات أو خطوط تحالف بين الهويات والجماعات الثقافية الكبرى والمجموعات الحضارية المتقاربة والمتشابهة فيما بينها في مواجهة الغرب وعالم ما بعد الليبرالية. (إيمانويل والرشتين، ما بعد الليبرالية، 2022).
وهي أيضاً أحد مداخل هندسة أو صياغة أو تخيل الجماعات والمجتمعات والأمم (بندكت أندرسون، الجماعات المتخيلة، 2014). ولا تستند المقولة القومية أو الجماعاتية لأسس في الواقع أو التاريخ الفعلي أو الحقيقي بالضرورة. ويحدث أن الكثير من أسس تكوين السرديات الإثنية والقومية والدينية يقوم على افتراضات وادعاءات وتخيلات قصدية أو متخيلة أو مفترضة. وهي أحد أنماط الاستجابة لدى الجماعات والأمم وفواعل الهويات حيال ما تعده مصدر تهديد متزايد وذي طابع وجودي لها. ويحدث نوع من المزاودة المحاكاتية بشأن الأصول والمحددات ومصادر الهوية أو مصادر الأفكار المؤسسة للجماعة الهووية ونزاع على ملكية تلك «الأصول» والحق في توسلها والاستثمار فيها واستخدامها لتأكيد ما لـ«الأنا» أو النيل من «الآخر».
وهكذا، يمكن عَدُّ الهوية «مقولة تفسيرية» أو «مقولة تحليلية» لكثير مما يجري، لكنها بالطبع ليست نهائية أو حصرية. والهوية هنا هي هويات متعدد الأبعاد والطبقات، والصحيح أنها سياسات هوية ومدارك هوية واتجاهات هوية وتمثلات وديناميات استقطاب وحشد وتأييد بكل المتطلبات والشروط القَبْلِيّة والإعدادية لذلك وكل السيرورات والتجاذبات بهذا الخصوص. وحتى تكون الهوية كذلك، ثمة أسئلة تحيل إلى عوامل تعزيز أو ترجيح لـ«أبعاد هوياتية» دون غيرها أو بـ«القوامة» على غيرها.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة (البيئة الإقليمية والدولية)، فإن بعض القوى «تبدي إرادة مبيتة لتقويض كل بناء قومي [أو وطني] يظهر لها كتهديد»، (عزيز العظمة، الهوية، ص16). انظر مثلاً ماذا حدث في العراق، إذ تشكلت تحالفات إثنية وتعززت الهويات والانتماءات بوصفها فواعل سياسية، وتم هندسة منظور للهوية «ما دون الدولة» من جهة، ومنظوراً «عابراً لها» من جهة أخرى.
ولم يكن ذلك محض فعل خارجي، بل نتيجة توافقات وقابليات داخلية وبالطبع إقليمية. وهذا ينسحب على الظاهرة الهوياتية الدينية والإسلاموية في عدد من بلدان الإقليم بكل استخداماتها وتجلياتها السياسية. وثمة ديناميات تغلغل واختراق خارجي -من بواية الهوية- في عدد من الدول في الإقليم، خاصة مجتمعات وبلدان الصراع مثل: لبنان وسوريا والسودان واليمن والعراق وغيرها.
ويحدث أن تكتسب الهويات والإيديولوجيات التي ترتكز على الهوية أو تتوسلها مقام العقائد واليقينيات وتصبح قوة تحريك كبيرة أو هائلة. وقد تصبح قوة تدمير أيضاً للآخر وللذات عندما يشعر الفاعل الهوياتي أنه يجب أن يفعل شيئاً ويظهر تأثيراً ويوجه رسالة، وبالتالي يتهيأ المنتمي، أو المتمثل، الهوياتي لأن يكون ليس فاعلاً سياسياً فحسب، وإنما محارباً وقاتلاً أيضاً ليس بيده وسلاحه فحسب، وإنما بموته أيضاً وأيضاً. (انظر: جان بودريار، ذهنية الإرهاب: لماذا يقاتلون بموتهم؟، 2003). يحدث ذلك بكل المشهدية الملازمة أو المطلوبة من أجل أن يتحقق الغرض من فعل الموت أو القتل أو التدمير.
يبدو أن خطاب الهوية، خاصة في الصيغ الإيديولوجية القوموية كما كنا نعرفها، استنزف قدرته على الاستقطاب الاجتماعي والفعل السياسي، فبرزت الصيغ الدينية التي استطاعت، لأسباب عديدة، حشد تأييد اجتماعي واسع النطاق وكسبت إلى حد كبير الصراع مع القوميين والعلمانيين وجذبت فواعل وشرائح اجتماعية كبيرة نسبياً وحققت حضوراً كبيراً في سياسات الإقليم، ولو أن ذلك تعرض لاحقاً لتراجع وانتكاسات كبيرة أيضاً. والواقع أن الحركات الهوياتية الدينية أو التي توسلت الدين مدخلاً وسبيلاً للسياسة لم تتمكن من إثبات أنها «الجواب الصحيح» على مشكلات مجتمعات وشعوب الإقليم اليوم، بل تحولت هي نفسها إلى «جرح نازف» في عدد من مجتمعات ودول المنطقة وامتد تأثيرها المدمر والقاتل إلى كثير من دول الإقليم والعالم.
وفي الختام، مثلت الهوية أحد أهم «فواعل السياسة» في الإقليم و«مقولة تفسيرية» لكثير من المعاني والاصطفافات وخطوط الاستقطاب والصراع على مستوى الجماعات والمجتمعات والأمم، وكذلك الأمر على مستوى النظام العالمي، وهي أمور تتداخل إلى حد بعيد. وتظهر تجليات الهوية بما هي فاعل سياسي وبما هي موضوع للفعل الاجتماعي والثقافي والديني والاقتصادي. وثمة دوماً من يرى مصلحة في اللعب على نداء الهوية كونه الأكثر حساسية وقابلية للاستعمال والاستثمار في رهانات وتجاذبات المعنى والقوة.